لئلا تفقد نفسك وأنت تحاول ألا تخسرهم
الثمن الباهظ للكبرياء
إن من آفات دهرنا الحديث، سقمة نفسية خفية تدعى “غرور الأهمية” أو وهم الانشغال. هي علة يتلفع بها المرء ليستر فراغاً يخشى أن يراه الناس. إنه الخوف الأجوف من أن يقال عنه “متاح”، فيصبح في عُرف هذا الزمان رخيصا أو قليل القدر. فما التلكؤ المقصود في إجابة، أو التغيب المدبر عن موعد، أو التباهي بجدول مزدحم، إلا أحابيل نفس ضعيفة، تصيح في داخلها: “انظروا إلي، أنا مطلوب”! وهي في حقيقتها تحاول أن تقنع نفسها أولاً بقيمة لا تجدها.
تجد أحدهم قد أحاط نفسه بسياج من ضوضاء مفتعلة، وتعمد الغموض ليبدو أعمق، وتسلح ببرود مصطنع ليبدو أقوى. وما كل هذا إلا غطاء هش لذات ترتعش خوفا من أن تواجه بحقيقتها العارية، فتكتشف أنها “دون الكفاية”. أما الإنسان الممتلئ بنفسه، الممتلئ جوهره، فهو في غنى عن كل هذا الزيف. من يعرف معدنه الحق لا يحتاج إلى التواري ليثبت وجوده، ولا إلى التصنع لينال احتراماً. إنه أشبه مايكون بالبحر العميق، لا يعكر صفوه تأخر الرد أو سرعته؛ فقيمته في ثقل ما يحمل، وليس في ضجيج أمواجه.
إعلم ياعزيزي أن من يملك معنى داخليا يفيض به، يظل حضوره طاغياً وإن لزم الصمت. فهو كالشجرة العتيقة، تدرك عظمتها بجذورها الضاربة وظلها الوارف، وليس بحفيف أوراقها الساقطة او المؤقتة. بينما ذلك المدعي، المثقل بهوس إثبات الأهمية، لهو كمن ينقش اسمه على الرمال عند الشاطئ؛ يفتعل الغياب ويعود ليرى أثره، فيجد موجة الحقيقة قد محت كل صنيعه، وكشفت زيف وجوده الذي لا يراه أحد سواه.
ولعلك تحسب، يا عزيزي، أن هذا التمنع المفتعل يثقل ميزانك في أعين الخلق، وأن إيماءك الدائم بأنك منهمك في عظيم الأمور، ولست متاحا كسائر البشر، سيرفعك في مراتب الأهمية. لكن، هيهات! إنما الحقيقة، يا عزيزي أن القلوب تمل الانتظار على أبواب موصدة، وأن الناس، مهما بلغ صبرهم، سينفضون من حولك شيئاً فشيئا، كما ينفض السامرون في آخر الليل.
وحينئذ، حين يبلغ بك الزمان مبلغه، ستلتفت باحثاً عن أولئك الذين أدرت لهم ظهرك؛ قد تريد أن تظهر لهم انشغالك كعادتك، أو لربما، في لحظة ضعف، تريد أن تبوح لهم بفراغك الحقيقي، فلن تجد حولك أنيساً يصغي، ولا جليساً يلتفت. أتدري لماذا؟ لأنك في زحمة إدعائك الأجوف، أضعت حبال الوصل، ولم ترعَ حق ودهم بالمقام الأول.
إن ما تفعله ليس إثباتا للأهمية، بل هو إهمال صريح مغلف برداء الكبرياء. إنه الجفاء بعينه، وهو درب لا يفضي إلا إلى الوحشة. وتلك الوحشة هي الثمن الذي ستدفعه بلا محالة؛ حين تجد نفسك وحيداً، في يوم أنت فيه أحوج ما تكون إلى يد تربت على كتفك، أو أذن تستمع لشكواك، فلا تجد إلا ظلال الأمس، وذكريات أناس أضعتهم بوهم انشغالك.
وحين تَخلُو إلى نفسك طويلاً، ويُطْبِق عليك بابُ الوحدة، يَغشاك الظنُّ بأنك قد أَحَطْتَ بذاتك علمًا، وسَبَرتَ أغوارها. فتعتقد أنك ذاك الشخص الهادئ، ساكن الرُّوع، الذي لا يستفزه شيء، وأنك في أسوأ تقديراتك، إنسانٌ يستعذب الكآبة الفلسفية بعيدًا عن ضجيج البشر. حينئذٍ، يا عزيزي، يَنْجَلِي لك ما كان مستورًا، وتُدرك حقًّا كم كنت مخطئًا حين ظننتَ أنك تعرف نفسك.
فالوحدة مرآةٌ عاريةٌ لا ترحم، تكشف لك من أنماط ذاتك ما لم يكن ليظهر في زحامهم. تُظهر لك، بلا رتوش، تلك السجايَا الموحشةَ التي لا تُطَاق وذلك الجانب الذي كنت تواريه بصحبتهم و حضورهم.
لأن الإنسان، كما أسلفنا الذكر في إحدى المقالات، يشدُّ عضده بأخيه، ويستمدُّ من نوره نورًا. كنتم كقناديل مجتمعة، يمتزج ضوء كلّ واحدٍ بالآخر، فيستُر ذلك النور المتكافل ما في كل قنديلٍ من عتمة، ويُخفي ما في كل روحٍ من نقص. ولكن، حين تُطفئ الأيام تلك القناديل من حولك، واحدًا تلو الآخر، وتقف أنت وحدك في العراء، حينئذٍ، تنقشع عنك تلك الأنوار المستعارة، وتنكشف الحجب التي نسجها الأُنس.
فترى ظلمتك الخالصة، واضحة، شاخصة أمامك. تُبصر وحشتك وجهًا لوجه، وتدرك أن كل ما كنت تخشاه وتفرّ منه، لم يكن يسكن إلا في أعماقك أنت. لأن ذلك الهدوء الذي كنت تزعمُه، لم يكن سكينة داخلية، بل كان مجرد “غياب للاضطراب”، سَمِهِ هدوء البحيرة الراكدة التي لم يُلق فيها حجرٌ قط. لذلك ياعزيزي، أنت بحاجة ماسة لأن تتعلم كيف تُلَيِّنُ حدودك الصّلبة التي بَنَتْها وحدتك وغرورك حول “أنَاكَ” المُتضخّمة؛ فأصبحت كلُّ مُلامَسةٍ لها بمثابة اخْتِراقٍ، وكلُّ اختلافٍ تهديدًا.
ولأنك، وهو الأهم، لم تألف كيف تُفْسِحُ المجال لوجودٍ آخر غير وجودك. لم تتدرّب على فنّ التغاضي، وقبول النقص البشري، واستيعاب إيقاعٍ لا يشبه إيقاعك.
إني لأعلم يقينًا، يا عزيزي، أن هذا الجفاف الذي تتدرع به اليوم ليس أصل طبعك. أعرِفُ أنك كنت ذا قلبٍ ليِّنٍ، وجانبٍ سمحٍ، تسرف في حسن الظنّ بالناس، وتوزّع ثقتك كمَنْ يذرّ الماء دون حساب. حتى جاءك ذلك الموقف. ذلك الموقف الذي قطع فيك عرق السذاجة، وهمس في أُذنك بصوتٍ قاسٍ “لا بدّ لك أن تُصبح اقسى ”. قال لك بلسان الألم: إن الأرض الطيبة أكثر الأراضي عُرضةً للدوس، وإن الغصن الرطب هو أسهل الأغصان كسرًا.
فصدَّقته وآثرت أن تكون حجرًا صلدًا، على أن تكون تُربةً خصبة تُجرَح بالمحراث. بدأت ترتدي قناعَ اللامبالاة، وتتسلح بالجفاء، وتقنّن عواطفك كمَنْ يخشى الإفلاس، ظنًّا منك أن هذا هو النضج، وأنها القوّة. ولكنك يا عزيزي، خلطت بين القسوة والقوّة.
فالقوّة ليست في الغصن اليابس الذي ينكسر عند أوّل ريحٍ عاتية، بل في ذلك الغصن اللّيّن الذي ينحني مع العاصفة، يكاد يمسّ الأرض، ثم يعود معتدلًا شامخًا، دون أن يفقد خضرته أو نداه. القوّة هي أن تمرّ بك كل تلك المواقف الجارحة، وتظل قادرًا على أن تلين، وأن تغفر، وأن تحب، لأن اللين اصعب بكثير من القسوة. أما هذا “النشوف” الذي اخترته، فهو سجنٌ باردٌ، قد يحميك من الألم، نعم، ولكنّه، وهذا هو الثمن الفادح، يحرمك من كل فرحٍ حقيقي.
فاعلم ياعزيزي، أن الناس أطْيانٌ مختلفة، ومعادن متباينة. فمنهم من جُبِل من “طينةٍ طيبة”، كالأرض الخصبة؛ هذا لا يتغير جوهره، بل كلّما أظهرت له من نقائك وصفائك، ازداد هو نقاءً، وأثمر لك مودةً ووفاءً، اذ أنه يُطبق ما ذكره الله تعالى في كتابه {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}.
واعلم ايضاً ياعزيزي أن من الناس من طينته “خبيثة”، كالسّبَاخ المالحة التي لا تنبت زرعًا فما إن يأمنك ويرى منك اللين، حتى يكشف لك عن أنياب الغدر، لأنه لا يرى في الطيبة إلا ضعفًا وهذا جهلاً منه ووحشة قلب. ومنهم ذلك “المتقلب” بينهما، لا يثبت على حال؛ يراوح معك بين المدّ والجزر، و”يشدّ الحبل معك ثم يرخيه”، كما يُعامَل الأطفال، فلا أنت تأمنه فتقترب، ولا أنت تيأس منه فتبتعد. بيد أنّ حظّك العاثر يا عزيزي، أوقعك في درب أولئك الذين أظهرت لهم أصلَك وطيبَتك، فما زادوك عليها إلا جحودًا ونكرانًا.
فإيّاك ثمّ إيّاك أن “يغيّرك” هذا.
إيّاك أن تخلع رداءَك الأبيض، فقط لأن وحلًا أصابك منهم. فالشمس لا تحبس نورها لأن كفيف لم يبصرها، والمسك لا يكتُم أريجه لأن زاكماً لم يشمه. إن طيبتك هي سجيّتك التي فُطرت عليها، وهي نصيبك من الكمال الإنساني، وليس نصيبهم منك. فإذا غيّرت طينك الأصيل لتشابه طينتهم الفاسدة، فأيّ انتصارٍ لك في ذلك؟ وأيّ خسران أعظم من أن تفقد نفسك، إرضاءً لظلمةٍ في نفوسهم؟ كن أنت، كن ذلك المطر، الذي لا يُبالِي أين يهطل؛ يصيب السبَاخ فلا تنبت، ويصيب الأرض الطيبة فتزدهر. ليس العيب في المطر يا صاحبي، بل العيب دائمًا في الطينة.
واسأل نفسك ياعزيزي،أيّ “ثقلٍ” مزعوم هذا، الذي يجعل العاطفة الصادقة تخشى انكشافها؟ إنّ الثقل الحقيقي هو ثقل الكتمان نفسه؛ بربك إنه لعِبء هائل لعاطفةٍ توَدّ لو تصرخ، لكنها تخشى أن تُبتذل على ألسنة من لا يعرفون قدرها. اسمعت قول أحدهم، “فضح القلب حين فاض”؟. لأنه أشبه بذاك النهر الذي كَسَر السدود، فما عاد يأبه للّامة. هو نورٌ أقوى من أن يُحبَس داخل الفؤاد، فلا بدّ أن يُشرق على الملامح واللسان.
أتدري ياعزيزي أين الخفة الحقيقية؟
ما الخفة إلا في ذلك القلب الجبان، الذي يُخفِي شعوره النبيل، لا عن الناس فحسب، بل حتى عن نفسه، لأن القلب دائماً إمتداد لنفسك قبل الناس. الخفة هي أن تدّعي الصلابة والرزانة، وجوفك يكاد يتفطر من الهوى. الخفة هي أن تمضي العمر في مخادعة ذاتك، فتموت مشاعرك عطشى على أبواب قلبك، خوفًا من أن يُقال عنك “خفيفٌ”.
فأيهما أثقل وأكرم: قلبٌ يبوح لأنه حيّ، أم قلبٌ يصمت لأنه يخاف أن يحيا؟
يُمكنك كتابعتنا على قناة اليوتيوب بعنوان من هنا:



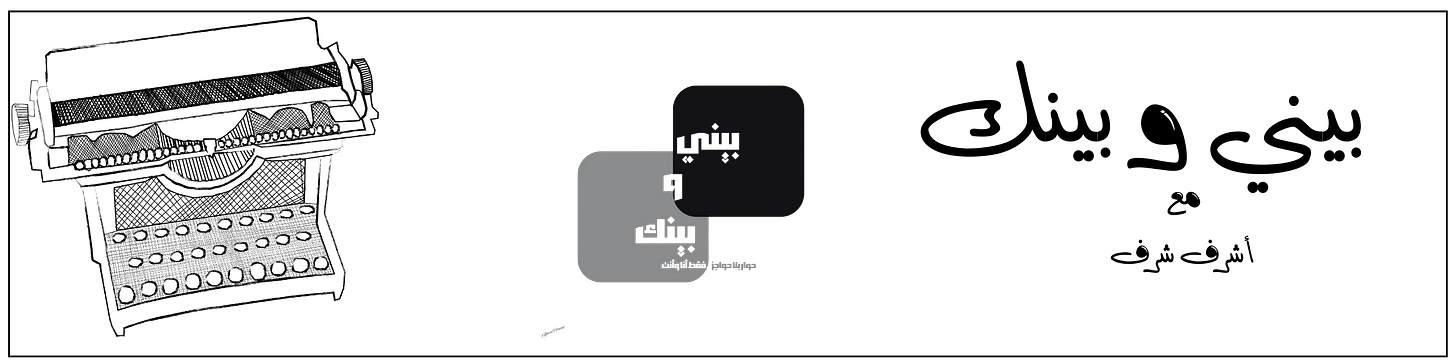


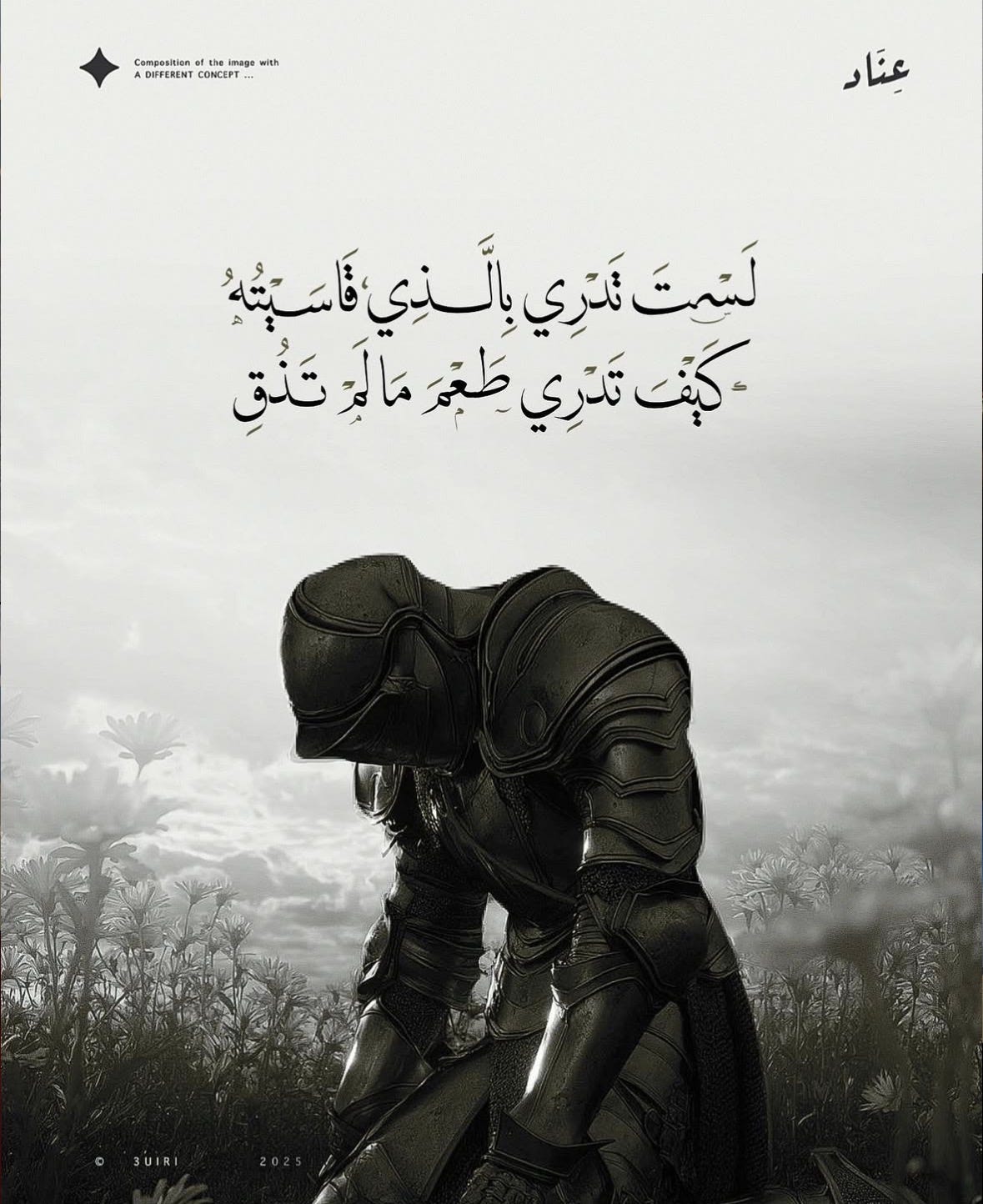

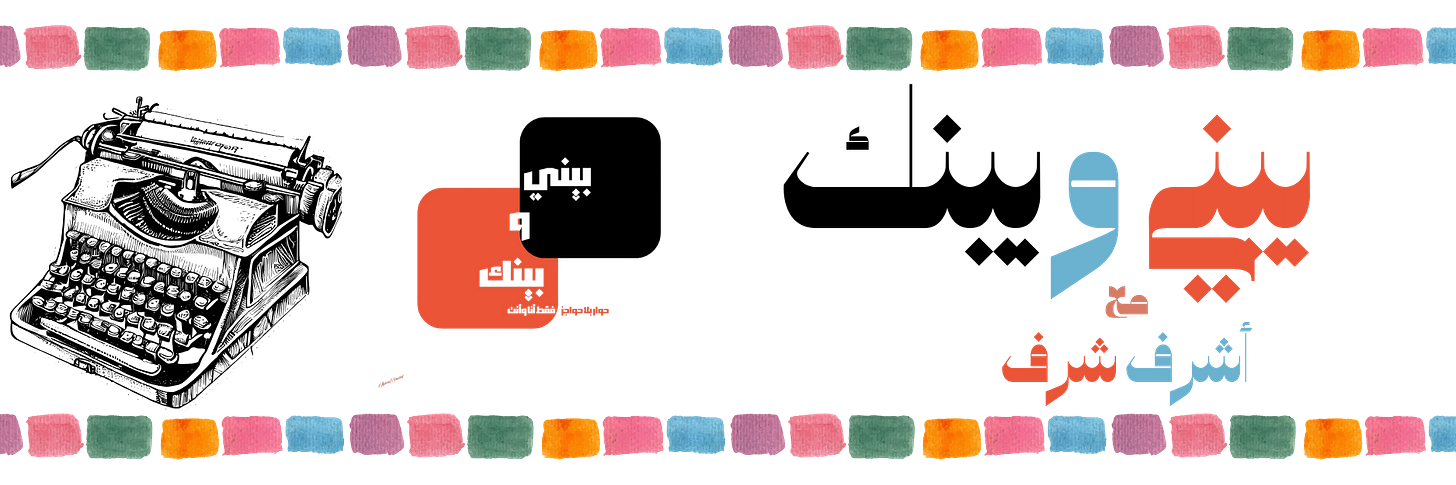
قال أرسطو لاحد تلاميذه إذا توفيت ولديك اربعة اصدقاء فأنت رجل عظيم، نحن نخسر اصدقائنا لأسباب اخرى عديدة لم تذكر هنا، ونتصالح مع وحدتنا لأسباب أخرى لم تذكر هنا أيضاً، هذا لا يعني أنني اختلف مع ماذكرته، بل على العكس قد أجدني ضمن السطور، احاول وبشدة أن انزل بمستوى تفكيري إذا كان محيطي تافهاً وأحاول بشدة أن ارتقي بكلامي إذا كان محيطي راقياً ولكنني تعلمت بالطريقة الصعبه أن أكون كما أنا حضر من حضر وغاب من غاب وشاء من شاء وأبى من أبى.
منذ سنوات وأنا اذهب يومياً لنفس المقهى واجلس بنفس الزاوية ولم أفكر اختيار صنفٍ جديد غير الماء والقهوة، سماعة هاتفي ومفاتيح سيارتي واحياناً نصطحب جهاز الكمبيوتر المحمول أو كتاباً عاف عليه الزمن.
لم تشعرني الوحدة بالوهن ولا الوهم لم اشعر انني ضعيف أبداً ولم أشعر أنني وحيد على الإطلاق، ولا أغيب لأصنع حولي هالةً عند الحضور، ولا أتأخر في الرد على أحدهم لأوهم العالم بأنني مشغول ولست مكتئباً على أي حال، ولا مصاباً بمتلازمة المنزل، لم يعد يغريني شيء هذا هو كل مافي الأمر.
أحببت كلماتك المعبرة جدًا! حقيقي من أجمل و أحن مقالاتك، سلمت يداك يا أشرف🤍