في كل سيرة بطل عظيم، سواء في واقع الحياة أو في الروايات الخيالية، قلّما تُروى المآسي صراحة، ودائماً ما تُقرأ بين الشقوق والكدمات والانكسارات والألم، وأحياناً حتى في النظرات الحزينة أو الصمت المُطبق. وما ذلك إلا إشارة إلى أن القوة لم تكن يومًا في الاكتمال وكانت دوماً في النقص الذي يؤدي إلى اكتمال وهو ما لا يتحقق إلا بالخسارة قبل المكسب، وبالعَراء قبل الامتلاء.
إننا نولد أول مرة مع صرخة تتجلى في بكاء المولود، ونغادر الدنيا ايضاً على وقع بكاء الأحياء مِن حولنا. غير أن بين الميلاد والفناء ثمة ولادة أخرى؛ ولادة قاسية تنبثق حين ينهار كل شيء، فنجد أنفسنا وجهاً لوجه مع الحطام، مضطرين إلى البدء من الصفر. وهنا يُعاد التكوين، ويُكتب للإنسان أن يولد من جديد لا مرة ولا مرتين، بل بقدر ما يفرض عليه القدر من انكسارات وتحولات. لذلك أجد من المضلّل أن نصدّق العبارة الشائعة بأن "الحياة مرة واحدة"، فهي ليست كذلك ولن تكون كذلك، والحقيقة أن الحياة لا تُعاش ككتلة واحدة، بل كحلقات متجددة، كطبقات تُبنى فوق بعضها. نحن نُميت أجزاء صغيرة في كل خيانة نتلقاها، في كل فشل نشعر به، في كل فقد، وفي كل الآلام ثم نولد أجزاء جديدة في كل صمود، في كل تعلّم، حتى تُفتح لنا نافذة جديدة على أنفسنا.
فالطفل فينا يموت ليُولد المراهق، والمراهق يموت في صراع الشكوك والمعارك الداخلية ليُولد الشاب. والشاب يتهشّم تحت ثِقل الخيبات حتى ينحت نفسه إنسانًا ناضجًا يرى العالم بعيون أخرى. ولكل مرحلة موتٌ صغير وبعثٌ جديد، حتى ندرك أن أعمارنا ليست خطًا مستقيمًا، بل سلسلة حيوات متقاطعة. وهذا في الواقع ما جعلني دوماً أتسائل عن سبب اشتياق المرء إلى طفولته دومًا. أهو حنين إلى زمن البراءة، حين كان القلب أبيض لم يخدشه وحشة العالم؟ أم هو توق إلى بساطة الأيام التي لم تكن تُقاس فيها القيمة بما نملك، بل بما نشعر؟
وفي واقع الأمر ياعزيزي فقد سألتُ كثيرًا من الناس ذلك السؤال البسيط جداً وهو لماذا تشتاق إلى طفولتك؟ و المثير أن بعضهم يعترف بوضوح أن حياته اليوم أفضل بما لا يقاس ماديًا، وربما نفسيًا أيضًا. ومع ذلك، لم أجد واحدًا منهم إلا ويحنّ إلى طفولته.
فتفكرت في الأمر، فاكتشفت أن الشوق ليس للأسلوب المعيشي ولا للظروف، بل لما لا يُشترى ولا يُعاد، فأسرتها في نفسي وقلت أن الطفولة بهذا المنطق ليست بيتًا أو طعامًا أو حتى لعِبًا، بل هي أشبه ما يكون بحالة. حالة من الخفة لم تعد لنا، ولعلك تتسائل ماذا أقصد بالخفة ياعزيزي، وهو إن سمحت لي أن أشبه لك الخفة التي اتحدث عنها أشبه ما يكون بوعاء فارغ.
تخيل يا عزيزي، أن الإنسان يُولد وكأنه وعاء فارغ، خفيف، يطفو مع كل فرح صغير ويقفز بلا تردد أو حتى تفكير. طفل في سنواته الأولى، يكون "ثَقله" وزنه فقط، لا يحمل فوق كتفيه هموم الأمس ولا حسابات الغد. لكن مع كل عام يمضي، تبدأ تجارب الحياة تغمر وتملأ ذلك الوعاء تدريجيًا، على سبيل المثال، في الثانية من عمره، يبدأ بفهم كلمة "لا" عندما يسمعها لأول مرة، فتصبح أول خيبة أمل حقيقية يشعر بها، فيغلق عينيه ويبكي، وكأن العالم صار فجأة أكبر وأكثر قسوة. تلك الخيبة تمثل غمًا كبيرًا بالنسبة له في ذلك الحين.
وفي الثالثة والرابعة من عمره، يتعلم أن الفقد يمكن أن يكون أصعب، حين يخسر صديقه الذي انتقل بعيدًا. يَحزنُ على هذا الفقد الصغير، وتتحول خيبة الأمل الذي تعرض لها من قبل، حين قال له أحدهم "لا" إلى وهم وحُزن صغير أمام الألم الجديد. يبدأ يصغر ما مر به في السابق معتقدًا أن الحزن الحقيقي بدأ من هذا الفقد. ثم يأتي سن المدرسة، حيث يحاول التأقلم مع قواعد جديدة، ويواجه أول مفاهيم مثل المنافسة والفشل والنجاح. تصبح هذه أول هموم ثقيلة نسبيًا على قلبه، فتَكبُر هذه الأوجاع ويبدأ بإستصغار الآلام السابقة، فكل جرح جديد يظل هو الأشد والأكبر وكل جرح جديد ينفي ما قبله من جراح.
ومع دخول مرحلة المراهقة، تتعقد الأمور أكثر فيعيش صراعات الهوية والرفض والتمرد، وتنمو الضغوط النفسية داخله إلى حد يكاد يثقل روحه. في هذه المرحلة يرى أن الهموم الحقيقية هي مما يختبره الآن، ويتمنى أحيانًا لو يعود إلى براءة الطفولة، حيث كانت الأيام أخف والقلوب أنقى، رغم أنه يسير بحذر نحو نضج يجعله يترك تلك البراءة خلف ظهره تدريجيًا أو على الأقل يحتفظ بها لنفسه داخله. ومع مرور الوقت، ينضج الشاب شيئًا فشيئًا، يحمل في قلبه كل هذه الهموم والتجارب، فيصبح عاقلًا راشدًا يدرك أن الحياة ليست سهلة، وأن الخفة التي رافقته في طفولته باتت بعيدة المنال الآن. لهذا يشتاق إليها، ويشتاق إلى ذلك الوعاء الفارغ الذي كان يحمل بداخله أمالًا خالية من الأعباء، ونفسًا كاملة لم تُثقلها متاعب العالم بعد.
مع كل خطأ أو فشل أو مسؤولية جديدة، يملأ ذلك الوعاء شيئًا فشيئًا وتخسر الخِفّة كلما امتلأ الوعاء، يكبر القلب فتثقل فيه خيبات الثقة، ويكبر العقل فتثقل فيه رياح المقارنات والقرارات ومسؤوليات البقاء، يكبر الجسد فيثقل بكوابيس الفواتير والإلتزامات وخوف المستقبل. الطفل يضحك فيسهل عليه النسيان؛ الكبير يضحك لكن يحمل القلق في داخله. طفل اليوم ينام مطمئنًا مهما ضاقت الدنيا، أما كبير اليوم فيحمل فراشه وهمومه معًا أينما ذهب. وهذا ما يُفسر اشتياقنا للطفولة، و هو اشتياق لنفس خفيفة، قلب لا يحمل سوى نبضه، وعقل لم يجرّب بعد ثقل الأسئلة ولا وجع الخسارات، أشبه ما يكون بحنين إلى أيام كان فيها كل شيء ممكنًا وكل أحلام العالم خفيفة وجميلة. قبل أن يثقلنا الزمن تدريجيًا بما لا نختار.
قد تتساءل، يا عزيزي، لماذا اخترت أن أذكر لك هذا المثال؟ وإنه لسؤال مشروع، بل ومحبب إلى قلبي. وناهيك عن أنني أحب أن أشبه الأمور الكبيرة بأشياء صغيرة وبسيطة لكي أتمكن من نقل ما يدور في داخلي بوضوح وتبسيط. لكن الأهم من ذلك أنني أحاول من خلال هذا التشبيه أن ألفت انتباهك إلى شيء أزعم أنه مُختلف، وهو كيف تتشكل الإضطرابات النفسية فينا.
إن لاحظت معيَ جيدًا، ستجد أن الطفل في كل مرحلة من عمره يبدأ يستصغر همومه السابقة أمام عبء وهموم المرحلة الجديدة التي يعيشها. هكذا، ما كان في وقتٍ مضى كألم عظيم، يصبح بعد حين مجرد جزء صغير مقارنة بما يشعر به الآن. وهذه هي طبيعة معظم المشاكل النفسية التي يظن الإنسان أنها نهايته أو قاعه المظلم، بينما في الحقيقة هي حلقة تصلك بالحلقة التي تليها، أشبه ما يكون بعملية تراكمية كلُ حلقة فيها متصلة بشكلٍ ما.
و ما يجعل الأمور تتفاقم مع مرور الوقت هو الرد الأول الذي صدر منك في مراحل حياتك الأولى تجاه الألم أو الضيق. إن بكيت حينها، فلا بأس؛ وإن اشتكيت أو عبرت عن ضعفك، فهذا أمر طبيعي ومقبول. لكن إن لم تواجه نفسك، ورفضت أن تعترف بخطأك، ولم تتعلم من كل تجربة، كما لم تنهض سريعًا بعد كل سقوط، حتى وإن كان السبب بسيطًا أو تافهًا، فإن ذلك يكون بداية لطريقة معالجتك للمشاكل التي تتلقاها فيما بعد، وحينها حتى أتفه المشاكل ستبدو معضلات جسيمة بالنسبة لك.
لذلك، ما أفتأ أُذكِّر المقرّبين مني أن الإسلام، في جوهره الأصيل، إذا أمر أو نهى، أو حتى ساق إلينا قصة من قصص الأنبياء، فليس ذلك على سبيل التشريع وحده، ولا لمجرد السرد والتذكير، بل وراءه دائمًا معانٍ متعدّدة المستويات، فوائد ظاهرة تتجلّى للناظر لأول وهلة، وفوائد خفية لا تنكشف إلا بالربط بين النصوص والعلوم والمعارف الأخرى. ولهذا أزعم أن إشارات القرآن ليست مجرّد أوامر أخلاقية أو تشريعات عملية، بل تمتد لتُصبح خارطة إلهية تمتد من سطح الفهم إلى سراديب النفس الداخلية التي تتجلى في البصيرة، لتُهذِّب عقل الإنسان، وتُنير روحه، وتوجّه سلوكه في مسيرة الحياة.
وأحبُ أن ألفت انتباهك يا عزيزي، إلى أن كل آية في القرآن الكريم، وكل حديث في السنة النبوية، يحمل في داخله هذين المستويين من الفوائد: الظاهر والخفي. الفوائد الظاهرة هي المعاني المباشرة التي تطرق سمعك أو تقع عليها عينك فور القراءة أو الاستماع، سهلة الإدراك، واضحة كالشمس. أما الفوائد الخفية، فهي أعمق وأدق وأرحب؛ لا تُدرك إلا عندما تفتح لنفسك باب السؤال، لماذا جاء الأمر هنا؟ ولماذا ورد النهي في هذا السياق؟ وما الغاية من القصة أو الموقف؟ عندها فقط يبدأ المعنى في التمدد، وتنكشف لك حكمة أوسع، وفوائد تتجاوز حدود لحظتك الحالية لتُعيد تشكيل وعيك ورؤيتك للحياة وسلوكك.
وأحب أن أعطيك مثالاًِ والأمثلة في القرآن لا تُعد ولا تُحصى مثل قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
أحد الفوائد الخفية هنا تتجلّى في وضوح نبي الله موسى عليه السلام وشفافيته، وهذا في عمق النفس الداخلية بل وتكشف لنا ايضاً مدى عِظم شخصية سيدنا موسى عليه السلام، إذ لم يفتش عن أعذار تُخفف عنه أو شماعة يعلّق عليها فعلته. لم يقل: "لقد استفزني"، أو "لم يكن له أن يتدخل"، بل واجه الموقف مواجهة رجل مسؤول عن نفسه أمام ربّه. لقد إعترف سيدنا موسى عليه السلام بفعلته ومن ثم نسب الفعل إلى الشيطان من حيث طبيعته، إذ إن القتل في جوهره فعل شيطاني وليس إنساني، وهذا يكشف لنا أن سيدنا موسى عليه السلام أيضاً يرى أن الإنسان لا يصدُر عنه إلا خير وهذا من رحمة قلبه، ومع ذلك لم يُلقِ باللوم على الشيطان، بل نسبه إلى نفسه أولًا واعترف بخطئه، ثم قال: ﴿هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، وكأنه يقول إن الدافع شيطاني، ولكن المسؤولية إنسانية خالصة.
ثم انظر إلى سرعة الندم وسرعة التوبة؛ فما إن وقع الفعل حتى تدارك الأمر، وأقرّ بقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾. وهنا سرّ بليغ، لم يقل "ظلمت فلانًا" أو "أخطأت في حق غيري"، بل جعل الظلم موجَّهًا إلى نفسه أولًا، لأن أعظم الظلم أن تظلم نفسك بحرمانها من الحق، أو بتعريضها لسَخَط الله، أو بإلقائها في دروب الغواية. فالنفس هي أول من يُظلم حين يبتعد الإنسان عن الحق، وإن كان الخطأ موجَّهًا نحو الآخر في الظاهر. ثم تأمل هذه الدقة، قد تترك في حياتك أشياء كثيرة وتزهد فيها، وربما تحتقرها فلا تعود إليها، إلا الحقّ؛ فإن تركته أو قصّرت فيه، فأنت لا تحتقر شيئًا خارجيًا بل تحتقر نفسك ذاتها. وهذا هو الظلم الأكبر.
لذلك، إن في هذا المشهد من قصة سيدنا موسى عليه السلام درسًا بالغًا وهو أن الشجاعة ليست فقط في مواجهة الأعداء، بل في مواجهة النفس اولاً، والاعتراف بخطئها دون مواربة، ثم المسارعة إلى التوبة، لأن التردد في العودة إلى الله أعظم من الخطأ ذاته.
وإن أحببت أن أُعطيك مِثالاً في السنة النبوية فسأعطيك مثالاً بسيط جداً وأيضاً الأمثلة كثيرة، مثل ما ورد في الحديث الشريف: «وإن أصابَك شيءٌ فلا تقلْ : لو أني فعلتُ لكانَ كذا وكذا ، ولكن قلْ قدَّرَ اللهُ وما شاءَ فعلَ فإن لو تفتحُ عملَ الشيطانِ». و قد يتبادر إلى ذهنك يا عزيزي سؤال وهو كيف يمكن لعبارة صغيرة، مؤلفة من كلمتين فقط، أن تفتح بابًا واسعًا للشيطان؟
والفائدة الظاهرة هنا جلية وهي النهي عن استعمال كلمة "لو" عند التحسّر على ما فات، لأنها لا تغيّر من الواقع شيئًا ولا تعيد الزمن إلى الوراء. لكن لو شئنا النفاذ إلى ما تحت الظاهر أكثر سنجد أن للحديث بعدًا نفسيًا عميق الأثر؛ فـ"لو" تُعد بوابة ذهنية تُدخل صاحبها في دوامة الندم، وتغذّي مشاعر العجز، وتحبسه في ماضٍ انتهى بدل أن تدفعه إلى المضيّ نحو المستقبل، كلمة مُكونة من حرفين فقط قد تُحوّل العقل إلى سجن مليء باحتمالات لم تقع، وتزرع في النفس أوهامًا تضعف الإرادة وتُفسد السكينة الداخلية، بل وأزيدك دهشة يا عزيزي، قد تقود تلك الكلمة المكونة من حرفين فقط إلى حافة الانتحار. و أعلم أن وقع العبارة صادم، لكن اسمح لي أن أوضح لك مقصدي ياعزيزي.
كما ذكرنا سابقًا، فإن أغلب الاضطرابات النفسية تتشكل نتيجة تكرار ردود فعلك تجاه موقف معين. وما قد يدهشك أن هذا التكرار لا يحتاج أكثر من مرة واحدة فقط. لا أعني عشر مرات، بل مجرد مرة واحدة تُنطق فيها كلمة أو تتخذ فيها موقفًا محددًا، فتتكرر تلقائيًا في ذهنك آلاف المرات بعد ذلك، إلى أن تتراكم وتتشابك، وتشكل في النهاية نمطًا شخصيًا كاملًا، ترى من خلاله العالم وتفسّر الأحداث وفق هذه العدسة. القوة الكامنة دائماً تكون في الشرارة الأولى، التي إن لم تُضبط، قد تصوغ شخصيتك برؤية محدودة، مسكونة بالندم والقلق، وتعيق قدرتك على التعامل مع الحاضر والمستقبل بوضوح واتزان. عندها ترى الحياة دائمًا من نافذة "الاحتمال الضائع"، وليس من واقع "القدر الجاري".
وهنا يتجلّى الإعجاز النبوي إذ يقطع هذا الطريق منذ بدايته، ويمنعك من الانزلاق إلى هاوية نفسية قد تُنتج القلق أو الاكتئاب أو فقدان الرضا. فالنهي عن "لو"أشبه ما يكون بتحصين داخلي يحميك من صناعة ذاتٍ مسجونة في أوهامها، ويعيد توجيهك إلى صيغة أكثر توازنًا: "قدّر الله وما شاء فعل". وهي عبارة لا تُغلق باب السعي ولا الجهد، لكنها تُحرر القلب من ما مضى، وتربط العقل بطمأنينة الرضا واليقين بل والتحسن إن كان الخطأ منك.
ماذا لو قُلت لك أن كل هذا، إذا ربطته مع علم النفس المعاصر، ستجد أنه يُسمّى الاجترار الذهني، أو إذا أحببت المصطلح باللغة الإنجليزية، يمكنك البحث عنه بمسمى Rumination. وهو عبارة عن تكرار مستمر للأفكار السلبية المرتبطة بالندم أو الفشل أو الخوف. والمشكلة كما قُلنا ليست في الفكرة الأولى بحد ذاتها، بل في تكرارها وتحويلها إلى عادة عقلية تستنزف الطاقة النفسية. كلما استسلمت لـ "لو فعلت كذا" أو "لو لم أقل ذلك", فأنت في واقع الأمر تعيد فتح الجرح مرارًا وتكرارًا، حتى يبدأ بالامتداد والتَقّيُّح والانتشار في ذهنك، كعدوى تتغلغل في مسارات التفكير، وتستولي على تركيزك وعزيمتك وسكينتك الداخلية. وهنا تكمن خطورة هذه الدوامة، فهي لا تقف عند مجرد شعورك المؤقت بالندم في موقف واحد، بل تصنع نمطًا ثابتًا في التفكير، يتحول مع الوقت إلى إطار عقلي يشوّه إدراكك للواقع ويقيد قدرتك على التحرك بثقة نحو المستقبل إلى أن تصنع منك شخصية كاملة على هذا النمط.
وهذا ما أحب أن تعيه يا عزيزي إذا رغبت في تكوين شخصية متوازنة، على الأقل ليست مريضة نفسيًا إلى درجة السَقَم، فعليك أن تنتبه لهذا الأمر منذ البداية. لأننا بطبيعتنا، كلنا نحمل بعض العلل النفسية، بدرجات متفاوتة، كما قال الحكماء والعلماء، الإنسان بطبعه معرض للزلل النفسي والضعف العقلي أكثر من أي شيء"، وما يميّز الفرد القوي والمتزن هو إدراكه لهذه الحقيقة، وتعامله معها في كل موقف قبل أن تتجذر في العقل.
دائمًا، اجلس مع نفسك وراجع تصرفاتك في كل موقف، إسأل نفسك كيف تصرفت؟ ما القرار أو الحل الذي اتخذته؟ وما التفكير الذي راودك؟ ثم حاول معالجته وفحصه. و قد تسألني "وكيف أعرف أن هذا التفكير خاطئ من الأساس لأتمكن من تصحيحه؟" سأجيبك بطريقة بسيطة جدًا، إذا كنت تعلم أن شخصيتك ليست عارفة بكل الأمور وهذا الطبيعي، فاعلم أن أول فكرة أو قرار يخطر على بالك غالبًا ما يكون ناقصًا أو خاطئًا وهنالك افضل وأصح منه. لذلك، اكبح نفسك فورًا قبل أن تتصرف، امنح نفسك لحظة للتفكير، ثم عالج الموقف بعقل متأنٍ ونية صافية.
والأمر الآخر يا عزيزي، هو ألا تمنح نفسك هذا القدر الكبير من الأهمية. وأرجو ألا تفهمني خطأ، فالإنسان بحد ذاته أكثر المخلوقات تكريماً، كما ذكرنا في إحدى مقالاتنا سابقاً وَتَـحْـسَبُ أَنَّـكَ جِـرْمٌ صَـغِـيرٌ وَفيكَ انطَوى العالَمُ الأَكبَر، فالمقصود ليس التقليل من قيمتنا، بل أن ترى نفسك دائمًا ناقصًا، وأنك قادر على أن تفعل أفضل من ذلك، وأن هناك من حولك يتقنون ما تتقنه أو أكثر. فإذا اعتقدت أنك دائمًا على صواب، فلن تتحسن أبدًا، وهذا الغرور ذاته دليل على نقصك. وإذا أفرطت في الاهتمام بنفسك ظاهريًا، فإنك تنشغل عن تحسين داخلك، عن جوهر نفسك وضميرك.
لذلك، اكتفِ بما هو واجب عليك وما يقع على عاتقك، بما يجعلك شخصًا أفضل، وما يجعلك أمام الله من الذين يحاولون على الأقل، ويعملون بصدق ونية صافية. واجعل من عادة قلبك ولسانك أن تردد دائمًا: "الله معي، الله ناظري، الله شاهدي". اجعل هذا شعارك ومرشدك، فهو يذكّرك بالمسؤولية الحقيقية وبالحفاظ على نقاء نيتك.
وأعدك ياعزيزي، من خلال هذا التوازن ستجد نفسك تختار دومًا الأفضل في الأمور، وستزداد قوة شخصيتك واستقامة سلوكك، وستتعلم أن الثقة بالنفس الحقيقية لا تأتي إلا من الوعي بالقدرات، والعمل المستمر لتحسينها في كافة المجالات مع الاتكال على الله بالطبع.
وخِتامًا يا عزيزي، كثيرًا ما أرى الناس يُسارعون إلى إلصاق التشخيصات بأنفسهم، فيقول أحدهم إنه يعاني من اضطراب الشخصية الحدية، وآخر من الوسواس القهري، وثالث من القلق العام لمجرد شعور عابر بالحزن، أو حتى نوبة قلق، أو انفعال في موقف محدّد. فيركضون إلى المقالات والكتب، ويجدون سطرًا يشبه حالتهم، فيتخذونه حكمًا قاطعًا على ذواتهم. والحقيقة أن هذه الأحكام في الغالب سطحية، ولا تعكس إلا لحظات إنسانية طبيعية، يتقاسمها الجميع مثل ضعفٌ مؤقت، اجترار ذهني، أو خوف مؤقت. ليست كل دمعة علامة اكتئاب، ولا كل وسوسة وسواسًا قهريًا، ولا كل غضب اضطرابًا في الشخصية.
أحيانًا يا عزيزي، كل ما تحتاجه ليس تشخيصًا طبيًا، بل وعيًا أكبر بسلوكك، وصبرًا على تقلباتك، وانضباطًا في تهذيب أفكارك. ولعل الخطر الحقيقي أن تُقنع نفسك بأنك مريض بينما لست كذلك، فتبدأ لا شعوريًا في تبني سلوكيات تشبه المرض وتكرّسها حتى تُصبح عادة. ولهذا دع عنك هذه الألقاب، ولا تنشغل كثيرًا بتصنيف نفسك ولا بتحليل نمطك كما المُتداول. اجعل همّك أن تُصلح ذاتك يومًا بعد يوم، أن ترتقي في خُلقك، وتُهذّب سلوكك، وتكون أقرب إلى الله في كل خطوة. فذلك وحده ما يجعلك أقوى من كل اضطراب، وأبعد ما تكون عن الارتماء في أوهام التشخيص.
وأرجو منك ألّا تُلقِ بالًا لتحديد الأنماط الشخصية أو التصنيفات النفسية؛ فكل ذلك لن يزيدك إلا تشتتًا. لا تلقِ بالًا لنمطك، ولا تبحث في أي خانة تُصنّف نفسك. المهم يا عزيزي أن تضع تركيزك على سلوكك بدلاً من أن يكون تركيزك على نفْسِك؛ فالسلوك أصدق وأشمل من مجرد الانشغال بصورة النفس. وهو الذي يُهذّبها ويُحسّنها في النهاية. أما إذا جعلت النفس غايتك، فلن تحصد غالبًا سوى التشتّت؛ لأنك ستظل إمّا تُعجب بها إعجابًا فارغًا، وتلقِ لها بالاً كبيراً، أو تُقدّرها تقديرًا مبالغًا فيه حتى تنفصل عن الواقع. فما يرفعك حقًا ليس أوهام التقدير الذاتي، بل الممارسة اليومية للسلوك السوي، وضبط أفعالك في لحظة الفعل.
اجعل تركيزك على سلوكك فقط، راقبه، طوّره، وحسّنه. فالقيمة الحقيقية ليست في أن تعرف إن كنت «انطوائيًا» أو «حديًا» أو «وسواسيًا»، بل في أن تمتلك القدرة على تهذيب نفسك، والتعامل مع مواقفك بوعيٍ واتزان. وبقدر ما تُصلح من سلوكك، يُصلح الله حالك، ويُعينك على تجاوز ضعفك، دون الحاجة لأن تحبس نفسك في قوالب مسبقة.
يسعدني دائماً أن أفتح باب المشاركة أمامكم؛ فإن كان هناك موضوعٌ معين ترغبون في رؤيته مطروحًا إما في مقال مكتوب أو على هيئة مقطع فيديو، فلا تترددوا في مشاركتي آراءكم واقتراحاتكم بكل أريحية. ويمكنك أيضًا متابعة القناة على يوتيوب إذا رأيت أن ذلك قد يضيف لك شيئًا مفيدًا.



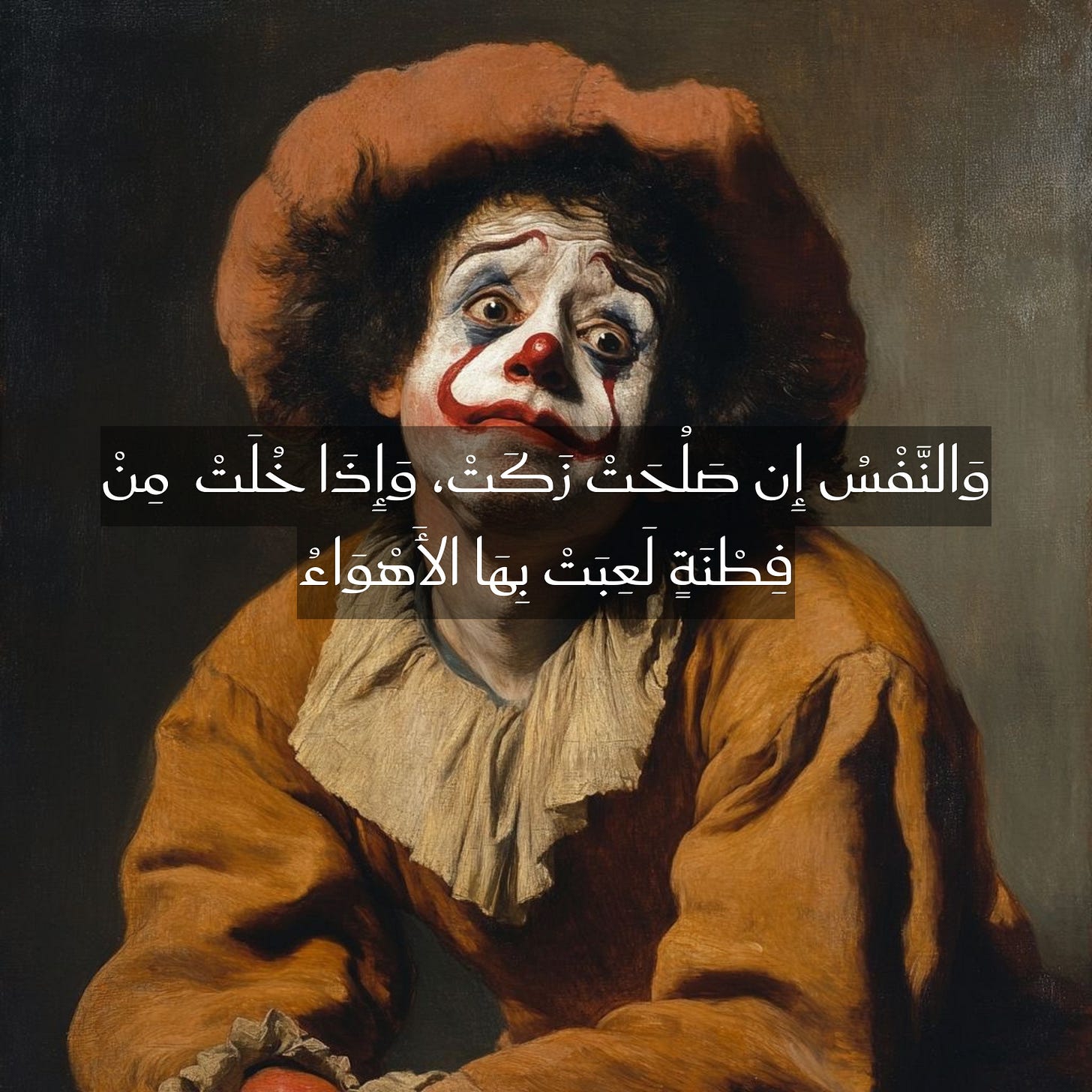


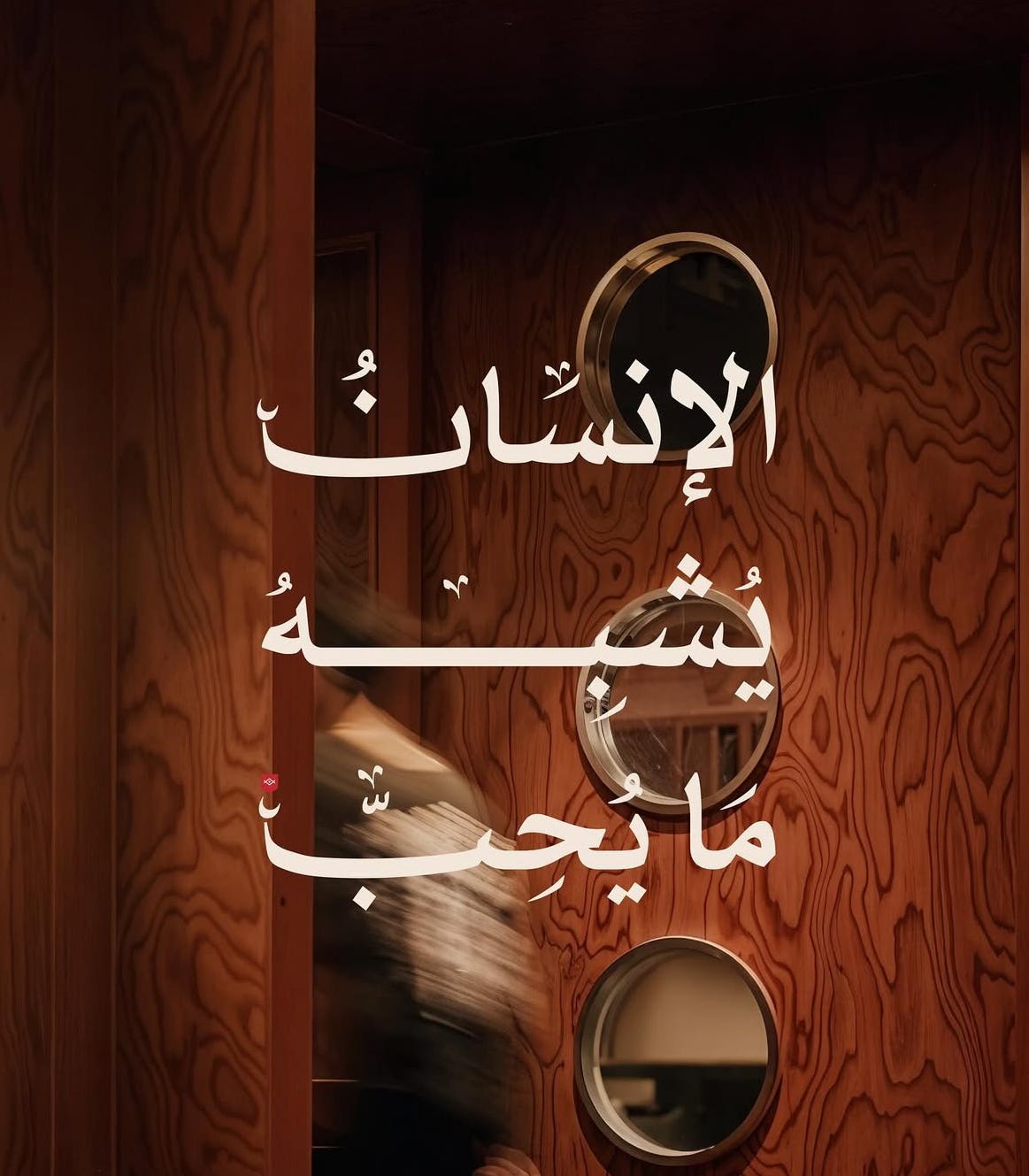
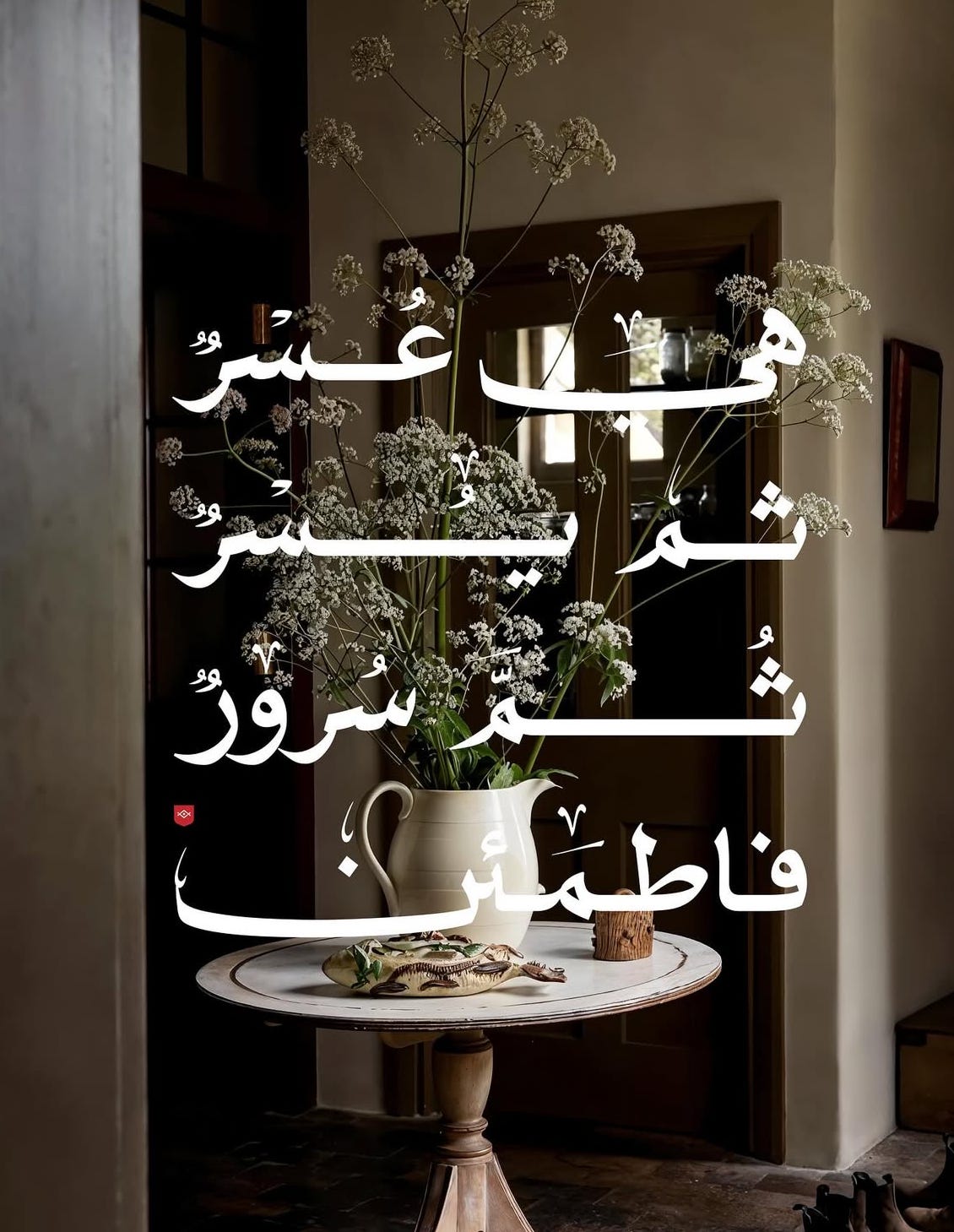
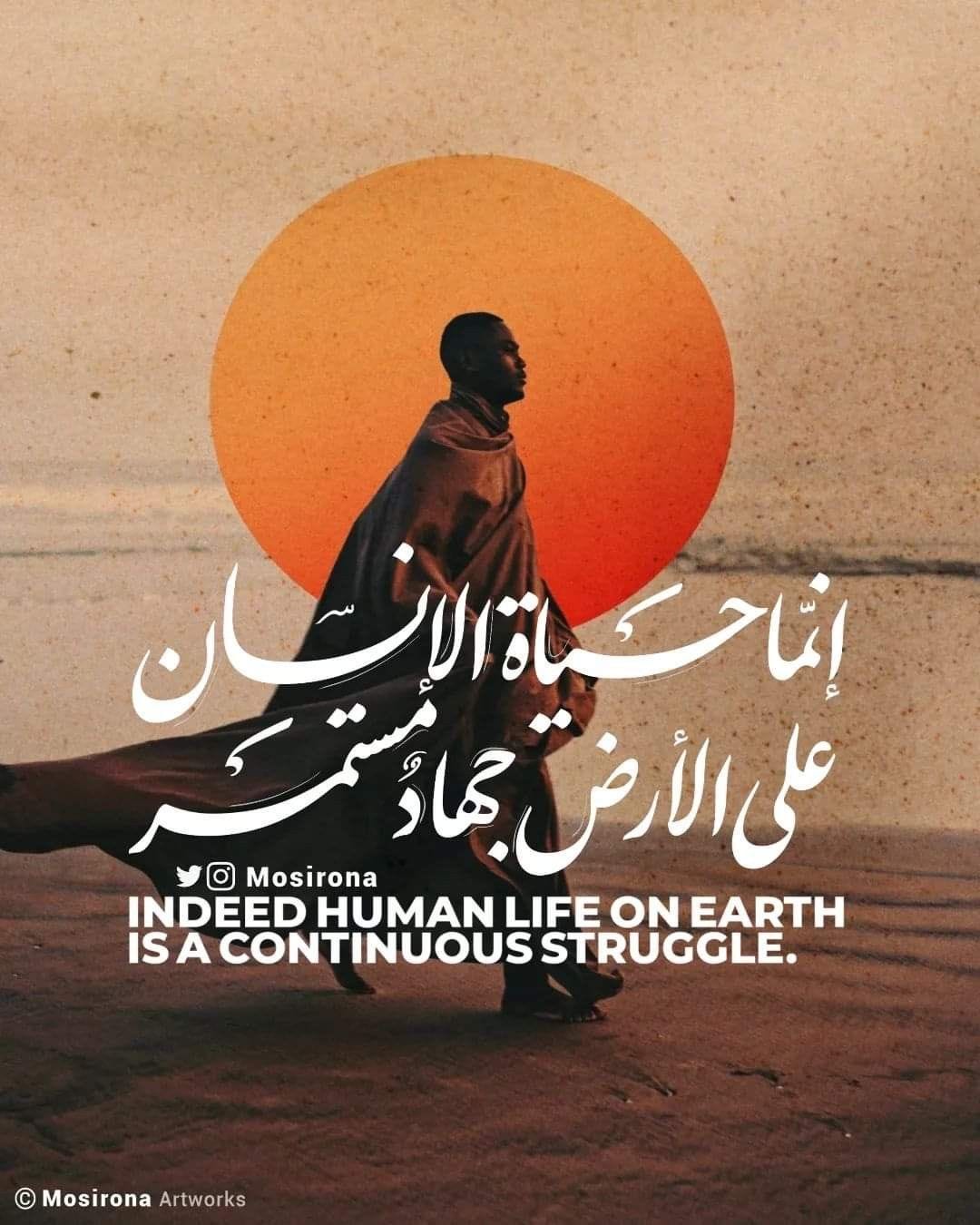
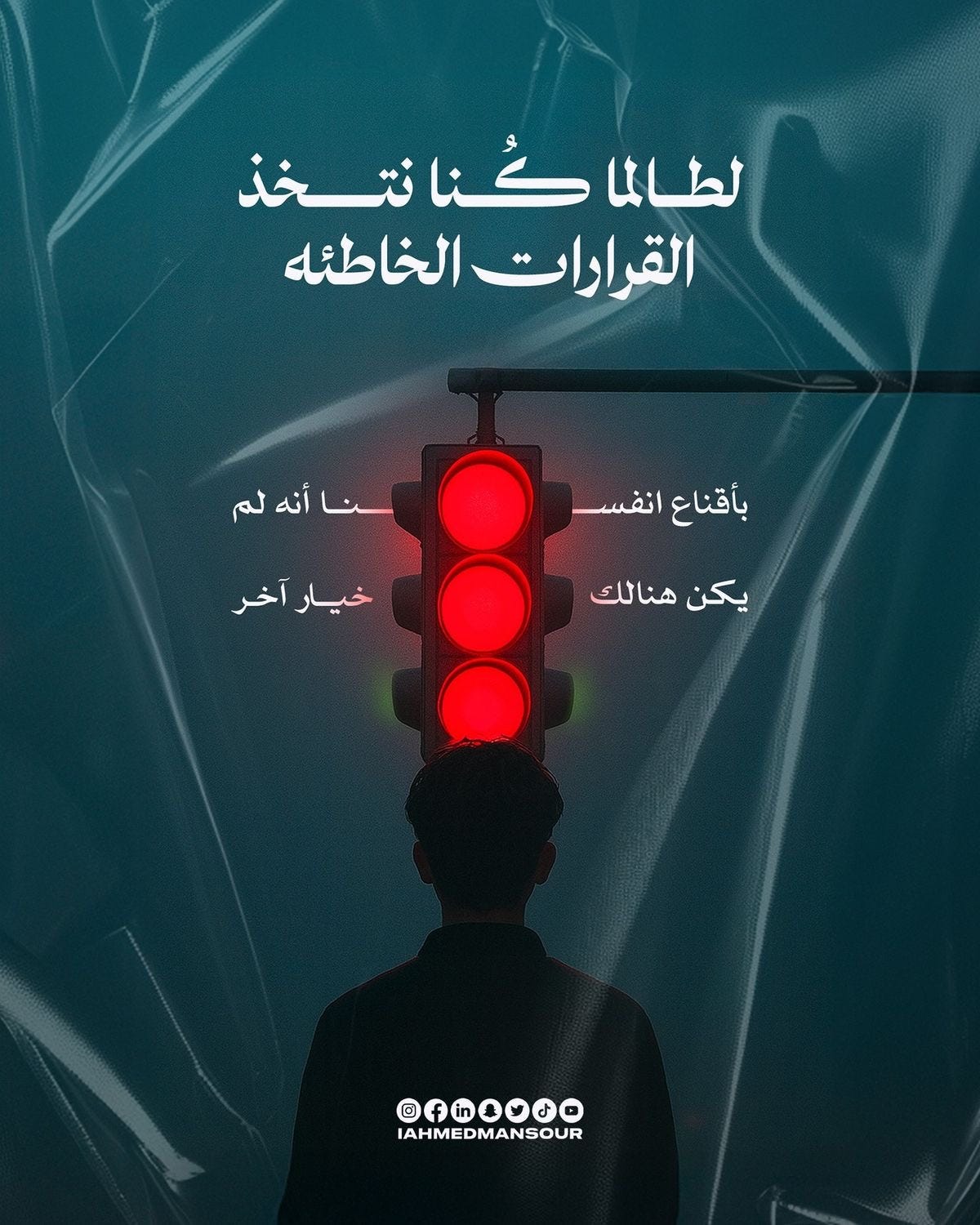
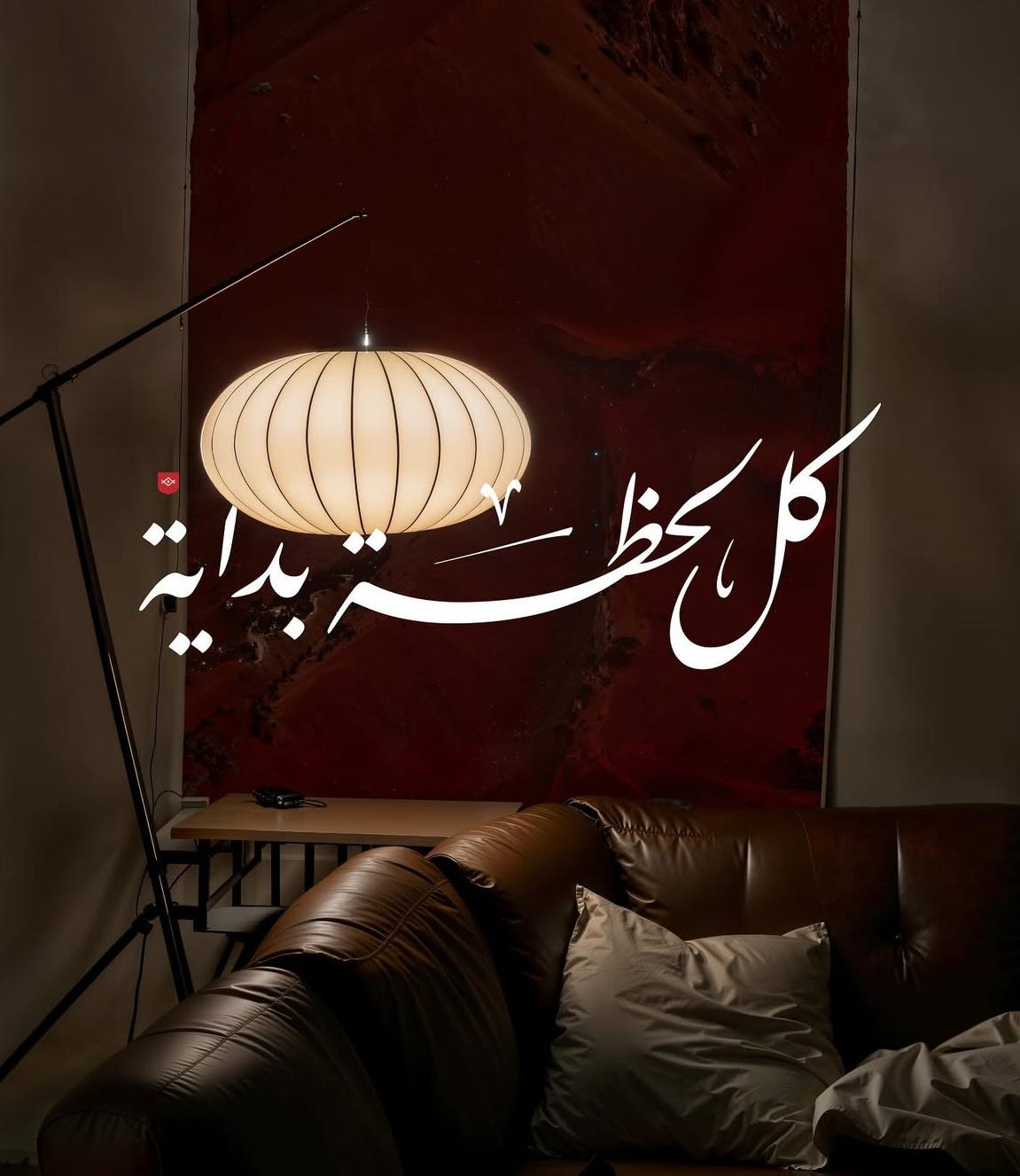
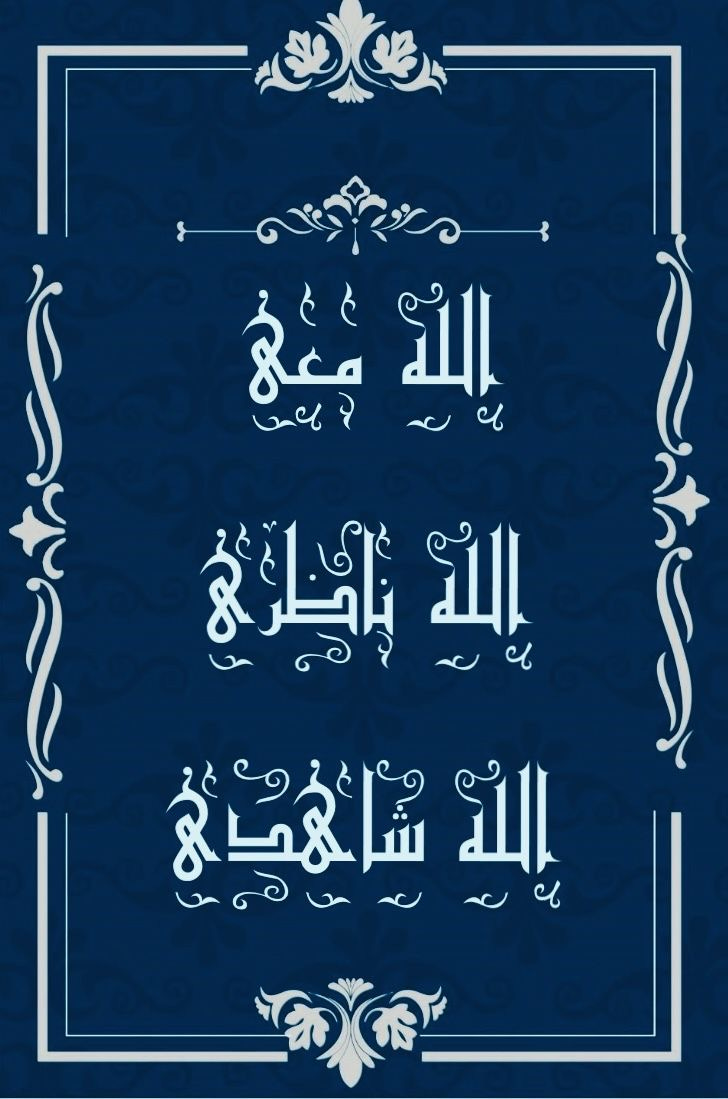
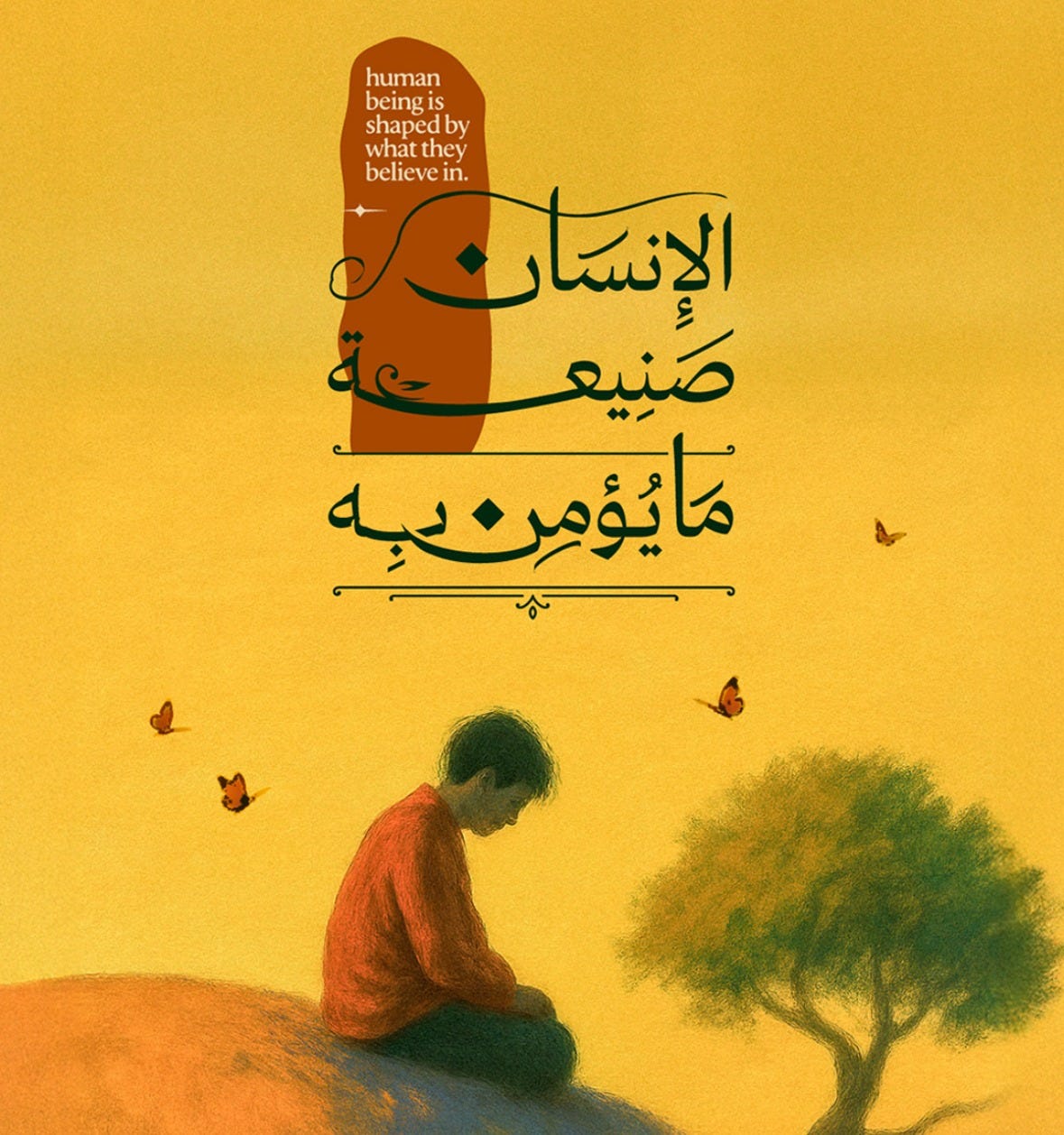
مقال رائع ومفيد كالعادة ، وقد أشرت فيه إلى نقطة مهمة وهي أن البعض يقنع نفسه بأنه يعاني من مرض بينما هو ليس كذلك ومؤخرا لاحظت أن الكثير من الناس في الواقع و المواقع يشخصون أنفسهم باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وينسبون كل تصرفاتهم وانعدام مسؤوليتهم إليه ففي الحقيقة هم فقط يعانون من تشتت التركيز وهو أمر ناتج عن كثرة تعرضهم للأفكار المتدفقة كالشلالات في المواقع... الخ ، وهذا لاعلاقة له بذلك الاضطراب، لذلك أرى أن اتجاههم واختيارهم لتشخيص أنفسهم بذلك الاضطراب ما هو إلا اختيار لطريق سهلة تجنبهم مواجهة أنفسهم لفهم حقيقة الوضع وهنا نستدل بالآية التي أشرت إليها في بداية المقال والتي تذكرنا بأهمية الوضوح والشفافية مع النفس الداخلية.
وأيضا عندما تحدتث عن الأنماط أو التصنيفات النفسية ، أوافقك الرأي فالإنسان بحاجة لمعرفة سلوكه وتهذيبه دون وضع ذاته في قوالب مسبقة ، إلا أنه في نفس الوقت أرى أنه أحيانا تكون مفيدة بحيث تساعدك على فهم سلوكاتك لتهذيبها فمثلا عندما تكون هنالك مواقف مأساوية و حزينة تختلف ردود أفعال الأشخاص تجاهها ، وعلى سبيل المثال كانت لدي صديقة أخبرتني أنه عندما تلقت عائلتها خبر مرض قريب لهم بمرض خبيث اختلفت ردودهم تجاه الموضوع فمثلا والدتها وإخوتها تأثروا بدرجة كبيرة حتى أنهم عجزوا عن الاستمرار في أعمالهم اليومية وما كان غريبا لصديقتي هي أنها هي لم تصل لهذه المرحلة ، وهذا سبب لها تساؤلات في نفسها وبدأت تشعر كأنها لا تعطي لذلك القريب أهمية وبدأت تشعر بغرابة في نفسها، وعندما استدرجنا أطراف الحديث استنتجت أنها هي عند تلقيها الخبر بدأت تبحث عن ذلك المرض وطرق ومصاريف العلاج الممكنة وماهي الأشياء التي تخفف أعراض ذلك المرض ، خلاصة القول احيانا جهلك لنمطك ونوع شخصيتك قد يضعك في مثل هذه المواقف بحيث تشعر أن اختلافك ليس طبيعيا ولكن في المقابل إذا كنت تعي نمط شخصيتك في مواجهة مواقف الحياة ستعرف التمييز بين سلوكك وتصرفك الطبيعي المختلف عن الغير والسلوك الخاطئ الذي يحتاج منك مجهودا للعمل عليه وتهذيبه.
أطلت تعليقي إلا أن هذا ما يعجبني في مقالاتك تناقش الموضوع من جوانب مختلفة وتحث العقل على التفاعل معها.
مقال رائع بارك الله فيك 🌹