الذَّكاءُ العاطِفيُّ ما بينَ الفَطْنَةِ وحُسنِ التَّعامُلِ معَ النَّفسِ والنَّاسِ
لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
بالغ السهولة أن يغمر الإنسان نَفَسه الغضب، فهو شعور فطري ينبثق دون الحاجة إلى مهارة، بل إن بعض المجتمعات تحتفي بالغضب كعلامة من علامات الذكورة والفحولة. أما الحقيقة ياعزيزي وهي التي لا يتقنها الا الأقلية جداً، فهي أن تحصر غضبك في حدود من يستحقه، وأن تُوزن ذلك الغضب مقدارًا يناسب الموقف، في الزمان الذي يقتضيه الحال، ولغرضٍ نبيلٍ متزن، وبأسلوبٍ راقٍ لا يفرط في الحد أو يعتدّي على حكمتك وعقلك. ذلك هو غضب العقلاء، غضبُ الرشد، الذي لا يفسدُ النفوس أكثر من كونه يبنيها، ومن ثم يُصلح و يمنح الإنسان قوةً على التغيير والتأثير.
على سبيل المثال لا الحصر، يظن كثيرٌ من الناس أن من يبتعد عن المشاكل هو في الأصل جبان هارب، غير مدركين أن الحقيقة، والتي يعيها القليل فقط، هي عكس ذلك تمامًا. فهو ليس جبانًا، بل هو أذكى من الجميع في الغرفة. يراه البعض جبانًا لأنه لا يخوض معارك لا طائل منها، لكنه في جوفه يردد "لِمَ أتورط في صراعات تؤذي روحي وتثقل عقلي؟ هل لأثبت قوةً لا تحتاج إلى إثبات؟" أنت قوي بالفعل، وهذا يقيناً هو من يجعلك تعرف كيف تمشي مبتعدًا عن المتاعب، دون أن تُهدَر كرامتك أو تُجَرَح نفسك، يمكنك الحصول على كل شيء بغير إرهاق نفسك او إزهاق كرامتك.
لذلك، الابتعاد عن خلق المتاعب ليس هروبًا، بل هو مهارة فائقة وقوة نفسية داهية. فليس من ضعف أن تحمي سلامة نفسك وراحتك، ولا أن ترفض إضاعة وقتك في تفاهات أو أن تسمح لغضبك أن يحترق على من لا يستحق. بل على العكس، من يملك القدرة على ضبط غضبه وإدارة نفسه بحكمة يستطيع أن يحقق نتائج تفوق كل توقعاتك.
إذا كنت من محبي علم تحليل السلوك الإجرامي، وأتمنى أن تحبه ليس لمجرد التشويق، بل لأنه يبعدك عن الوصول إلى عقل المجرم بنفسك، بمعنى أنه يمنحك فرصة لتفهم كيف وصل هؤلاء الأشخاص إلى ما هم عليه اليوم، فتتجنب أن تمشي على ذات الطريق التي أوصلتهم إلى الفساد الهالك، وتدرك كيف كانت بداياتهم وكيف انحدروا، فلا تقع في نفس الفخاخ التي وقعت فيها شخصيًا أو غيرك، فستدرك أن أبرز صفة يمتاز بها محلل السلوك الإجرامي ليست الشهادات العليا، ولا التعليم الرفيع، بل الذكاء العاطفي فقط.
والسبب في ذلك بسيط وواضح، المجرمون في جوهرهم ليسوا كائنات متوحشة أو شريرة بالفطرة، بل هم أناس عاديون تراهم في حياتك اليومية. ما افتقدوه حقًا هو الذكاء العاطفي الذي بدوره يمنح الإنسان اداة لفهم عواطفه وضبطها ومن ثم عواطف من حوله وكيفية التعامل الأمثل معها، وهذا النقص أوقعهم في غياب الحكمة والتبصّر، فصاروا أسرى لنزواتهم الداخلية ومشاعرهم الجامحة، مما أسهم أيما إسهام إلى تدهور صحتهم العقلية، وانعكس ذلك على سلوكهم الإجرامي بطرق شتى.
أعلم جيدًا يا عزيزي أنك لربما صادفت موقفًا فيه شخص يعاني حزنًا عميقًا، قد يصل إلى حد الاكتئاب الحاد، ثم يأتي شخص آخر وينطق تلقائيًا بأن السبب هو ابتعاد هذا الإنسان عن ربه. ورغم بساطة هذه الفكرة وعشوائيتها، إذ في غالب الأحوال، الناصح لا يدرك العلاقة الحقيقية بين الحزن والإيمان، وإنما يردد ما سمعه من قبل، وهذه النظرة قد تزيد من ألم المنكسرين، بل قد تدفعهم إلى مرحلة الإلحاد، لأنهم في واقع الأمر يرون الدنيا سوداء قاتمة، والآن صاروا يرون الدنيا والآخرة بنفس السواد في خيالهم.
وقد تتساءل، يا عزيزي، هل هناك فعلاً رابط بين الذكاء العاطفي والإيمان بالله؟ والجواب بكل بساطة: نعم، فهما ليسا منفصلين بل يكمل كل منهما الآخر. لكن الإشكالية تكمن في أن الشخص الحزين يحتاج إلى سماع أمورٍ معينة أولاً قبل غيرها، ولذلك كان الأصح أن يبدأ الناصح بمحاولة تنمية الذكاء العاطفي عند هذا الشخص، ومن ثم يوجهه إلى أن أحد مفاتيح الذكاء العاطفي هو حسن الإيمان بالله. هذا الإيمان بدوره يقوده إلى اكتساب جوانب كثيرة من الذكاء العاطفي بشكل طبيعي، بدلاً من القفز المباشر إلى المرحلة الأكبر، وهي الإيمان الكامل، التي قد تبدو للمنكسر عبئًا ثقيلاً يصعب تحمله في البداية. وبهذا التسلسل، يُمنح الإنسان فرصة لفهم ذاته ومشاعره، ويتعلم كيف يوازن بينها، مما يهيئه لاستقبال الإيمان كقوة داخلية تعينه على الصبر والرضا، فتتلاحم النفس والعاطفة والروح في منظومة متكاملة تعزز السلام الداخلي، والذي سيقوده الى البحث المكثف عن أن يكون ذكياً عاطفياً بشكل أكبر.
والعلاقة بين الإيمان والذكاء العاطفي مترابطة جداً في واقع الأمر إذ أن الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم المشاعر وتنظيمها، والاستجابة لها بحكمة، وهذا يتجلى في الإيمان الحقيقي الذي يمنح الإنسان قوة على الرضى والتسليم بحكم الله. فالشخص المؤمن بقدرة الله وحكمته في تدبير الأمور، يتعامل مع المحن بروح تسامح ورضا، لأنه في داخله ميقن أنه خيرٌ من الله وأن الله اعلم بما يُصلح عبده، وهو هنا لا ينكر الألم لكنه يملك من الحكمة والسكينة ما يجعله يتجاوز المحنة دون أن يغرق في اليأس، وهذا سيجعل من عقله مختلفاً ومتماسكاً مما يعينه على رؤية اوضح والذي سيقوده الى التحسين أكثر.
أما من يفتقر إلى الذكاء العاطفي، فغالبًا ما ينهار أمام الصعاب، ويلوم نفسه أو الآخرين فيبدأ بتقمص دور الضحية، ويعجز عن رؤية الخير خلف المحن، وقد تفتقر روحه إلى الطمأنينة التي يمنحها الإيمان، مما يفتح الباب أمام الصراعات النفسية وينزل من منحدر الى أشد إنحداراً. لذلك، الذكاء العاطفي والإيمان بالله هما وجهان لعملة واحدة، إذ يدعم الإيمان القدرات العاطفية على التكيف مع الحياة، ويمنح القلب راحة لا يمكن أن توجد في غياب حُسن الإيمان بالله.
وهنا يكمن الدرس الأعظم يا عزيزي وهو إن العجز عن إدارة العواطف والضغوط النفسية، مثل الحزن أو بالأخص الغضب المكبوت، و هو الشرارة التي قد تشعل عدة نيران داخل النفس البشرية. نيرانٌ بعضها تقود صاحبها إلى الهلاك، حيث يعاني من أمراض عقلية مستعصية تُحول دنياه إلى سجن لا مفر منه، وتجعله في مأزق روحي يعوقه حتى عن آخرته. ونيران أخرى تثير العنف والدمار داخل النفس، فتتفجر بأفعال تهدد المجتمع وتُسلب الإنسان إنسانيته.
وفي المقابل، فإن أغلب الجرائم، وخاصة تلك التي يرتكبها القتلة المتسلسلون، تترك خلفها خيوطًا وأبوابًا كثيرة تُسهّل اكتشافهم والقبض عليهم. وهذا لا يحدث صدفة، بل لأن الغضب المكبوت الذي يكمن في داخلهم يعمي بصيرتهم، فيُفقدهم القدرة على التروي والحكمة، فيندفعون بأفعال تترك وراءها آثارًا واضحة.
وهذا بالضبط ما يفعله كل سلوك غير حميد في عقلك. فالغضب يعميك عن رؤية الحقيقة، فيُحجب عنك نور العقل والحكمة. والحسد يعميك عن بذل الجهد والعمل، إذ يغرّك بأن الحياة عادلة مع الآخرين وليس معك، فتقضي وقتك في تمني زوال نجاحهم بدلًا من تحسين واقعك. والحقد يُطفئ فيك روح التطور، فيُقيدك داخل دائرة الضغائن التي تمنعك من النمو والتغيير. أما الكذب، فله تأثير مدمّر على الإيمان بالحقائق، إذ يجعلك أسيرًا للوهم، عاجزًا عن تصديق ما هو صحيح وواقعي ويحصل أمام عينيك. و التكبر يمنعك من قبول الأخطاء أو الاستماع للآخرين، فيُحولك إلى سجين لغرورك، فتغلق أمامك أبواب النجاح والعلم والتحسين والتطوير. وعندما يعميك التكبر، تفقد القدرة على التطور، فتظل محاصرًا في دوامة الجهل مهما بلغت من المعرفة.
كل هذه السلوكيات تعمل كعوائق أمام النضج والوعي، فتقيد إرادتك وتحول دون تحقيقك لذاتك الحقيقية. ومن هنا تنبع الأهمية الكبرى لفهم الذكاء العاطفي والعمل على تطويره، فلا يقتصر ذلك على المختصين فقط، بل هو ضرورة حتمية لكل من يطمح إلى حياة أفضل على كل المستويات، حتى المهنية منها.
وأزعم أن هذه السمة الشخصية تمثل البوصلة الحقيقية التي توجه الإنسان نحو أن يكون إنسانًا كيساً فطناً بحق، وليس مجرد كائن يعيش على هذه الأرض. وقد جسدت الأديان السماوية، وعلى رأسها الإسلام، هذا المفهوم بوضوح، حيث كرّست تعاليمها الإنسانية كلها لترسيخ هذه السمة في قلب كل فرد، لأن الأخلاق في الإسلام تتدفع بالإنسان إلى بناء شخصية كاملة متزنة، تحمل في قلبها قيم الرحمة، والعدل، والصبر، والتواضع، والصدق وغيرها الكثير. وهذه القيم هي اللبنات الأساسية التي تشكل الإنسان الحقيقي، الذي يعيش بتوازن مع نفسه ومع مجتمعه، ويكون نموذجًا يحتذى به في كل شيء.
ولو خُيّرتُ شخصياً بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، لاخترتُ العاطفي دون تردد، بل ولقطعت بذلك يقينًا لا رجعة فيه؛ إذ إن الذكاء العاطفي، حين يُصقل ويُحسن توجيهه، يفتح أبواب العقل ويهذب مسارات التفكير، فيُفضي بطبيعته إلى ذكاءٍ عقلي أرقى وأدهى. أما الذكاء العقلي وحده، مجرَّدًا من العاطفة، فقد يَقْوَى في التحليل، لكنه يَفْقِد السمة الأخلاقية بل وحتى الفكرية، ويَضعف أمام سراديب العلاقات الإنسانية، فيخطئ في مواضع الفهم، ويخيب في لحظات التقدير.
ولهذا لا يُستغرب أن ترى كثيرًا من الناس يحملون أعلى الشهادات، ويتبوؤون أرفع المناصب، ويديرون شركات كبرى بكل كفاءة، لكنهم حين يعودون إلى بيوتهم، ويجلسون أمام أبنائهم أو أزواجهم، يعجزون عن التعبير بلغة الحب، ويفتقدون أبسط مفردات العطف. فالكلمات التي تنساب منهم يمنةً ويسرةً في قاعات الاجتماعات تجفّ حين يُنتظر منها مشاعر في البيت وحين تُطلب في مناسبة مهمة، ويتحول حديثهم رغم علمهم وثقافتهم ودهائهم إلى جُمَل باهتة، خالية من الروح الإنسانية. وهذا هو جوهر الذكاء العاطفي، أن تدرك بدقة ما يحتاجه أهل بيتك من مشاعر وكلمات، وكيف تلبّي هذه الاحتياجات بما يعزز التفاهم والمحبة بينهم، وفي الوقت ذاته تعرف ما يتطلبه عملك من تنظيم وجهود حتى يُدار بكفاءة ونجاح. فالذكاء العاطفي لا يقتصر على فهم الذات فقط، بل يمتد ليشمل إدراك مشاعر الآخرين ومتطلباتهم، فتخلق توازنًا بين حاجاتك الشخصية ومسؤولياتك المهنية والعائلية. وهكذا يصبح الإنسان قائدًا حكيمًا في حياته الخاصة وعمله، ينسج علاقات متينة ويحافظ على بيئة مليئة بالثقة والاحترام، مما ينعكس إيجابًا على جميع جوانب حياته.
ولذلك فالذكاء العاطفي يتركز في جوهره على شِقين، الشِق الأول هو أنه القدرة على فهم مشاعرك التي ينتج عنها سلوكك، ومن ثم إدراك كيفية التعامل معهما بوعي واتزان، ثم توجيههما توجيهاً صحيحاً نحو الحل الأمثل في المواقف المختلفة. والشِق الثاني يتمحور حول علاقتك بمن حولك وأمامك فيصبح مهارة قراءة مشاعر وسلوك الآخرين كما لو كنت تقلب صفحات كتاب مفتوح أمامك، فتتخيل بوضوح ما كنت لتفعله لو كنت في موقعهم، مع استحضار التعاطف الذي يُمَكِنُكَ من فهم دوافعهم وردود أفعالهم دون أن تفقد موضوعيتك أو حكمك السليم.
لكن فهم جوهر المسألة وأصلها حول الذكاء العاطفي، أبعاده وسماته، بل وحتى كيف يمكن للفرد أن يبدأ أولى خطواته في هذا المسار، يتطلب منا أن ننظر إلى الأمر من زاوية مختلفة. ربما تكون البداية المثلى أن نطرح السؤال عكسياً وهو لماذا لا يمتلك الجميع سمة الذكاء العاطفي؟
الإجابة يا عزيزي ليست بذلك القدر من التبسيط الذي قد يغرينا بسطحه ويخدعنا بمظهره. فبالرغم من أن مصطلح "الذكاء العاطفي" أصبح على ألسنة الجميع، وبالرغم من أن الكثيرين يتناولونه من باب الإثارة والتشويق، إلا أن هذا بالذات قد يكون أكبر عائق أمام الفرد في تعلم أي شيء أو إتقانه. فحين يكون دافعك الوحيد هو التشويق، فأنت كمن يركض وراء شعلة يعرف انها ستنطفئ مع أخف الرياح؛ ما إن تخبو حتى تجد نفسك في الظلام، بلا حافز ولا رغبة في الاستمرار. وهذا ما يحدث في كثير من مجالات الحياة، يشرع الإنسان بحماسة مشتعلة، لكنه لم يربط شغفه بهدف أسمى أو معنى متين، فيتوقف عند أول فتور، وكأن الطريق لم يبدأ أصلًا.
وبالرغم ايضاً من وجود مئات، بل آلاف الكتب التي تتناول الذكاء العاطفي، وتشرحه من زوايا شتى، إلا أن كثيرًا ممن قرأوها، بل مرّوا عليها مرارًا وتكرارًا لا يزالون عاجزين عن تجسيد هذه السمة في واقعهم، لا قولًا ولا فعلًا. فأين تكمن الإشكالية؟ هل هي فينا نحن؟ أم في أساليب التربية؟ أم في طبيعة الكتب ذاتها؟ أم لعل الخلل في فهمنا للمفهوم نفسه؟
والحق أن المسألة أكثر تشعُباً من أن تُسند إلى عامل واحد. فالتربية تلعب دورًا محوريًا؛ إذ إن الطفل الذي يُمنَع من التعبير عن مشاعره، أو يُسخر من دموعه، أو يُعلَّم أن الصمت هو علامة النضج، فينمو مشوّه الإحساس، بارعًا في كبت العواطف، لكنه عاجز عن التعبير عنها، فتتراكم داخله مثل بركان مكتوم، حتى يصبح، حين يبلغ أشده، ضجيجًا عاصفًا داخليًا وفريسةً لنفسه المتمزقة في الوقت ذاته.
أما الكتب، بالرغم من ما تحويه من أدوات وطرائق ونصائح، فإنها لا تكفي وحدها لصناعة التغيير الحقيقي. فالمعرفة النظرية، مهما بلغت، تبقى مجرّد بذور ما لم تُروَ بتدريب داخلي، وممارسة مستمرة، ومراجعة للسلوك اليومي. والسبب ببساطة أن الإنسان، في لحظات الحسم، لا تحكمه المعلومات بقدر ما يحكمه طبعه، والمواقف لا تأتي على راحتك ومهلك، بل تُباغتك، وتفرض عليك رد فعل في لحظة قد تكون أسرع من أن تُفكر حتى. فالمشاكل تنفجر في لمح البصر، واتخاذ القرار غالبًا ما يكون في ظل ارتباك، أو توتر، أو ضغط، وهو ما يُنهك العقل ويُضعف الوعي. ففي تلك اللحظة الفاصلة، هل سيتاح لك الوقت لتستعرض ما قرأته في الكتب؟ غالبًا لا.
حتى وإن قلنا إن قراءتك لكتب الذكاء العاطفي ستثمر يومًا ما وهذا قول لا يخلو من الصحة بالطبع، إلا أن ثمرتها تبقى محدودة إذا لم تُقرن بالتطبيق والممارسة اليومية. فالفكرة، مهما بدت ناضجة في ذهنك، تظل عرجاء إن لم تمشِ على أرض الواقع. لكن ما نبحث عنه في الحقيقة، أسمى من كل ما كُتب في الكتب، لأن معظم ما يُطرح هناك يُروى من منظور عقلي بحت، مفرغ من الروح، مفصول عن القيم العليا التي يُهذّب بها الدين النفس الإنسانية. بل إنك في كثير من تلك الكتب، تجد الطرح محايدًا أو إن صح القول مُسطّحًا لا يقيم للدين وزنًا، كأن الإيمان عبء على الذكاء، أو كأن الروح تُعيق صفاء الفكر.
بل الأسوأ، أن بعضها يُطعِّم نصائحه بسموم خفية، كمن يُدَسُ السم في العسل، تدس الشك في الإيمان، وتروّج لفكرة أن العقل وحده يكفي، وأن أكثر العاقلين لا يؤمنون أصلاً بوجود إله. وهنا تكمن الخديعة الكبرى وهي فصل الذكاء عن الأخلاق، وفصل السلوك عن الضمير، وفصل الإنسان عن خالقه.
وما لا يدركه كثيرون أن الدين حين يُفهم فهماً جيداً فهو أعلى درجات الذكاء العاطفي منا وضحناً سابقاً، لأنه يُعلّمك كيف تضبط نفسك، كيف ترحم، كيف تحب، كيف تعفو، كيف تردّ السيئة بالحسنة بدافع النبل والرفعة. فما الذي يُعلّمك الصبر على الأذى، وضبط الغضب، وكظم الغيظ، والعفو عن من أساء إليك، إن لم يكن دينك؟
والأمر الذي لا مفر منه هو الاعتراف بأن أحد أعمدة الذكاء العاطفي شئنا أم أبينا يُغرس فينا من خلال التربية والتنشأة. هذه هي الحقيقة التي لا تقبل المجاملة. فالتنشئة التي نتلقاها في طفولتنا تشكّل القالب الأول والأساسي الذي يتكوّن فيه إدراكنا للمشاعر، وحدود التعبير، وآداب الاختلاف، وكيفية التعامل مع النفس والآخر، وهل من الضروري أن يكون والداك على دراية تامة بأنهما يربّيانك وفق مبادئ الذكاء العاطفي؟ ليس بالضرورة أبدًا. بل في كثير من الأحيان، قد يمارسان هذا النوع من التربية الفطرية دون أن يُسمّياه، أو يُدركا ماهيته العلمية. قد لا يعرفان المصطلحات، ولا قرآ كتبًا عن "تنظيم المشاعر" أو "التعاطف الوجداني"، لكنهما يزرعان فيك، دون أن يدروا، بذور الاتزان، والرحمة، والقدرة على فهم نفسك والطرف الآخر.
نعم، يمكنك لاحقًا أن تكتسب خبرات، وتنمّي وعيك، وتُهذّب نفسك، وربما مع الوقت والإصرار والتعلم تتجاوز في نضجك العاطفي من ربّاك. ولكن، لا تنسَ أن البذرة الأولى زُرعت هناك من والديك. وإن لم تُزرع هذه البذور في الصغر، فالأمر لا يعني أنها ضاعت للأبد. لكنها حين تُزرع متأخرة تحتاج ضعف الجهد، ومزيدًا من الألم، ومسيرة طويلة من الوعي الذاتي، لتصل إلى ما كان يمكن أن يكون طبيعيًا لولا ذلك الغياب التربوي. لهذا، فالذكاء العاطفي ليس مهارة تتعلمها من دورة تدريبية وحسب، بل هو نتاج حياة، وتجارب، ونشأة وجرأة على مراجعة الذات كلما أخطأت أو قصّرت.
واسمح لي، يا عزيزي، أن أضرب لك مثالًا لتوضيح جزء من سمة الذكاء العاطفي في التربية. في إحدى الرحلات المدرسية لنشاط غير صفّي لطلاب المرحلة الابتدائية، كانت الزيارة إلى المسجد النبوي. وبينما الطلاب يصطفون وينظمهم المُعلم المسؤول عنهم، كنت جالس بإنتظار الأذان، ولاحظت أحد الطلاب يضرب زميله على كتفه، فاستاء الطالب المضروب وسرعان مااشتكى لأبيه. كان رد الأب غير متوقع؛ إذ قال له "اضربه كما ضربك، وإن لم تفعل، فسأكون أنا من يضربك." استجاب الطالب للأمر وضرب زميله أمام المُعلم دون مبالاة بالعواقب، مما دفع المُعلم إلى وصف الطالب بالعدواني، غير مدركٍ أن هذا التصرف كان رد فعل.
حينها، ظللت أفكر مكان الأب، متسائلًا: ما كان التصرف الأمثل في هذا الموقف؟ والحقيقة أن هناك العديد من الطرق التي كان يمكن أن تكون أكثر حكمة وفعالية، وحتى إذا حاولنا أن نفهم تفكير الأب من وجهة نظره، ونتبنى مكانه ناهيك عن كونه تصرف خاطئ أو صحيح، فإن أقل ما كان يمكن فعله هو تنبيهه لابنه بضرورة اختيار الوقت المناسب للرد، ذلك بأن الأسد لا يخرج من عرينه إلا في الوقت المناسب، وعندما تكون الظروف قد نضجت لتُجبره على ذلك، وبأن تكون ضربته أكثر رقة، كنوع من "بصمتة" المميزة التي لا تتغير بتغير منافسه، والتي تعبر عن قوته دون أن تثير رد فعل عاطفي مبالغ فيه من المنافس.
الآن يا عزيزي، لنحاول أن نتبنى وجهة نظر الأب من منظوره هو أولاً ناهيك عن كونه فعل خاطئ ام صحيح، ثم ننتقل إلى المنظور المتطور أو الأصح بالنسبة له و الذي تطرّقنا إليه سابقًا. إذا أخذنا موقف الأب كما هو، بمعنى أنه يريد لابنه أن يأخذ بحقه دون النظر للظروف أو التوقيت، فإنه بذلك يُنتج شخصًا سريع الانفعال، يغلب عليه الغضب الذي يعميه عن الحكمة والعقل، وهذا، بالمناسبة، سيعيقه أيضًا عن نيل حقه بأفضل طريقة ممكنة، إذ قد يردّ الفعل بالمثل على الظلم الذي يراه، وربما يتبنّى وجهة نظر خصمه مهما كانت قاسية أو بغيضة. وهكذا يصبح عقله في الحقيقة وعاءً لكل الأفكار والسلوكيات التي تعرّض لها، يستقبلها ويكررها بلا وعي أو تمييز، وهذا سكون خطراً عليه في المستقبل دون ان يدرك او حتى يتذكر ما السبب في هذا.
وهذا المنطق، يا عزيزي، هو الذي قد تلاحظه يتكرر بإجتنابه عبر التاريخ مرارًا، مثلما حدث أيام صلاح الدين الأيوبي، حاكم مصر وبلاد الشام، الذي قاوم الحملات الصليبية مرات عدة. حين فشلت هذه الحملات في هزيمته، لجأ الصليبيون إلى استخدام ورقة الضعف كما الحال اليوم في المعارك غير المتكافئة، وهي قتل الأبرياء والمدنيين المسلمين في القدس التي كانت تحت حكمهم. فكيف كان رد فعل المسلمين؟ لم ينزلوا إلى مستوى الانتقام الأعمى، بل بنوا كنائس عديدة في مصر التي كانت تحت حكم المسلمين، وسكنوها مسيحيون بل وصرفوا لهم مساعدات مالية.
والسؤال هنا هو لماذا لم يتعامل المسلمون بالمثل؟ لماذا لم يقتلوا كل من ليس على دينهم كرد فعل؟ لأن لكل إنسان بصمته الخاصة، وقلبه الثابت الذي لا يتغير بتغير خصمه. فالإنسان لا يصير نسخة مقلدة لخصمه، مهما كانت الظروف. تمامًا، وكما كان شانتلوين أحد قادة الحملة الصليبية مثالًا للفساد والإجرام وإنعدام المروءة، بأن ذبح كل من كان في طريقه للحج من المسلمين، فقد كان باليان على النقيض تمامًا، فارسًا حقيقيًا يتحلى بأخلاق الفروسية، من شجاعة في الميدان، وكرم في المواقف، ووفاء في العهود، واحترام حتى لعدوه في أحلك الظروف. وهذا ما جعل صلاح الدين الايوبي وباليان لديهم إحترام متبادل. وهذا هو أحد أهم أركان الذكاء العاطفي و هو القدرة على أن تظل متزنًا وإنسانياً، رغم العواصف، تطبيقاً لقول الرسول ﷺ "لا تخن من خانك"، وكما قال أحد الشعراء "يُخاطِبُني السَّفِيهُ بِكَلَ قَبْحِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ مُجِيبًا، يَزيدُ سَفَاهَةً فَأَزِيدُ حِلْمًا كَعُودٍ زَادَهُ الإِحْرَاقُ طِيبَ".
وبهذا نستدل على أن الذكاء العاطفي يقوم على عدة أركان أساسية تشكل معاً بنيانه المتكامل. سنستعرض هذه الأركان بإيجاز أولاً، ثم نفصل الحديث عن كل ركن منها على حدة، حتى تتضح الصورة أكثر ويصبح إدراكها أسهل. فالفهم المبدئي يمنحنا الإطار العام، بينما التحليل التفصيلي يكشف لنا العمق العملي لكل جانب.
من أبرز هذه الأركان هو الوعي بالذات، والتحكم في الانفعالات، وفهم الآخرين، والتعامل الأمثل مع المواقف. وتتجلى هذه الأركان بوضوح في قدرة الفرد على تحليل الشخصيات واستيعاب دوافعها، بل وحتى توجيهها أو التأثير عليها للوصول إلى أهدافه. ومع ذلك، فإن هذا كله لا يتم توظيفه بدافع الأنانية أو الاستغلال، بل يسعى دائماً للحفاظ على منظومته الأخلاقية الى أبعد حد. وهنا تكمن المفارقة العظيمة، كثير ممن يمتلك هذه السمة ينزلق إلى استغلال ذكائه العاطفي لخدمة مصالحه الشخصية فقط، متجاهلاً المبادئ والقيم. أما القلّة النادرة التي تحافظ على توازن بين الذكاء واستخدامه الأخلاقي، فهي تمثل حالة استثنائية تستحق الوقوف عندها، وهذا مُرادنا سوياً ياعزيزي.
الآن، إسمح لي ياعزيزي أن نُفصل كل ماقلناه لتتضح لنا الصورة الأكبر، ولكل ركن سنطرح سؤال، ولربما أول سؤال نطرحه ما المقصد من الوعي بالذات؟
الوعي بالذات هو أن تعرف وتفهم طبيعتك الشخصية، وهو أن تدرك ما الذي يستثير انفعالك، وكيف يتجلى هذا الانفعال في سلوكك، وما العواقب التي تترتب عليه عادة. تدرك مثلاً أنك تغضب لسبب معين، وأن غضبك يتخذ نمطاً محدداً، وأنك غالباً ستشعر بالندم بعده. وهذا الوعي لا يتأتى إلا عبر مراجعة حقيقة مع نفسك، وتدوين لحظات إنفعالك ونصيحتي لك دونها كل مااستطعت حتى وإن كان عبر مذكرة صوتية إن لم تحتمل التأجيل للكتابة، وكما ذكرنا في مقالاتنا السابقة سوياً ياعزيزي، "لايجب أن يخلو يومك من مراجعة نفسك" تطرح خلالها سؤالاً محورياً ألا وهو هل كانت هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع المشكلة؟
قد تجيب بنعم، وتقتنع أن لا بديل عنها، وقد تقول وهو الأصح، نعم، ولكن كما أن لكل صحيحٍ أصح، فلكل طريقةٍ طريقة أذكى وأكثر أثراً. ومن هنا تدرك أن أمامك دائماً مساحة لتطوير أسلوبك واختيار ما هو أكثر فاعلية.
وماذا بعد أن تعي بذاتك؟ يحدث أن تمتلك زمام مشاعرك، فلا تتعجل في الحكم على أحد، ولا تبني قراراتك على أول صورة رسمها عقلك، وغالباً اول صورة او حل يرسمه عقلك لك يكون اقل فاعلية، لأنك تعلم أن الإنسان بطبيعة الحال عرضة للخطأ في التقدير. تدرك كذلك أن الحلول لا تنحصر في تفجير الغضب، بل قد توجد بدائل أكثر حكمة وهدوءاً وأكثر فاعلية.
قد تتسائل ياعزيزي ولماذا لا أغضب؟ وما الضرر في ذلك؟ هنا نصل إلى الجواب على شِقين:
الشق الأول ديني، استلهاماً من قول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب"، وفي الحديث الآخر: "ألا أخبركم بمن يحرُم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب، هيّن، ليّن، سهل". وحين يأتيك النهي النبوي الصريح عن فعلٍ ما مثل قوله ﷺ "لا تغضب" فاعلم أن وراءه ضرراً محققاً عليك قبل غيرك، ليس في الآخرة فحسب، بل في دنياك أيضاً. فالغضب يفسد صفاء الفكر، ويعكّر صفو القلب، ويقودك إلى قرارات ونتائج قد تندم عليها لاحقاً، كما أنه يزرع مسافة بينك وبين من حولك، ولو كانوا أحبّ الناس إليك.
أما الشق الثاني، فهو الجانب النفسي والاجتماعي إذ أن قدرتك على ضبط انفعالك تمنحك حضوراً أوقر، وكلمة أوزن، وأثراً أعمق. فمن يواجه الأحداث بعقل راجح وصدر رحب، لا فقط يحافظ على اتزانه، بل يملك زمام الموقف، ويكسب احترام من حوله حتى في لحظات الخلاف.
واسمح لي ياعزيزي أن أضرب لك مثالاً من تجربتي الشخصية في هذا الأمر لكي تتضح لك الصورة أكثر.
أي شخص جرّب التدريب على الفنون القتالية كالملاكمة أو الجودو أو فنون القتال المختلطة أو بطولة القتال النهائي المعروفة باللغة الإنجليزية UFC، سيدرك أن الغضب ليس سلاحاً في صفّك، بل عليك، حتى لو وضعنا الفائدة الدينية جانباً مع العلم أنه يستحيل أن تضع الفائدة الدينية جانباً إذ أن كل الأمور في الحياة مبنية على الدين اولاً وقبل أي شيء لأنها غاية خلقنا.
لا أخفيك سراً ياعزيزي، في إحدى مراحل حياتي الدراسية، كنت ميّالاً إلى استخدام يدي أكثر من استخدام عقلي في فض الخصام. وكنت حينها صغيراً، يافعاً، متهوّراً؛ تحديداً في المرحلة الإعدادية أو كما قد تسميها بعض الدول العربية الصف الثامن وشاكلته، حين يكون العمر بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة تقريباً. كنت من أولئك الذين يعشقون العراك في المدرسة، مدفوعاً بما أشاهده يومياً من عروض المصارعة والملاكمة والجودو وسائر فنون القتال. حتى حين منعني والداي من مشاهدتها، كنت أتحايل وأذهب إلى بيت صديقي لأتابعها هناك. لاحظت المدرسة ميلي هذا، فقررت بدلاً من قمعه إذ حاولو قمعه عدة مرات ولكن لا جدوى، فقررت أن تستثمره ومنحتني منصب رئيس النظام في المدرسة. والنظام، لمن لا يعرفه، كان مجموعة من الطلاب المخوَّلين بالتحرك في أي مكان من المدرسة بلا قيود، وكانت مهمتهم الرئيسة تعميم النظام في المدرسة، وهي ميزة كانت أشبه بالحلم لأي طالب وقتها.
بالفعل تقلدت المنصب، ومعه بدأت تنمو داخلي روح المسؤولية. لكن للأسف، ما زال العراك حاضراً في ذهني ولكن هذه المرة كوسيلة "لإحقاق الحق". فإذا تنمّر أحدهم على طالب ضعيف، كنت أعتبر نفسي مسؤولاً عن "ردعه" بيدي، ظانّاً أنني بذلك أنصر المظلوم. لكن مع مرور الوقت، أدركت أن هذا السلوك رغم نبل الدافع كان خاطئاً؛ لأن هناك تسلسلاً طبيعياً للمسؤوليات، والمعلمون هم الأجدر والأقدر على التعامل مع هذه المواقف بحكمة، بعيداً عن العنف بين الطلاب.
ومع النضج والخبرة، فهمت أن القوة الحقيقية لا تكمن في أن تُسقط خصمك أرضاً، بل في أن تملك السيطرة على نفسك حين تكون قادراً على ذلك. فالملاكم المحترف يعلم أن أقوى ضربة قد توجهها أحياناً هي تلك التي تختار ألا تُطلقها. ولم تكن هذه الصفة على غرابتها تؤثر سلباً على تحصيلي الدراسي، بل كانت، بشكل لا يُفهم، مكمّلة له إذ انني كنت افضل تماماً ما بين المذاكرة وغيرها من الأمور. لكن عندما دخلت المرحلة الثانوية، تغيّر الأمر تماماً. كنت قد اقلعت عن هذه العادة. ولكن سرعان ما افتعل احدهم مشكلة معي امام المعلم والمعلم لم يردعه بأي شكل من الأشكال فتلفظ بلفظ مسيئ أمام الفصل بأكمله، فقررت لكمه في الفور، فمع أول لكمة وجهتها لهذا الشخص، كُتب عليّ تعهّد خطي، وكانت هذه المدرسة من أرقى المدارس في المدينة المنورة، لا يدخلها إلا الطلاب المتفوقون والأوائل من المرحلتين الإعداداية والإبتدائية، وكان مقرها الأساسي أمام المسجد النبوي مباشرة ويعرفها من سكن المدينة تماماً. مدرسة عريقة خرّجت أساتذة وعباقرة من أبناء المدينة، وكان مبناها ضخم كبير ذات ادوار عديدة كما كان يشبهه البعض بمدرسة "هاري بوتر".
ذلك التعهّد لم يمر مرور الكرام؛ فقد خاطبت المدرسة والداي، الأمر الذي دفع أهلي إلى اتخاذ حلّ معاكس لما قد يتوقعه البعض. في ذلك الوقت، كان يومي مشحوناً بالكامل، بين المدرسة، وحلقات التحفيظ، والنادي الرياضي، وممارسة هواياتي، ولكن تم إضافة مهمة جديدة إلى الجدول، وهي الذهاب إلى حلبة الملاكمة، ليس للتشجيع على القتال، بل لتعلّم السيطرة على المشاعر، ذهبت لأول مرة وأنا أرى في نفسي بطلاً لا يقف أمامه أحد. لكن بمجرد أن وقفت في الحلبة، جاء المدرب، وبلا مقدمات، وجّه لكمة مباشرة إلى وجهي، ثم سألني بابتسامة "ماذا ستفعل الآن؟". اشتعل غضبي، واندفعت لأردّ عليه، لكنني لم أستطع لمسه حتى، إذ كان يتفادى كل ضربة بحرفية عالية، إلى أن أسقطني أرضاً. عندها، اقترب مني وقال جملة لم أنسها حتى اليوم: "كل ضربة وجهتها لي كانت في المكان الخطأ، وهذا لأنك غاضب. وكلما زاد غضبك، تشوّش عقلك، فتفقد دقة ضرباتك، بل وتفقد قدرتك على لمس خصمك أصلاً." ومنذ تلك اللحظة أدركت أن الغضب ليس قوة، بل ثغرة فادحة تفتحها في دفاعك، وأن السيطرة على النفس أعظم مهارة يمكن أن يمتلكها إنسان، سواء في الحلبة أو في الحياة.
ومع مرور شهور من التدريب، استوعبت درساً بالغ الأهمية، كلما أتقنت فنون القتال، كلما سعيت إلى تجنّبها مهما كلّفك الأمر. وكلما أدركت أن الغضب خصلة مذمومة تشوش عقلك، ازددت يقيناً بأن خصمك الحقيقي هو نفسك، لا غير. وفي يومٍ من الأيام، خرجت مع مدربي لنتناول وجبة خفيفة في مطعم قريب من المركز الرياضي. وأثناء الطريق، إذا بشخص متهور يسرع متجاوزاً سيارة المدرب، ثم يطلق عليه سيلاً من الشتائم، ويتوقف أمامه بلا أي سبب. توقعت أن يتوقف المدرب ويرد عليه، لكن المفاجأة أنه لم يعيره أي اهتمام، بل اكتفى بالابتسام قائلاً بهدوء: "هداك الله، وأعادك إلى رشدك"، ثم تابع طريقه وكأن شيئاً لم يحدث. كنت أعلم تماماً أن هذا المدرب بلا أي مبالغة كان بإمكانه أن يبرحه ضرباً بطريقة لم يتخيلها ذلك المتهور قط. فقد كان من طراز المقاتلين الذين يستطيعون مواجهة عشرة أشخاص في آن واحد دون أن يتمكن أحد من لمسه، إذ تمرّس على فنون القتال منذ نعومة أظافره، وصقلها حتى صارت جزءاً من تكوينه.
لكن في تلك اللحظة بالأخص، فهمت درساً أكبر من أي حصة تدريبية، القوة الحقيقية ليست في أن ترد على الاستفزاز بالقوة، بل في أن تمتلك القدرة الكاملة على الرد، ثم تختار أن لا تفعل. ذلك الموقف علّمني أن ضبط النفس قمة القوة، وأن التحكم في رد الفعل أرفع شأناً من إتقان أي فن قتال.
كان مدربنا حينها يقدّم لنا دروساً أخلاقية أعمق من مجرد تعليم القتال. كان يقول: "لا تبدأ أي عراك. أنت دائماً الحلقة الأضعف في الأمر، لأنك صاحب العقل الواعي، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟" وكان يؤكد أن القتال يجب أن يكون فقط للدفاع عن النفس، حتى إذا ضربك أحدهم، فلا تتخذ وضعية الهجوم أبداً؛ بل ضع نفسك في موضع المدافع فقط. وهناك فرق كبير بين الاثنين، المدافع يحمي نفسه ولا يهاجم، وإن اضطر للرد، يوجّه ضرباته لليد أو القدم فقط، لوقف اعتدائه فقط وليس لإذائه، وهذا قمة في الرحمة.
حتى القتال نفسه كان له ضوابط صارمة، إياك أن تضرب رجلاً أمام أطفاله، إياك أن تؤذي رجلاً برفقة عائلته، إياك أن تضرب رجلاً أمام زوجته، إياك أن تضرب رجلاً أمام أمه، إياك ثم إياك أن ترفع يدك على امرأة، ومهما حدث، انظر إليها كأمك وأختك وعرضك. عندها فقط أدركت أن هذا لم يكن تدريباً على القتال بقدر ما كان تدريباً على النُبل وضبط النفس، وعلى أن تكون سيد مشاعرك وليس أسيرها. ومنذ ذلك الحين، لم أدخل أي عراك قط، مهما كانت الاستفزازات، وكنت أتجنبه كما يتجنب المرء وسوسة الشيطان، بل واعتذرت للشخص الذي لكمته في مرحلة الثانوية حتى وإن كان هو من بدأ هذا الشجار.
وهذا ما أود أن أنقله لك يا عزيزي اليوم، التحكم في المشاعر هو أسمى صفة يمكن أن تمتلكها. فإذا أمسكت بزمام غضبك، صفا بصرك الداخلي، واتسعت آفاق حكمتك، وصرت ترى المواقف بوضوح لا تحجبه سحابة الانفعال. فالغضب لا يقود إلا إلى العمى عن الصواب، بينما الوعي بالذات هو المفتاح الأثمن الذي تحتاجه في هذا الزمن المزدحم بالصراعات والتوترات.
انظر اليوم إلى رياضات القتال الاحترافية، سواء الملاكمة أو حتى فنون القتال المختلطة الـUFC كما تُعرف اليوم، ستجد أن كثيراً من الأبطال يتعرضون لكم هائل من الشتائم والاستفزازات قبل النزال، ومع ذلك لا تهتز أعصابهم، بل يظلون ثابتين كالصخر. وإن تأملت أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، ستدرك أن مفتاح فوزه لم يكن في سرعة لكماته فحسب، بل في ثباته الانفعالي؛ فقد كان أحياناً يبتسم أو يضحك وهو يقاتل، لأنه لا يترك للغضب موطئ قدم في قلبه أو عقله.
والأهم من ذلك، انظر إلى قدوتنا العظمى ﷺ، الذي خاض معارك وغزوات لإعلاء كلمة الحق، ومع ذلك، وبالرغم من إباحة القتال في تلك المواقف، لم يَقتل بيده طوال حياته إلا رجلاً واحداً، وهو أُبيّ بن خلف، وكان ذلك في ساحة المعركة. ومع كل ذلك، كان أرحم الناس، حتى قال ﷺ : "إنما يرحم الله من عباده الرحماء"، فجمع بين القوة الكاملة والرحمة المطلقة، وبين القدرة على الرد والاختيار للعفو. وهنا تدرك أن العظمة ليست في أن تكون قادراً على سحق خصمك، بل في أن تمتلك القدرة على ذلك وتختار ألا تفعل، لأنك تعلم أن القوة الحقيقية هي أن تكون سيد نفسك قبل أن تكون سيداً على غيرك، وأن خصمك الوحيد هو نفسك فقط.
وعندما نصل إلى الركن الثاني من أركان الذكاء العاطفي، وهو فهم الآخرين، قد يتبادر إلى ذهنك سؤالان في غاية الأهمية:
الأول: كيف نمتلك القدرة الحقيقية على فهم الآخرين؟
والثاني: ما الفرق بين هذا الفهم وبين سوء الظن؟
ولعلّنا نبدأ أولًا بالإجابة عن سؤال: كيف تفهم الناس؟
في رأيي المتواضع، هذا الفهم لا يتأتّى إلا بكثرة الاحتكاك بمختلف الأشخاص، وأعني هنا اختلاف العقول، بل واختلاف الطبقات الاجتماعية أيضًا. فكلُّ شخصٍ تقابله سيترك فيك درسًا؛ فمنهم من سيخذلك، ومنهم من ستظنّ أنك تحبّه، ثم لا تلبث أن تكتشف العكس، ومنهم من سيذكّرك بأن الناس معادن، وأنه ليس كل من تأنس به أو ترتاح له يصلح أن تودعه قلبك أو تأمنه على عقلك.
وما جعلني أؤكد على ضرورة التعرّف إلى مختلف الطبقات الاجتماعية، هو أن الإنسان في طبيعته يجعل أكبر همّه ما لا يملكه. فالطبقة المتوسطة تطمح إلى الصعود، وتكافح لأجل ذلك، فتراها تخوض تجارب متنوّعة، بعضها محفوف بالمخاطر وبعضها مليء بالدروس، وهذا وحده كفيل بأن يمنحك صورة حيّة عن صبرهم وطموحهم وأخطائهم أيضًا. أما الطبقة الأدنى، فسترى أنهم ينشغلون غالبًا بعبور يومهم بسلام، غير آبهين بالغد بقدر ما يركّزون على قوت اليوم وأساسيات العيش ولا ضير في هذا ايضاً طالما أنهم سالمين. وهذا يمنحك درسًا في التلقائية والبساطة، وربما في التكيّف السريع مع الظروف الطارئة. وأما الطبقة العليا، فقد تكتشف أن كثيرًا من همومهم في نظر الطبقة الأدنى تافهة أو رفاهية بحتة، ومع ذلك قد تراهم أحيانًا يحسدون الطبقة الأدنى على لا مبالاتهم بالغد، أو على قدرتهم على الاستمتاع باللحظة دون عبء التخطيط المستمر. وبين هذه وتلك، تظل الطبقة المتوسطة تسعى للحاق بإحداهما، تميل تارةً إلى الأعلى بدافع الطموح، وأخرى إلى الأدنى بدافع الحنين أو الرغبة في التحرر من ضغط التوقعات.
وأنت ياعزيزي، إن كنت مراقبًا دقيقًا، ستشهد هذا كله في حياتك اليومية، وربما في أسبوع أو شهر واحد، لتجد نفسك تكتسب من كل طبقة مهارة مختلفة من الأدنى فنّ التكيّف، ومن المتوسطة روح السعي، ومن العليا نظرة استراتيجية حتى وإن شابها الترف. وهذه المهارات حين تجتمع، تمنحك قدرة أعمق على فهم الناس على اختلاف بيئاتهم ودوافعهم.
ومع مرورك بمزيد من التجارب، ستتعلم أكثر، وتفهم أكثر، بطريقة تلقائية وطبيعية. وهنا نأتي إلى الأمر الثاني، وهو ثمرة لما سبق أن تحدّثنا عنه وهو مراجعة النفس. فمراجعة النفس أشبه بإمساك مرآة صافية ترى من خلالها أفعالك وأفعال الآخرين بوضوح؛ فتتأمل ردود أفعالك أمام تصرفاتهم، لكن هذه المرة بعيدًا عن غشاوة العاطفة أو ضباب الانفعال. حينها ستقف على حقيقتهم، كما ستقف على حقيقة نفسك في التعامل معهم.
وأمر آخر لا يقل أهمية هو أن تضع نفسك مكانهم. اسأل نفسك دائمًا "لو كنت مكانه، ماذا كنت سأقول أو سأفعل؟" فهذه المحاولة تمنحك زاوية نظر جديدة، وتساعدك على إدراك ما يدور في دواخلهم، أو على الأقل تفهّم دوافعهم. مع كل ذلك، يبقى عليك أن تبحر في فهم النفس البشرية، فهي بحر عميق مليء بالأسرار، لا يكفي فيه مجرد الملاحظة أو التجربة، بل يحتاج إلى وعي متراكم لسنين، وقراءة متأنية لطبيعة الإنسان، وإدراك أن ما تراه ظاهرًا قد يخفي وراءه عالَمًا كاملًا من الأفكار والمخاوف والرغبات.
أما عن السؤال الثاني، فهناك فارق الجوهري بين فهم الآخرين وسوء الظن بالناس وهو أمر مذموم، بينهما أن فهم الآخرين يعني قراءة الموقف بعين واعية وقلب منفتح، مع محاولة إدراك دوافعهم ومشاعرهم وظروفهم، دون أن تُصدر حكماً مُسبقاً أو تُحمّل النيات ما لم تُصرّح به الأفعال. أما سوء الظن، فهو أن تضع افتراضات سلبية من البداية، وأن تفسّر تصرفات الناس بناءً على أسوأ الاحتمالات، حتى قبل أن تتحقق أو تتأكد. وأيضاً فهم الآخرين يحتاج منك إلى مزيج من التعاطف والانتباه والإنصاف، بينما سوء الظن لا يحتاج إلا إلى عجلة في الحكم وقلة صبر. فالأول يقودك إلى بناء الجسور، والثاني يهدمها قبل حتى أن تكتمل.
واسمح لي يا عزيزي أن أروي لك قصة تحمل في جوفها درسًا بليغًا في ثلاثة أمور، حسن الظن، والذكاء العاطفي والفطنة، ومعنى الصداقة الحقيقية.
كان في سالف الزمان شابٌّ عظيم الثراء، ورث عن أبيه تجارة الجواهر والياقوت، والتجارة تلزمها مكسب وخسارة، وكان شديد الكرم مع أصدقائه، يفضّلهم على نفسه، فيجلّونه ويحترمونه أيما احترام. ودارت الأيام، فمات والده وافتقرت العائلة افتقارًا شديدًا. أخذ الشاب يبحث عن صديقه المقرب له وكان صديقه هذا ثرياً من أصحاب القصور والأموال. فقرر أن يقصد داره رجاء أن يجد عنده عملًا أو عونًا من المال. فلما بلغ القصر، أخبر الخدم بصلته بصاحب الدار وما كان بينهما، فنقلوا الخبر إلى سيدهم، فنظر من خلف الستار، فرأى صديقه بثياب رثّة وعلامات الفقر بادية عليه، فأعرض عن لقائه، وأمر أن يُقال له: "صاحب الدار لا يمكنه استقبال أحد". فانصرف الشاب مكسور الخاطر، متألمًا من موت الصداقة وغياب الوفاء.
لم يبتعد كثيرًا عن القصر حتى التقى ثلاثة رجال بدت عليهم الحيرة، فسألهم عن شأنهم، فقالوا: "نبحث عن رجل اسمه فلان بن فلان"، فذكروا اسم والده. أجابهم: "هو أبي، لكنه توفي منذ زمن". تأسفوا وذكروا محاسنه، ثم قالوا: "كان والدك يتاجر بالجواهر، وقد ترك عندنا أمانة"، وأخرجوا كيسًا كبيرًا مملوءًا بالمرجان النفيس، ودفعوه إليه. تعجب الشاب، لكنه تساءل: "من يشتري المرجان هنا؟ فالبلدة خالية من الأثرياء". واصل طريقه، حتى لقي امرأة مسنّة تبدو عليها النعمة، فسألته عن أماكن بيع المجوهرات في البلدة. قال: "وأي نوع تبحثين؟" فأجابت: "أريد أحجارًا كريمة مهما كان ثمنها". عرض عليها المرجان، فانبهرَت بجماله، فاشترت منه قطعًا وأعطته مالاً وفيراً مقابلها، ووعدت بالعودة لشراء المزيد. ومن هنا عادت تجارته إلى النشاط، وعاد اليسر بعد العسر.
عندها تذكر صديقه القديم، فبعث إليه بيتين من الشعر مع رسول فكتب فيها معاتباً صديقه:
صحبتُ قومًا لِئامًا لا وفاءَ لهم يدّعون بين الورى بالمكر والحيل
كانوا يجلّونني مذ كنتُ ربَّ غِنى وحين أفلستُ عدّوني من الجهل
فلما قرأها الصديق، كتب ردًا بثلاثة أبيات، وأرسلها إليه:
أما الثلاثة قد وافوك من قِبَلي ولم تكن سببًا إلا من الحِيل
أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي
وما طردناك من بُخلٍ ومن قِلَلٍ لكن عليك خشينا وقفة الخجل.
وهذه القصة تعلمنا أن الفطنة تعني أن تمتلك عينًا تلتقط التفاصيل منذ اللحظة الأولى، وقلبًا يستوعب الإشارات الخفية، ثم تبني على ذلك القرار الأصح بدلاً من الصحيح. أليس صديقه كان قادرًا، وهو يراه واقفًا على عتبة بابه، أن يعطيه ما يسد حاجته في الحال؟ وهذا هو الفعل الصحيح، بلى، ولكنه اختار طريقًا أصح وأذكى عاطفياً وأحفظ لكرامة صديقه؛ طريقًا يجعل العون يصل إليه دون أن يشعر بثقل المنّة أو مرارة السؤال، فينعم بالعطاء ويظل مرفوع الرأس. فقد خشي أن يضعه في موقف حرج، ورأى أنه يستحق أكثر من مساعدة عابرة، بل يستحق أن تُنعش تجارته من جديد. ولأجل ذلك لم يمنّ عليه حتى بالعطاء، بل رتّب الأمر في صمت جلل، ليصل إليه الخير في صورة فرصة حقيقية تعيد له مكانته ورزقه. وهذا هو الذكاء العاطفي في أبهى صوره؛ إذ فهم صديقه، وفهم كرامته، وأدرك ما هو أنفع له، وما يسعده أكثر من المال المباشر، وفهم كذلك كيف يكسب قلبه ووده على نحو أعمق وأدوم.
والذكاء العاطفي في أساسه أصل الفراسة ولذلك، فالفرق بين الفراسة وسوء الظن، أن الفراسة هي أن تلتقط من أخيك إشارة واضحة أو علامة ظاهرة أو دليلًا جليًا، فتستنبط منه أمرًا في نفسك، لكنك تكتمه إن كان سوءًا، فلا تبوح به ولا تحكم عليه به، ولا تجزم بما توسمته حتى لا تقع في الإثم. أما سوء الظن فهو أن تظن بأخيك شرًا بلا دليل، أو بدافع حقد أو نية سيئة في قلبك، أو من فساد حالك أنت، فتسقط عيوبك على غيرك وتقيسه بنفسك، فذلك هو عين الإثم والظلم. وهنا يظهر أن الفراسة مبناها على صفاء القلب وحسن النية، أما سوء الظن فمبناه على تعكير القلب وتشويه النية. الفراسة تُبقي باب الخير مفتوحًا، بينما سوء الظن يغلقه ويزرع العداوة في النفوس.
ختامًا يا عزيزي، حَكِّمْ عقلك، واكبح جماح غضبك، وامسك لسانك، وازرع في قلبك إيمانًا راسخًا، و نمِ ذكاءك العاطفي، فبهذه المبادئ تُبنى حياة متزنة تنعم فيها بالسلام مع نفسك والآخرين.
بحمد الله وتوفيقه وبفضل الله ثم إقتراحاتكم، تم افتتاح قناتنا على منصة يوتيوب، وقريبًا بإذن الله سيتم نشر أول مقطع فيديو. وإن كنت من المهتمين بهذا النوع من المحتوى، فستجد هناك طرحًا أكبر ونقاشات مستفيضة حول القضايا ذاتها التي نشاركها هنا، لكن بصيغة مرئية ومباشرة تفتح الباب للحوار والتفاعل بشكل أوسع. وفي المستقبل ربما نتوسع لنتحدث عن الكتب والتحليل وربما حتى اللغات.
رابط القناة ستجدونه مرفقًا هنا، كما يمكنكم الوصول إليه من الصفحة الرئيسية في قسم الروابط. نتطلّع إلى لقائكم هناك، وإلى تفاعلكم الذي يُثري، ويساعدنا على التطوير المستمر. كما يسعدني أن أفتح باب المشاركة أمامكم؛ فإن كان هناك موضوعٌ معين ترغبون في رؤيته مطروحًا إما في مقال مكتوب أو على هيئة مقطع فيديو، فلا تترددوا في مشاركتي آراءكم واقتراحاتكم بكل أريحية. كما يمكنك التعليق أسفل القناة بما تحب.



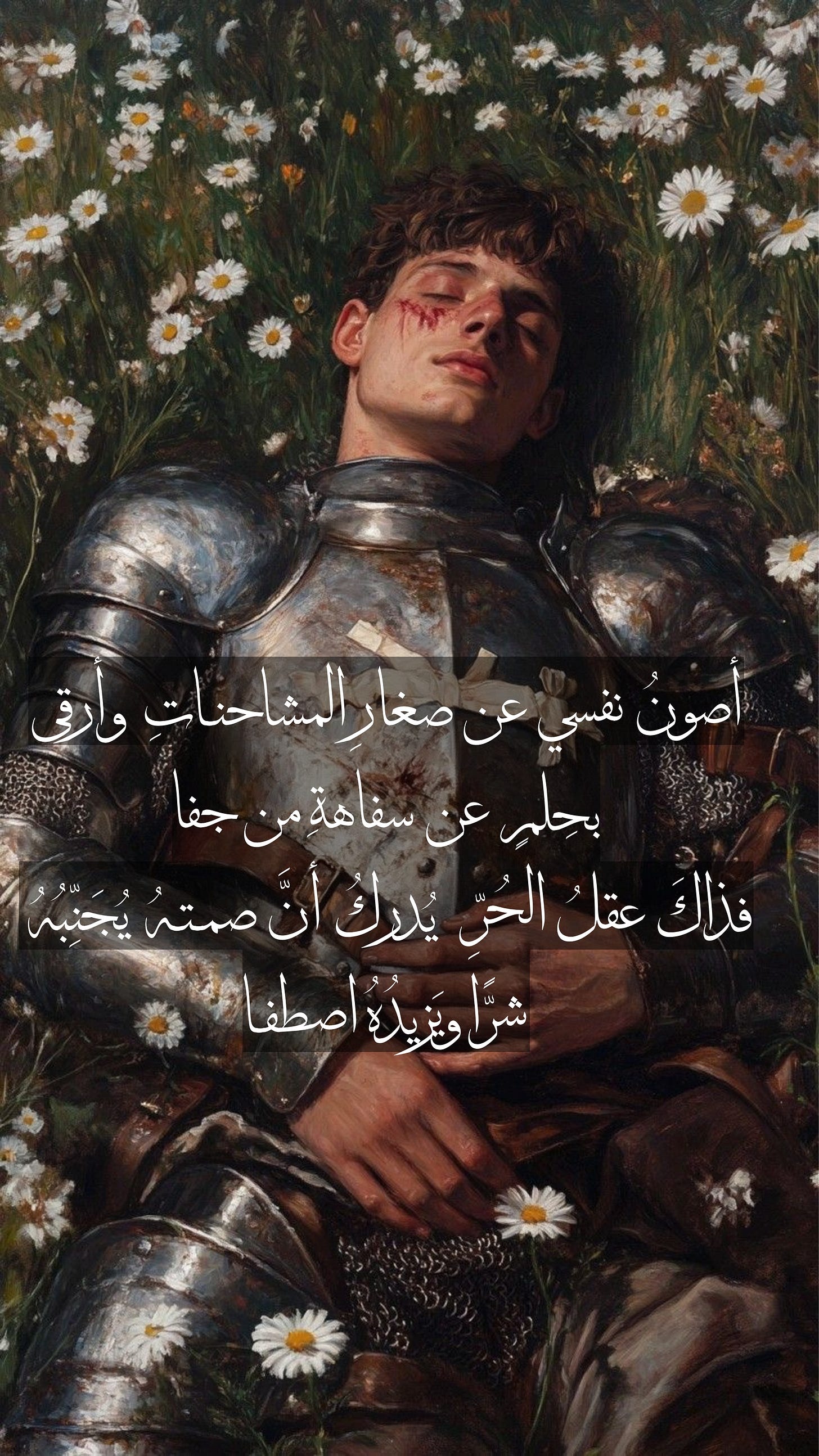
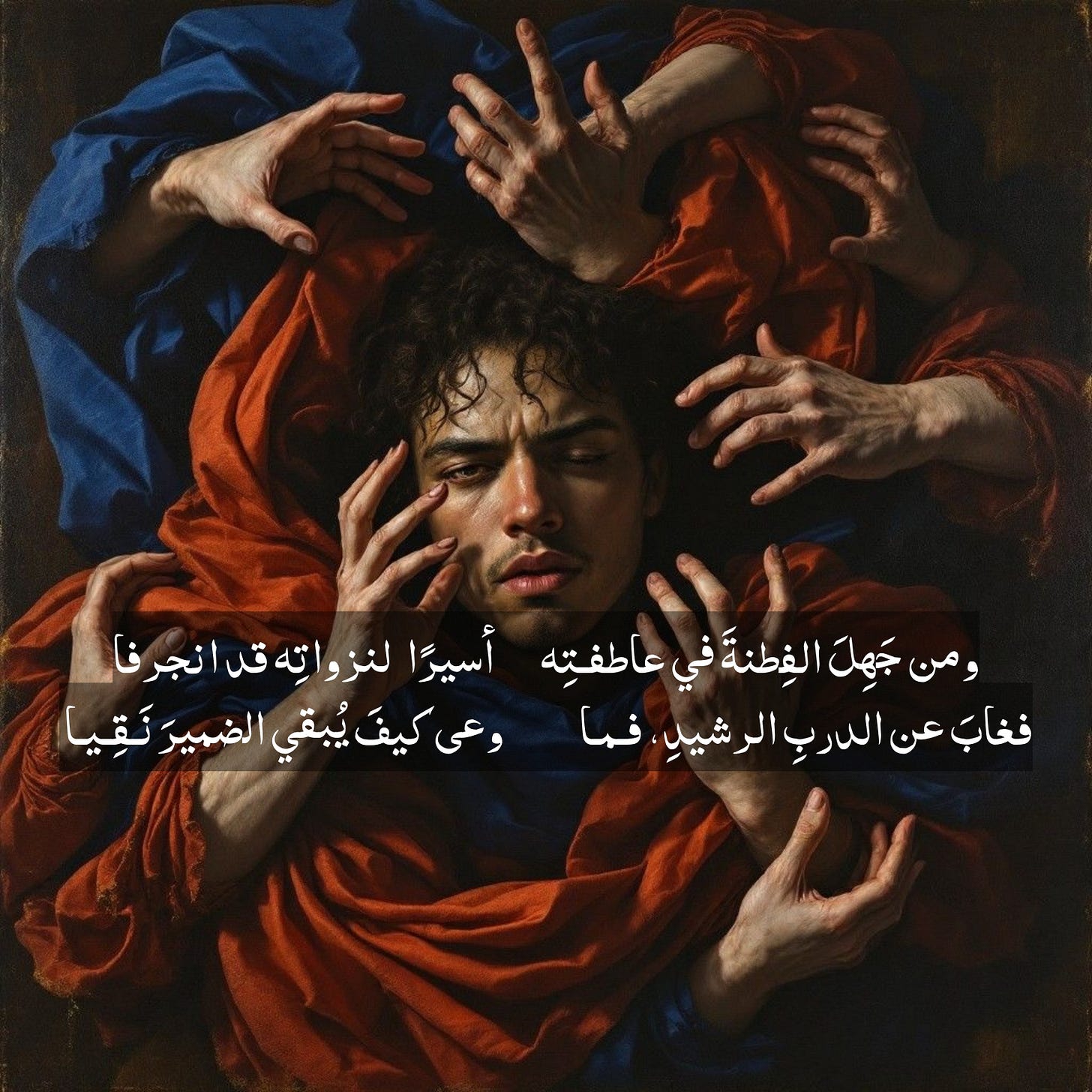
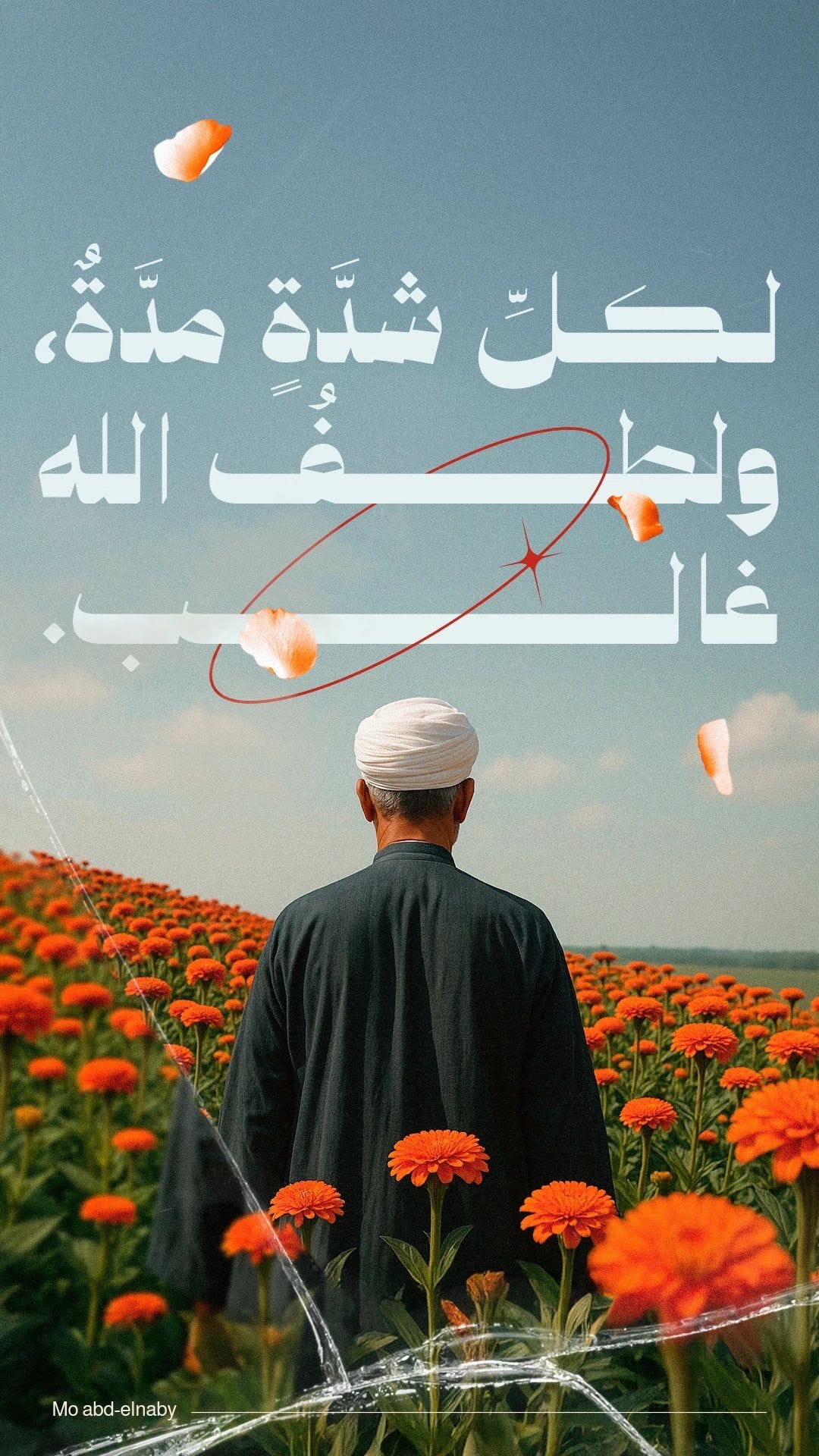
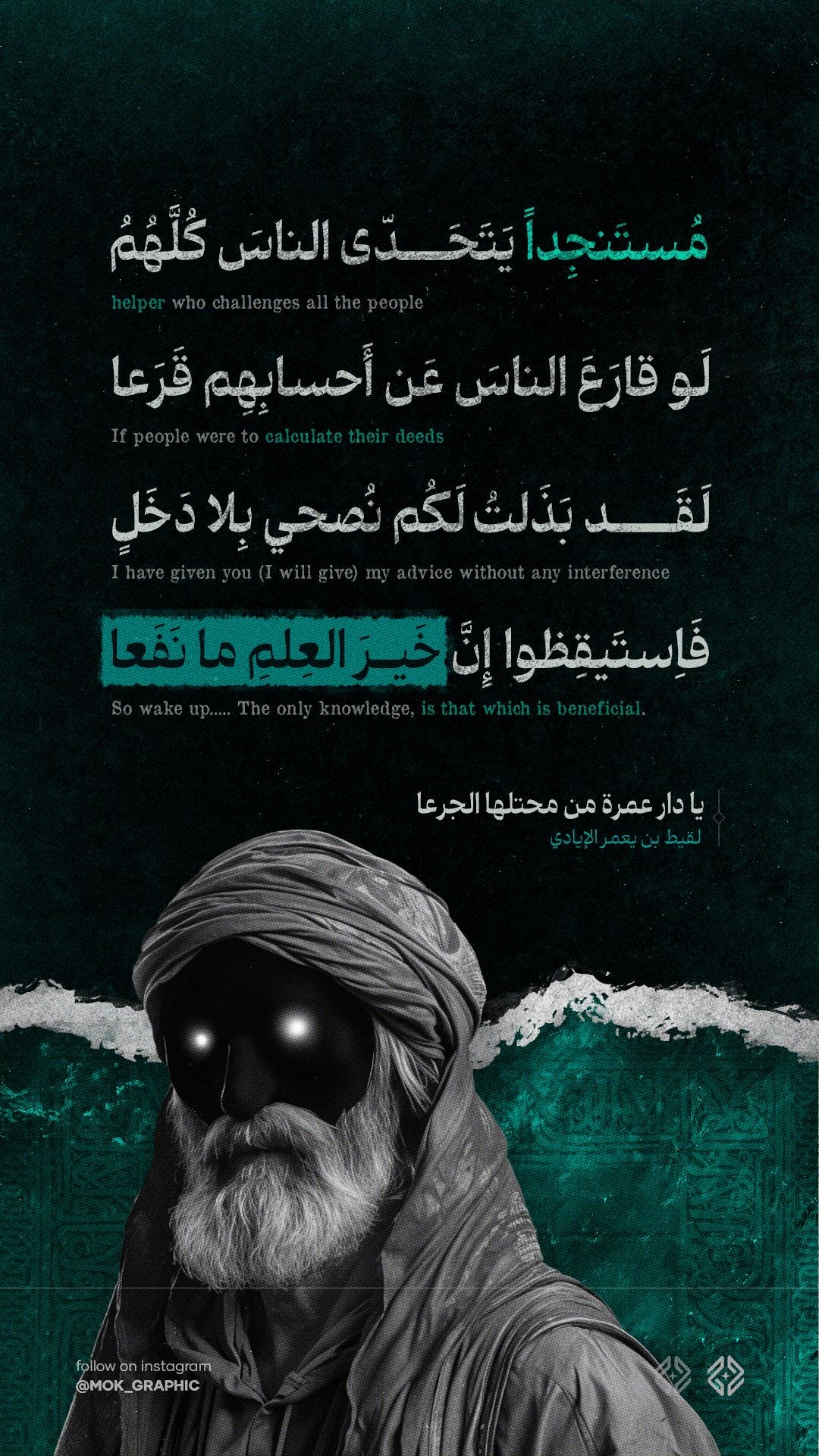
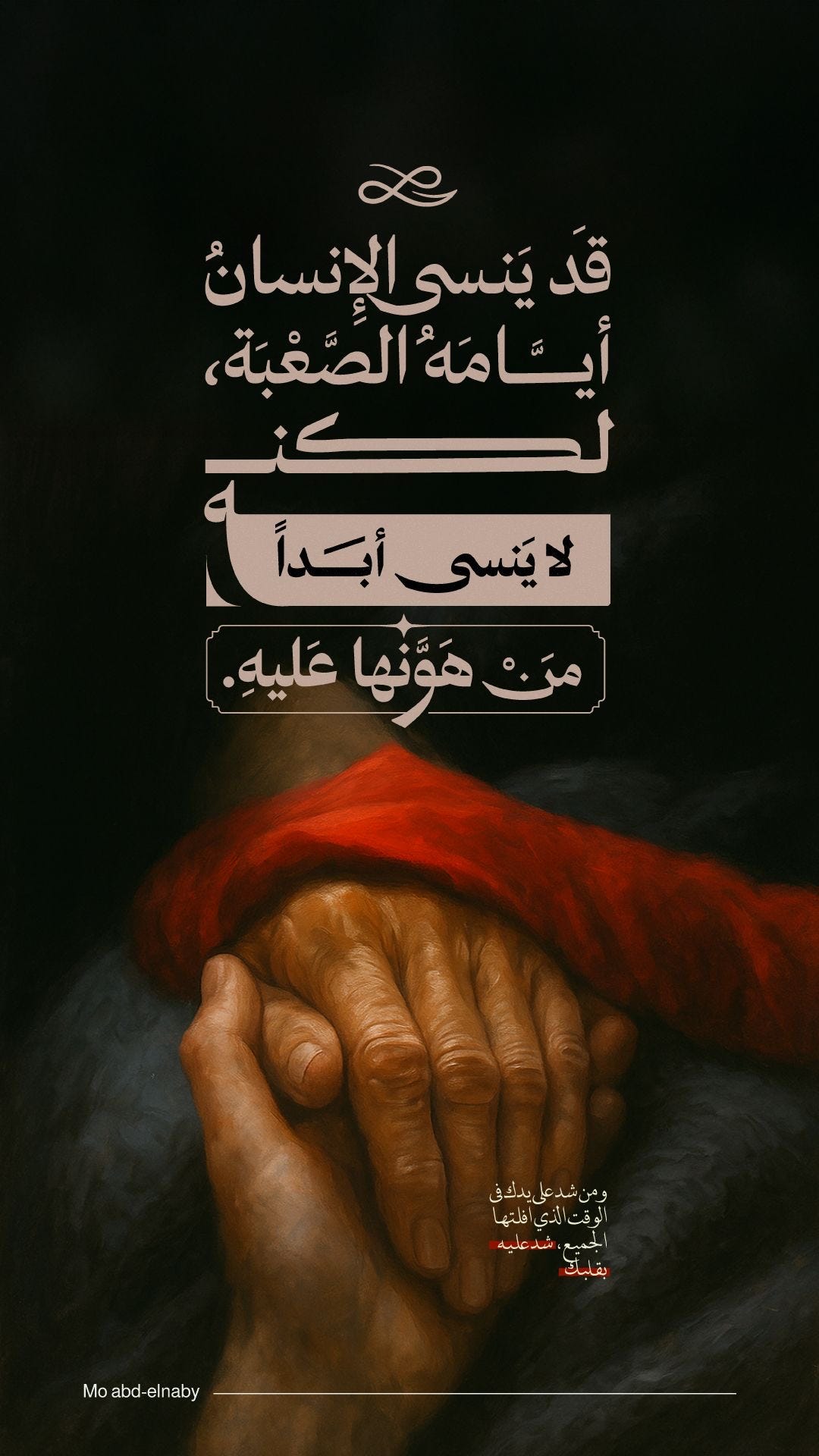


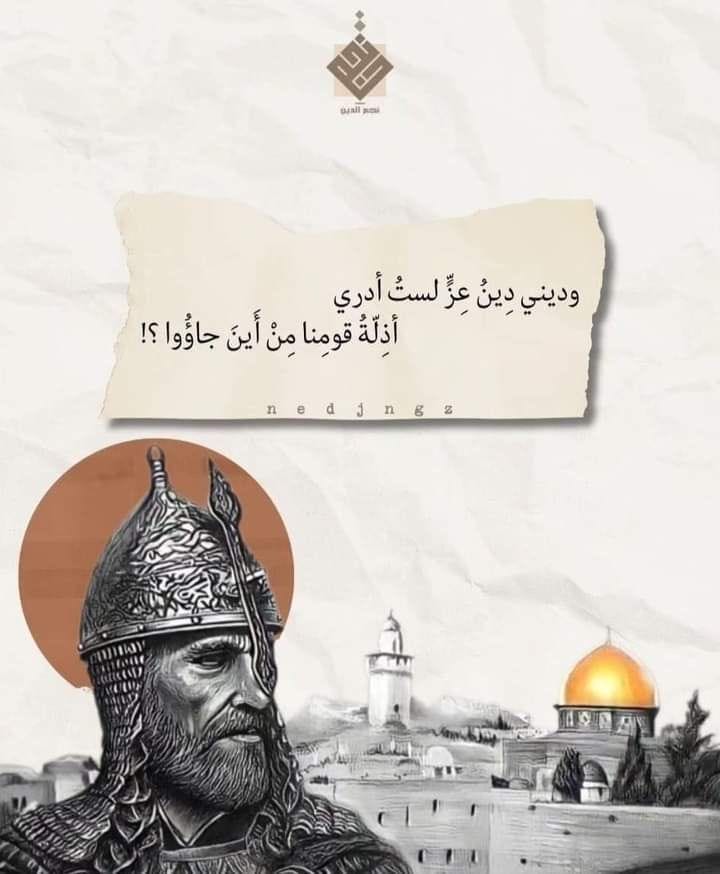

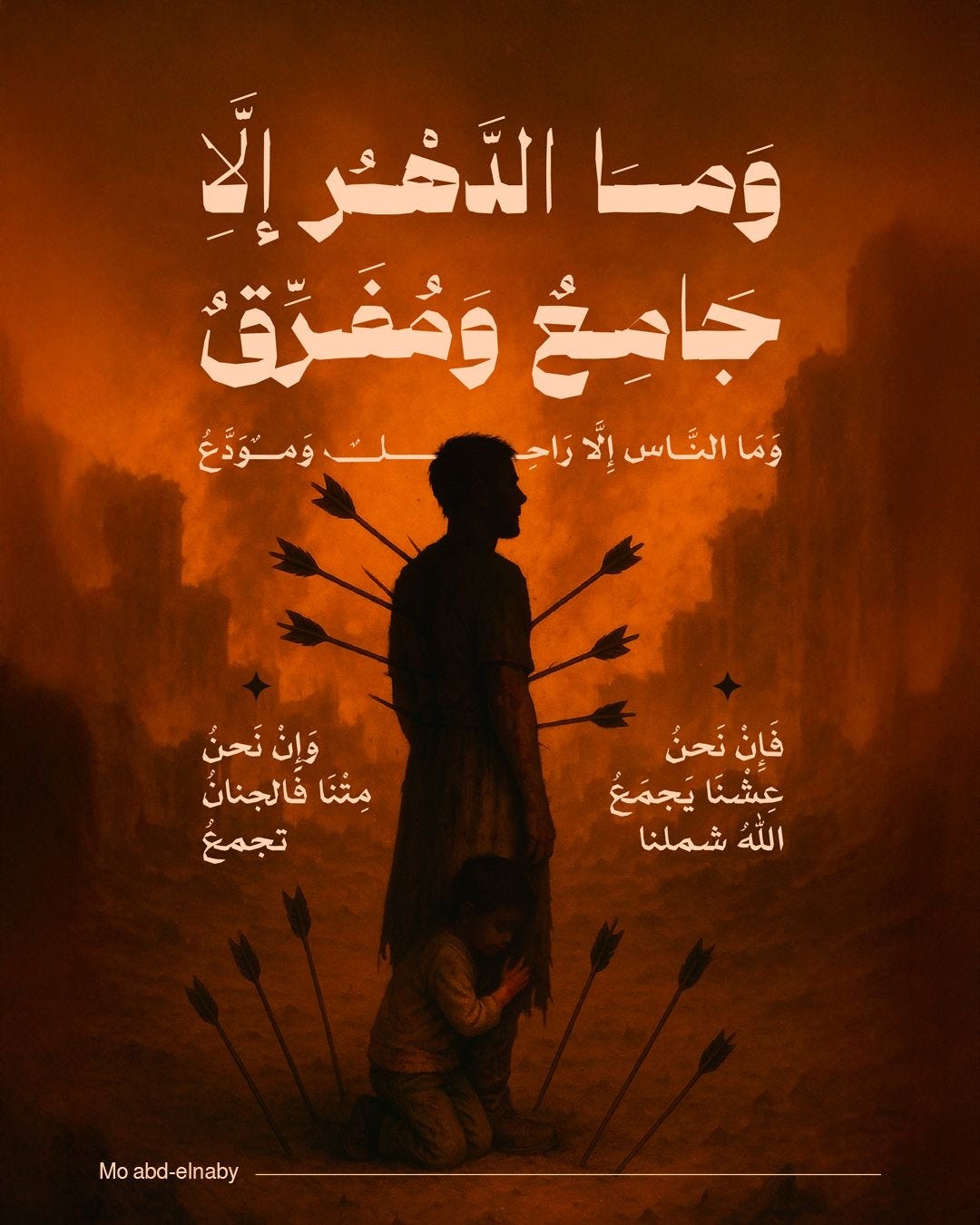
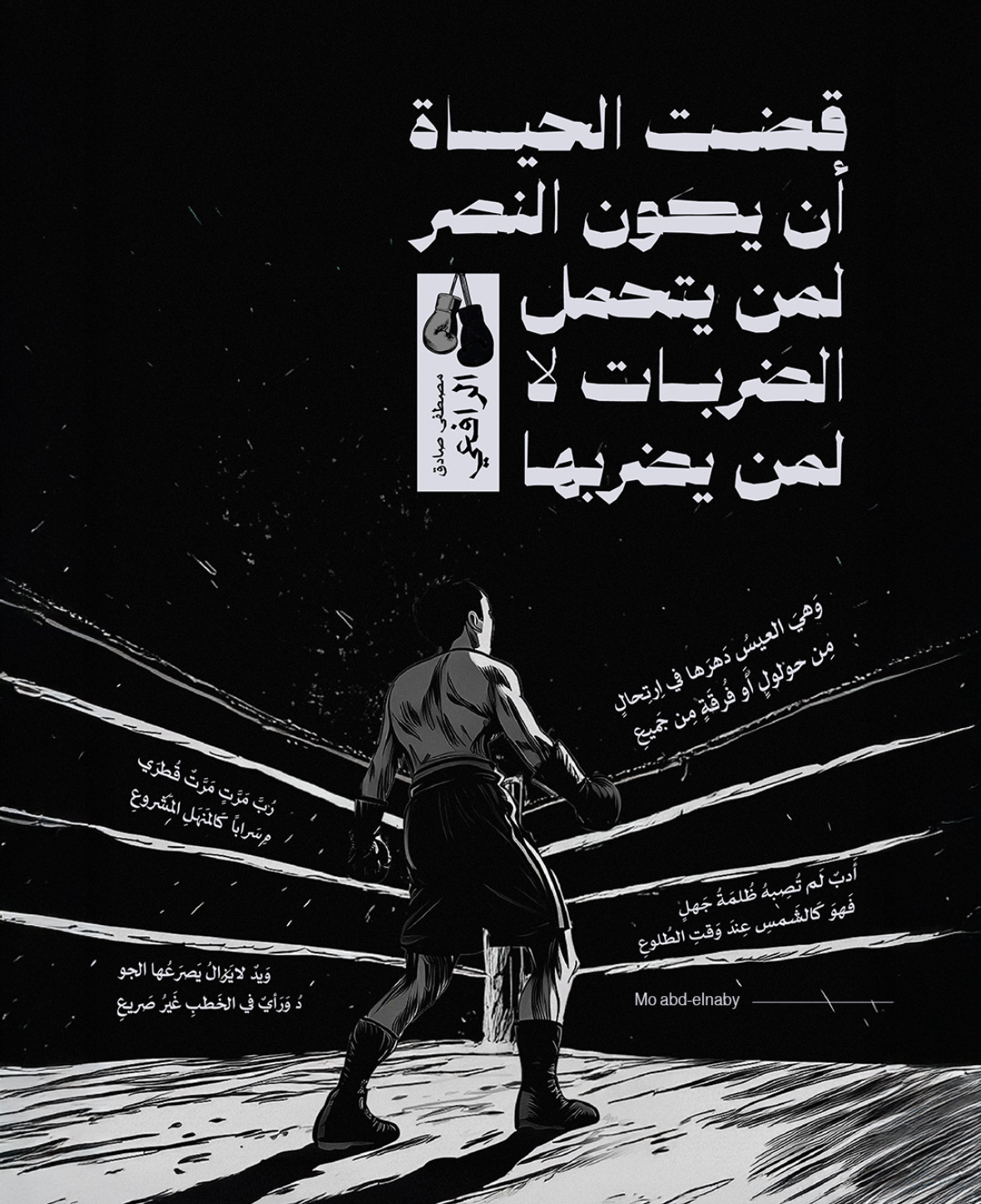
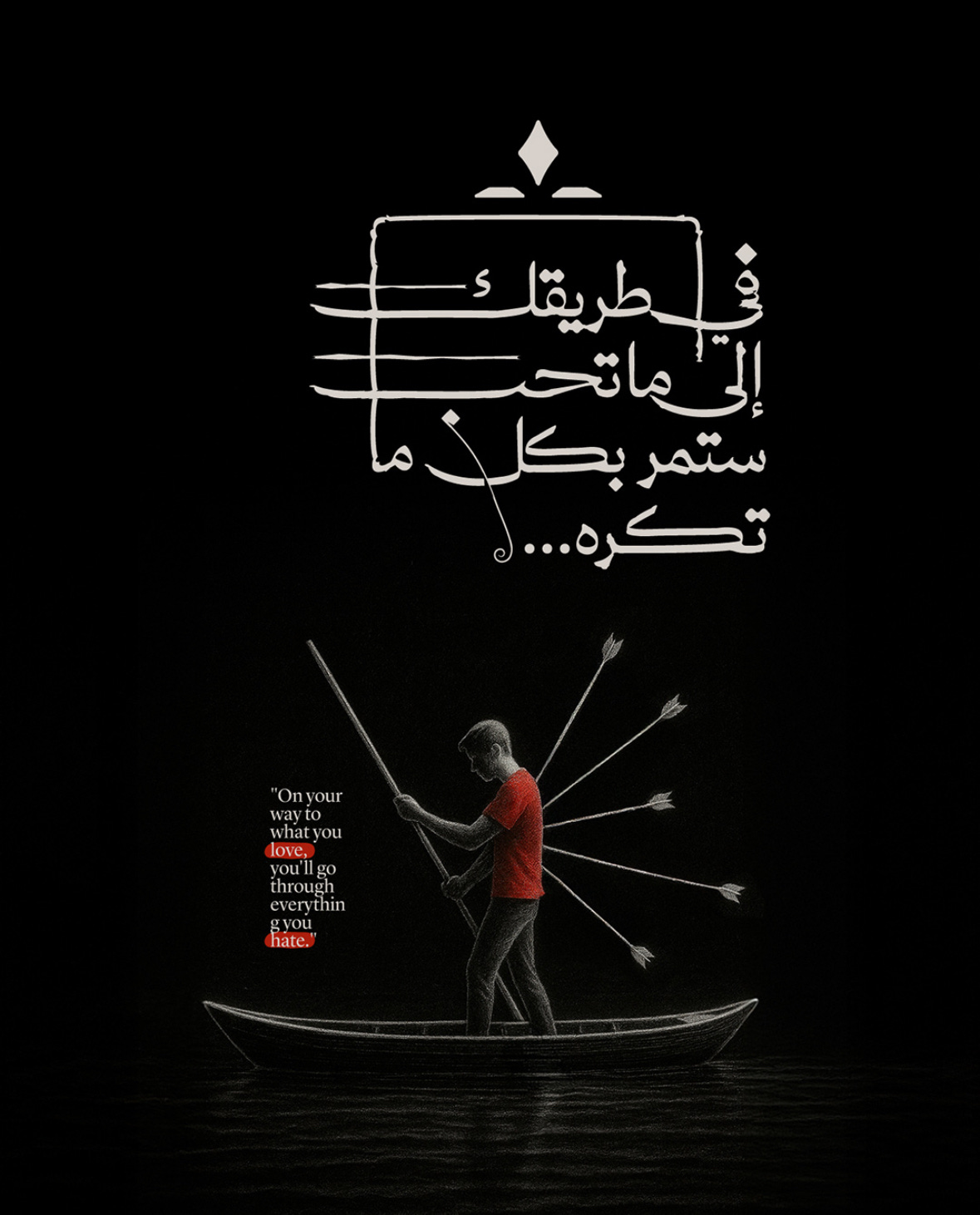

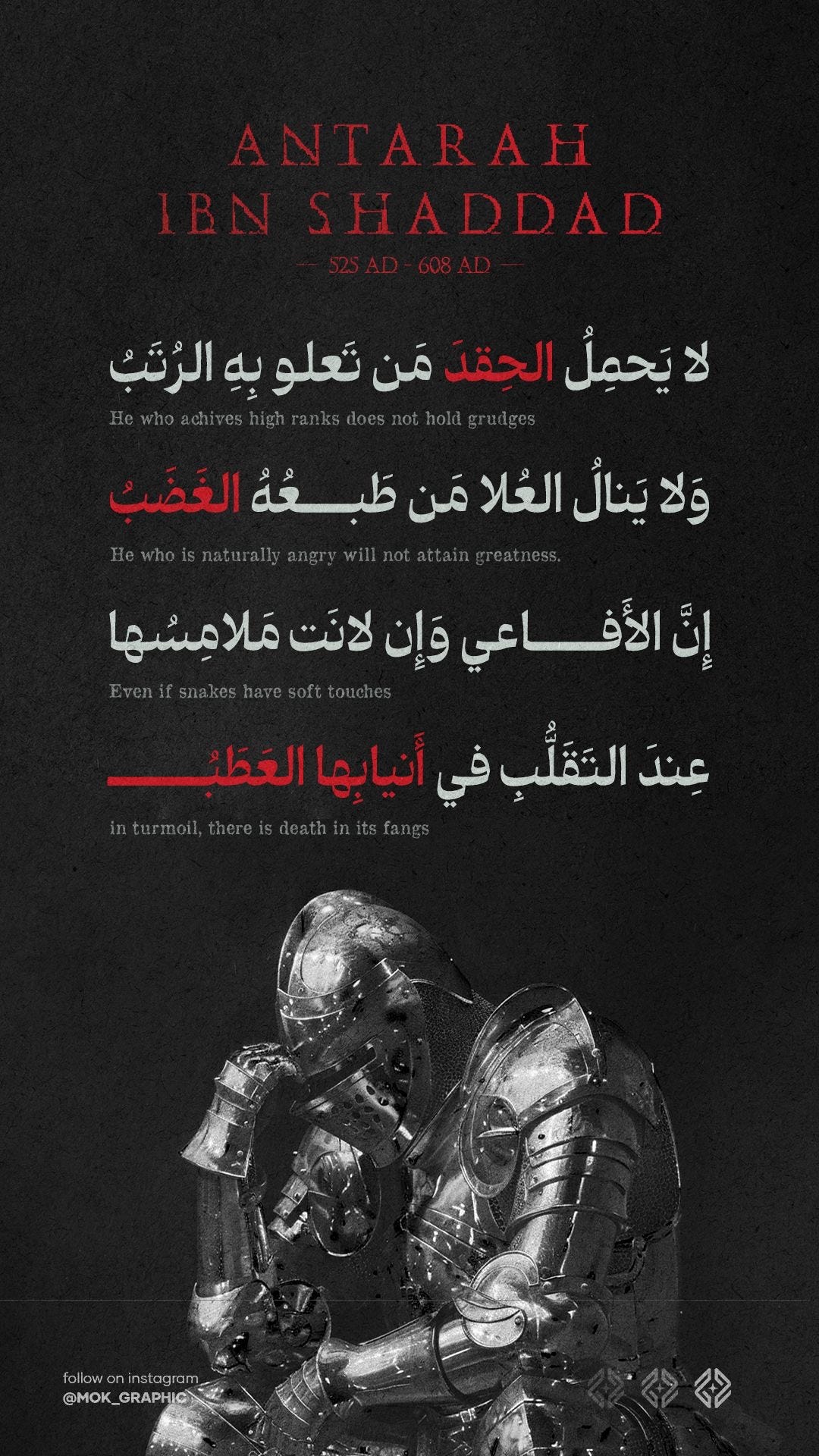
جزيت خيرا يا اخي وابدعت، انه موضوع وان كان كما قلت يزيد فيه الحديث الا ان امثلته في الواقع تكاد تكون معدومة.
تعليقًا على جزء ان الذكاء العاطفي لا ينفصل عن الدين فقد رأيت منذ فترة اثناء قرأتي عن الادارة تأثير يسمى "تأثير بين فرينكلن"
(Ben Franklin Effect"
وهو بالفعل تطبيقًا حقيقيًا يستخدم في الغرب لهذه الاية:
"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"
يقول فرنكلن انه اذا كان هناك صديق عمل وكان فظًا معك او تشعر انه لا يحبك ودائما العلاقة بينكما غير لطيفة، فاذهب واطلب منه ان يسدي لك معروفًا او خدمة حتى وان كنت قادرا على ان تفعله بنفسك، فذلك سوف يحسن علاقتك معه واذا كان هناك بغضاء بينكما سوف تزول.
لا اعلم ان كان هذا التفسير صحيحا ولكن هذا ما وقع في قلبي حينما قرأت هذا التأثير.
مقالك بالصدفة طلعلي وما أجملها من صدفة! مقال مش بس بحكي عن الذكاء العاطفي ، لأ هو مكتوب بالذكاء العاطفي!!!
.مكتوب بطريقة ما بتحكم على الإنسان مهما كانت شخصيته
أدركت الكم الهائل من الأهمية لكوني شخص ذكي عاطفي وليس عقلياً.
شكراً على المقال والإضافة الجميلة للعقول 🌸🤍