كََيْفَ نُُصّبِحُ مُثَقَفِينْ
من التشتت إلى الثقافة: سلسلة متكاملة لاستعادة التركيز، فهم الوقت، وبناء الذات المثقفة (مقدمة)
في زمننا الحاضر، يكاد التشوّش والتشتت يصبحان سمة عامة. وبالتشتّت أعني ذلك التبعثر الذهني الذي يطال كافة جوانب الحياة، من أبسطها إلى أعقدها. من ذلك الشرود الذي يرافقنا في محادثاتنا اليومية، حين نُوصَف بعدم التركيز، أو قلة الانتباه، أو بطء الاستيعاب، إلى ذلك التشتّت المعرفي العميق الذي يدفع الفرد لأن يركض خلف عدّة مجالات في وقتٍ واحد، دون أن يُمسك بخيطٍ ناظم بينها. يصبح الذهن ليس إلا مرآة مشروخة، تعكس كل شيء لكنها لا تُبقي صورةً واحدة متماسكة حتى. يريد المرء أن يتعلم كل شيء، أن يفهم كل شيء، أن يكون جزءًا من كل الحوارات والمعارف، لكنه في النهاية لا يُتقن شيئًا واحداً على وجه التحديد.
وهنا زمام الأزمة، يتحول حب التعلُّم إلى فوضى معرفية، و يُصبح العقل ساحةً تتقاطع فيها الرغبات دون هُدى، ومن ثم تأتي النتيجة الطبيعية وهي عدم التركيز بين الإغراءات الكثيرة لما يمكن معرفته، ولا لما لما يجب أن يُعرف. لذلك، التشتّت ليس كما يظن البعض أنه فقط غياب التركيز، بل هو أقرب مايكون لانسلاخ تدريجي عن عمق التجربة، عن التخصّص، عن البقاء في اللحظة. وهو، إن لم يُضبط، يُحوّل العقل من بوصلة إلى دوّامة تسحب معه كل شيء. كأن عقولنا مبعثرة في زوايا متباعدة من الحياة، كأنها قطعُ زجاج مكسور لا يجمعها إطار. نُجالس الواقع بأجساد حاضرة، لكن عقولنا تسرح في متاهات لا مرئية، في عوالم اخرى، نركض وراء المهام، نُطارد المواعيد، نلهث في سباقٍ لا نُدرك وجهته في الأساس، وكلما اقتربنا من هدفٍ ما، شعرنا أننا ابتعدنا عن أنفسنا أكثر وابتعدنا عن اهدافنا الحقيقية التي ينبغي التركيز عليها، وكأن الاقتراب من الخارج يعني افتقاد الداخل.
يشبه الأمر أن تُلقي بنفسك من مكان شاهق، لا تسقط ولا تطير، فقط تظلّ معلّقًا بين السماء والأرض، في فراغٍ لا قرار فيه، لا صدمة توقظك ولا رفعة تُذهلك، مجرد وجودٍ صامت بنصف عقل، لا تحرّكه مشاعر ولا تضيئه رغبة. تتأرجح بين نقيضين، لا أنت في الحزن ولا في الفرح، بل في منطقة رمادية تُنكر التصنيف، وتُبقيك معلقًا في اللاانتماء. ربما بات هذا الأمر من سمات عصرنا الراهن وهو إن دل على شيء يدل على التشتت الوجودي الذي يدفع الإنسان للسعي خلف كل شيء في آنٍ واحد. فتراه يتنقّل بين الاهتمامات والمهارات كمن يطارد أطيافًا لا تثبت. فإن أتقن لغةً ما، سرعان ما يرغب في تعلّم أخرى، لا لحاجة ماسة أو هدفٍ واضح، بل فقط لأنه صادف فيلمًا بلغةٍ جديدة مثلاً فأعجبه، فخيّل إليه أن ثقافة هذا الشعب كلّها قد تجلّت في ساعة ونصف من السينما! وهكذا، يتوهم أن الإعجاب بلقطة أو نغمة أو مشهد كافٍ لأن يجعل من الثقافة وجبةً سريعة تُستهلك وتُنسى.
والحقيقة ياعزيزي أنك إن تأمّلت قليلاً في وجوه الناس، ستلمح شيئًا مشتركًا بينهم: التشوّش. الكثيرون يعيشون في حالة تشتّت دائم، لا في مهمة واحدة أو مجال بعينه، بل في كل شيء تقريبًا. يتنقّلون بين المهام، يفتحون أبوابًا لا تُغلق، يدرسون هذا ويقرأون ذاك، يبدؤون مشروعًا قبل أن يفهموا سابقه، يتعلّمون ألف شيء دون أن يتقنوا واحدًا. تجدهم في العشرينات أو أوائل الثلاثينات، يريدون أن يملكوا كل ما يملكه من هم في الأربعين والخمسين: ثروة، عِلم، خبرة، علاقات، سفر، زواج، وأطفال. يريدون أن يُنقّبوا عن المال من كل مصدر، أن يعملوا ليلًا ونهارًا بلا توقّف، أن يسافروا، ويُحبّوا، ويُحبّوا بالمقابل، أن يُكوّنوا صداقات لا تُعدّ، أن يتزوّجوا ويبنوا بيوتًا وذكريات، أن يملؤوا الحياة بكاملها دفعة واحدة.
وكل ذلك ليس خطأً بحد ذاته، فالطموح حقّ، والتوسّع ليس عيبًا. لكن المعضلة تبدأ حين يريد الإنسان كل شيء، الآن، دفعة واحدة، دون نضج كافٍ، دون ترتيب للأولويات، ودون لحظة توقف ليسأل: "هل أنا أسير فعلاً نحو ما أريد؟ أم أنني أركض لأن الجميع يركض؟" بل السؤال الأصح هو “ هل أنا أركض وراء ما أريده أنا حقاً، ام خلف مايركض الجميع وراءه ؟ وهكذا، ينتهي به الأمر مثل طفل يحاول حمل كل الألعاب في السوق، فيفقدها جميعًا. لا هو استمتع بها، ولا هو امتلك شيئًا منها حقًا. لذلك ياعزيزي أكررها لك، التشتّت لا يُنجز، بل يُفرّغ. لا يُقرّب، بل يُبعِد. والسؤال الذي يجب أن يُطرَح: هل ضياعك من كثرة ما تريد؟ أم من أنك لا تعرف ماذا تريد من الأساس؟
ولعلّ هذا التشتّت، يا عزيزي، ليس فوضى عابرة كما قد يبدو في ظاهره، بل هو تقاطعٌ دقيق بين مساراتٍ متنافرة في النفس الإنسانية، تتصادم حينًا وتتآزر أحيانًا، لكنها في النهاية قد تفضي إن أُحسن توجيهها إلى ارتقاءٍ حقيقي في وعي الإنسان وتكوينه. أعلم تماماً يا عزيزي أنك تشعر بثِقل هذا التشتّت، وأشعر بك كثيراً. أعرف جيدًا أنك ترغب في الإحاطة بكل شيء: أن تلمّ بالفنون، وتتعمق في الدين، وتغوص في اللغات، وتحيط علماً بالطب والصحة، وتتذوق الفلسفة وتنهل من الحكمة، أن تعرف عن الفضاء وتقنياته، عن التصميم والتصوير، فنون الطهي، وأن تتنقّل بين صفحات كتبٍ شتى، من علم النفس إلى روايات الخيال العلمي، من المتنبي إلى شكسبير.
ولكن، دعني أسألك السؤال الجوهري: أين أنت الآن من كل هذا؟ ولماذا، رغم كل هذا الشغف، لا تصيب منه إلا القليل؟ وهذا ما سنحاول أن نجد له مخرجاً في مقالانا هذا، سأحاول بتواضع المحب أن أضع بين يديك طرفًا من الإجابة كما أراها. وأذكرك ياعزيزي أن رغبتك مشروعة، بل نبيلة، ولكن الطريق إليها ليس مجرد تمني أو تجميع عشوائي للمعلومات. إنك، رغم تعدد اهتماماتك، لم تضع خارطة طريق حقيقية، ولم تُعالج بعد المشكلات التي تعيق تعلّمك. فإن أردت أن تتعلّم، فإن أول ما عليك فعله هو أن تطهّر عقلك من عدة سموم فكرية ونفسية، حتى تستعيد تلك الصفاء الذهني اللازم، وهو مايعد بمثابة تمهيد وتعبيد الطريق لإعادة ترتيب الداخل، وإعادة تموضع نفسك في الحياة كباحثٍ عن المعنى، كطالبٍ للمعرفة عن وعيٍ بدلاً من أن يكون عن تقليد أو ركض خلف ماهو رائج.
هذا الصفاء او التطهير هو الشرط المبدئي لكل تحوّل حقيقي، لأن الذهن المُثقل لا يبني، والوعي المزدحم لا يفهم. ومتى ما أُزيلت العوائق وهدأ الضجيج الداخلي، تبدأ أولى ملامح التركيز في الظهور، ويصبح باستطاعتك أن تميّز بين ما تريده حقًا، وما تظنه رغبة لمجرد أنه دار حولك كثيرًا. عندها فقط، يصبح الطريق أوضح، والعقل أكثر قابلية للاستيعاب، والروح أكثر استعدادًا للسير.
أضع بين يديك يا عزيزي، هذا المقال وهو بمثابة تمهيد لسلسلة مقالات تحت عنوان "كيف"؛ سلسلة من المقالات التي نحاول فيها معًا تفكيك ذلك السؤال العميق الذي يُطرح في داخلك أكثر مما تبوح به شفتاك: لماذا لا أصبح ما أطمح إليه؟ لماذا، رغم هذا الشغف الكبير بالقراءة مثلاً، والبحث، والاطلاع، لا أشعر أنني أقترب من صورة الإنسان المثقف الذي أريد أن أكونه؟ في هذه السلسلة، لن نغرق في نصائح جاهزة، ولا وصفات سريعة، ولا معادلات رياضية تُقاس بها المعرفة. ما نريده أسمى من ذلك. نريد أن ننزل إلى الجذور. أن نسمّي العلل بأسمائها، ونُزيح الغطاء عن ما يعيق تشكّل الوعي في الإنسان.
سنتحدّث عن العوائق والمشاكل الحقيقية التي تعيق تشكُّل الوعي، ليست تلك التي نحبّ لومها دائمًا كضيق الوقت أو قلّة الموارد، بل ما هو أخطر مثل، التعقن الدماغي الذي يجعل العقل كسولًا في استقبال الجديد والكثير، والتشتّت المعرفي الذي يُغرق الإنسان في كل شيء ولا يُخرجه بأي شيء، ثم بطء الاستيعاب كنتاجٍ طبيعي لهذه الفوضى الداخلية التي خلفتها التعفن الدماغي والتشتت المعرفي، سنتحدث أيضاً عن غياب مفهوم الوقت الحقيقي، كما فهمه الإسلام والفطرة السليمة، لا كما أعادت تشكيله الحياة المعاصرة.
سنتحدث عن غياب الترتيب الصحيح لليوم، عن الفوضى في اليوم وفي العقل، عن انشغال الإنسان طوال الوقت دون أثر رغم ان لديه الفراغ الكثير، والانزلاق الأخطر وهو أن تعيش كنسخة، وتنسى أنك الأصل؛ أن تُبرمَج عقليًا على أن تكون فردًا من القطيع، تلبس ما يلبسون، وتفكر كما يفكرون، وتقرأ ما يُقال لك أن تقرأه كي تواكب حديث الجلسة والرفقة، لا ما يُحرّك فيك الأسئلة الحقيقية، وأخيراً الفراغ الذي يكاد أن يقتل الفرد رغم زعمه انه مشغولاً جداً. فراغ لا يملأه إنجاز، لأنه بلا وجهة، بلا بوصلة. لكي نصبح مثقفين فهذه مشاكل جذرية يجب ان تعالج، وهو ما سنخصص له مقال لكل مشكلة بإذن الله.
وإياك أن تظن ياعزيزي أن هذه مجرّد مشاكل عابرة، بل هي أعطاب عميقة، وطبقات متراكمة من الغبار على الروح والعقل. تمنع الرؤية، وتشوّش الفهم، وتُخرجك من كل تجربة معرفية فارغًا كما دخلت، وكأنك لم تقرأ شيئًا. ولهذا، ستكون هذه السلسلة محاولة لتفكيك هذه العلل واحدة تلو الأخرى، وسنخصّص لكل مشكلة مقالًا مستقلًا، نضع فيه الأصبع على موضع الألم، ونقترح بتواضع طريقًا للعلاج، وما هذه المقالات أن تكون من باب التوجيه من علوٍ، أو من ادّعاء منزلة المثقف أو الأستاذ، فما أنا بذلك، ولا أرى نفسي أهلاً له. إنما هي محاولة متواضعة من قلبٍ يسير على الطريق، ويحب أن يصحب معه من وجد في نفسه ذات الأسئلة، وذات العطش، وذات التيه، و لسنا هنا بوصفنا أساتذة نُقدّم دروسًا، بل بوصفنا رفقة في الطريق، نسأل، ونحاول أن نزيح عن العقل غبار العادة، ونوقظ في النفس ما خفت من نداء الفطرة.
فالغاية ليست أن نُعلِّم، بل أن نفهم، و لا أن نُوجِّه، بل أن نرافق. وكل ما أرجوه، أن تجد في هذه السطور ما يُنبّهك، لا ما يُملِي عليك؛ ما يُعينك على أن تكون، لا ما يحاول أن يُحدّد لك ما تكون. وإياك أن تظن يا عزيزي أن الغاية من هذه السلسلة أن تصبح "مثقفًا" فقط. لا، ما نسعى إليه أعمق من ذلك: أن تصبح طالب معرفة. طالباً حقيقياً للعلم، لأن المثقف قد يعرف الكثير، لكنه يركن إلى ما حصّله. أما طالب المعرفة، فلا يهدأ له بال، ولا يركن إلى اكتفاء، بل يسير، ويسأل، ويبحث، ويظلّ متواضعًا أمام كل باب جديد يطرقه. وهنا، في هذا التواضع، في هذا السعي المستمر، تكمن الإنسانية الحقيقية.
الكثير من الناس يا عزيزي في زماننا هذا يعانون من ما يمكن تسميته بـ"السموم العقلية"، وهي لا تأتي من فراغ، بل هي نتاج تراكمات يومية من عادات خاطئة في استخدام التقنية، وأساليب تلقّي سطحية، أصبحت بمرور الوقت جزءًا من نظام الدماغ نفسه. نعم، الدماغ نفسه بدأ يعتاد على نمط معين من الاستهلاك؛ نمط سهل، سريع، بلا صبر ولا انتظار، بلا عمق ولا هدف. واصبحت النتيجة ان الكثير يعانون من التشتّت الذهني. وليس المقصود بالتشتّت هنا مجرد "السرحان" أو الغياب اللحظي عن التركيز، بل المقصود به تآكل القدرة على الانتباه العميق او حتى الإنتباه الطبيعي، وافتقاد التركيز لفترة زمنية كافية تُمكِّنك من الفهم والاستيعاب.
وأوّل أسباب هذا التشتّت هو ما أسمّيه التعفّن الذهني أو "الركود العقلي"، وهو ما يحدث حين يعتاد الدماغ على استهلاك سريع ومكثّف لمحتوى سطحي، كما هو الحال في المقاطع القصيرة التي تُمطرنا بمتعة لحظية عابرة. هذه المقاطع تُعطي الدماغ جرعة عالية من التحفيز، لكنها في الوقت نفسه تعوّده على نمط استهلاك مضطرب، متقطّع، لا طاقة فيه على الصبر أو الاسترسال. وهنا تبدأ المشكلة. عندما تحاول مشاهدة فيديو تعليمي هادف، أو محاضرة تتجاوز الخمس دقائق، تشعر بثقلٍ في رأسك، ومللٍ يُثقل عينيك. وعندما تجلس لقراءة كتاب، تجد أن إنهاء صفحتين في جلسة واحدة يبدو وكأنه حملٌ ثقيل على عاتقك، رغم أنك قبل سنوات كنت تلتهم الفصول.
مع مرور الوقت ستجد ان هذه السموم لا تقتصر على المحتوى الرقمي وحده، بل إنّ الأمر يتجاوز التأثير على قدرتك المعرفية، ليصل ويا للأسى إلى عمق تواصلك الإنساني نفسه. لا بد أنك لاحظت، يا عزيزي، أن كثيرًا من المحادثات باتت جوفاء نوعاً ما، سطحية، وكأنها تتم بين ذهنيْن مشوّشين. تكلّم أحدهم لخمس دقائق فقط، ثم ترى عينيه تتيهان، وملامحه تتبدّل، وكأن ذهنه انسحب دون أي مقدمات. يبدأ استيعابه بالتآكل، واهتمامه بالتبخّر، وكأن قدرته على الإصغاء لم تعد تحتمل حتى جملةً واحدة مكتملة. هذا يا عزيزي ليس عيبًا في قدرته ولا في ذكائه، بل هو نتيجة تراكمات خاطئة وعادات مكتسبة للدماغ. والدماغ كأي عضلة: إن عوّدته على المشي لمسافات قصيرة فقط، لن يصبر على الركض. ولذلك، فإنّ أول خطوة في طريق التعلم الحقيقي ليست إضافة معلومات جديدة، بل إزالة العوائق القديمة أولاً. وإزالتها تبدأ في تقليل الاستهلاك السريع بالتدريج حتي تصل لقطعه من جذوره.
صدقني يا عزيزي، الاستهلاك السريع مهما بدا مغريًا في لحظته، مبهجًا في سطحه فإنه يُربّيك على شيء أخطر بكثير وهو النسيان السريع وهذا اكثر ما يواجهه الناس اليوم بعد التشتت الذهني. إنه يسلبك قدرتك على التذكّر، على التركيز، على الاستبقاء. يعوّد دماغك أن يأخذ بلا أن يحتفظ، أن يرى بلا أن يستوعب، ولكي لا تظن أن الأمر مبالغة، دعنا نجرّب تجربة بسيطة سوياً. افتح أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ذات المحتوى السريع، شاهد المقاطع القصيرة بنفس المدة التي تعوّدت عليها يوميًا. دقائق؟ نصف ساعة؟ ساعات؟ لا بأس، أكمل جلستك المعتادة.
ثم، بمجرد أن تنتهي وأعني فور الانتهاء، لا بعد خمس دقائق، اسأل نفسك سؤالًا واحدًا: هل أتذكّر مقطعين على الأقل ممّا شاهدت؟ هل أستطيع أن أستعيد محتوى مقطع واحد فقط بكامل تفاصيله؟ الغالب أنك ستُفاجأ بأن ذاكرتك قد محَت كل شيء تقريبًا، وكأنك لم تشاهد اي شيء، بل مرّرت فقط. وكأن دماغك لم يتلقَّ معلومة واحدة، هنا، يا عزيزي، تتّضح الحقيقة: ما تظنه "ترفيهًا بريئًا" هو في الواقع تدريب يومي على النسيان. تمرين على التفاهة السريعة، على التلقّي غير المفيد، على استهلاك لا يصنع عقلًا بل يطفئه، ومن ثم تُصبح عادة لدماغك. وهنا يبدأ الانحدار البطيء، لأنك سمحت ببرمجة دماغك على نمط لا يصلح للتعلّم، ولا للتثبّت، ولا للوعي.
فهل تملك الشجاعة لتكسر هذه الدائرة معي؟ هل تجرؤ أن تعيد لنفسك حق التركيز؟ أن تسترد من هذه المنصات عقلك ووعيك وذاكرتك؟ ذلك يا عزيزي هو أول الطريق نحو التعلّم الحقيقي التعلّم الذي لا يُمحى، التعلم الصحيح الذي يجعل منك إنساناً على فطرته قبل أن تصبح إنساناً مثقفاً. وإن كنت في داخلك تشعر أنك مختلف، أو حتى تنوي بصدق أن تسلك طريقًا مغايرًا لما عليه الأغلبية، فهذه يا عزيزي هي بدايتنا المشتركة. بدايةُ من قرر أن لا يُترك لتيار التشتت، أن لا يكون مجرد مستهلك آخر في طابور النسيان الطويل. نبدأ بخطوة بسيطة: نقلّل الاستهلاك السريع بالتدريج وهو فخ لهذا الوحش في الدماغ، حتى لا نُهذّب الوحش بل نقطع جذوره من الأساس.
نكسر الاعتياد، نقاوم الإغراء اللحظي، ونسترد زمام عقولنا. ومن هناك، شيئًا فشيئًا، سنستعيد قدرتنا على التركيز؛ ذاك الصفاء الذهني الذي كدنا ننسى شكله. بعد مرحلة التقليل، يا عزيزي، نأتي إلى الخطوة الأهم وهي الاستبدال. لا يكفي أن نُقصي الاستهلاك السريع، بل لا بد من زرع بديل صحي مكانه، بديل يُغذي لا يُرهق، يُثمر لا يُشتّت. وهنا، نُقدِم معًا على استبدال الاستهلاك السريع بـ الاستهلاك البطيء والواعي او المفيد وهو ذاك الذي يحمل قيمة ويصنع أثرًا. وأرى في رأيي المتواضع وهو عن تجربة أن أفضل منصة يمكن أن تحتضن هذا النوع من المحتوى المفيد هي منصة اليوتيوب، إذ تحوي آلاف القنوات التي تقدّم موادًا عميقة، تثري الدماغ، وتُنعش العقل.
إختر منها ما يتصل بشغفك مثل العلم، الفلسفة، التاريخ، التقنية، أو حتى تحليل الكتب والروايات المهم أن يكون المحتوى حقيقيًا، نافعًا، وذا مغزى. اجعل هذه العادة جزءًا من يومك، كما تتناول طعامك، وكما تمشي أو تتنفس. اغرس في روتينك مقطعًا واحدًا على الأقل يوميًا لكن لا تشاهده كأي مقطع آخر. شاهده مرتين:
في المرة الأولى، شاهد بانتباهٍ تام، وكأنك ستمتحن فيه. ضع في ذهنك أنك ستُسأل عن كل نقطة، كل فكرة، كل مثال. هذا التوجّه وحده كفيل بأن يُحفّز مناطق التركيز في دماغك.
وفي المرة الثانية، أمسك قلمك، وافتح دفترك، وابدأ في تدوين أهم الأفكار، بأسلوبك، لا بنسخ الكلمات. الكتابة هنا ليست للحفظ، بل للترسيخ، للتفاعل مع الفكرة، لجعلها جزءًا منك.
بهذا الشكل، ستبدأ تعويد دماغك على نوعٍ جديد من الاستهلاك، استهلاك يحمل معنى ويصنع أثرًا. ومع مرور الوقت، ستجد أنك من أول مشاهدة تستطيع فهم المحتوى بتركيز عالٍ، بل وتكتب ملاحظاتك منذ اللحظة الأولى دون الحاجة لإعادة مشاهدة، لأن عقلك أصبح جاهزًا مستعدًا متعطشًا لما هو نافع. هذه هي البدايات الحقيقية، يا عزيزي، وهي لا تتطلب عبقرية، بل التزامًا… والنية الصادقة في أن تصنع من نفسك إنسانًا آخر.
ها أنت، يا عزيزي، تصل أخيرًا إلى لبّ هذا المقال، إلى النقطة التي يتّضح فيها السبب من الطريق، والغاية من المحاولة. كما ذكرت سلفاً هذا المقال هو تمهيدي فقط لبدء رحلة ان تصبح مثقفاً، بداية من معالجة التعفّن الدماغي الناتج عن الاستهلاك السريع، سنلمس شيئًا فشيئًا أثر العلاج: سنبدأ في. استعادة شيئًا من الذاكرة التي كانت تخوننا، وشيئًا من التركيز الذي كان يتفلّت من بين أيدينا، وتراجع ذلك التشتت الذي كان يحول بيننا وبين أي عمق معرفي أو فكري. وما ذكرناه حتى الآن، يا عزيزي، هو البيئة الذهنية او ما أسميه بـ “الأساس”. أما في المقالات المقبلة، فنحن مقبلون على التعامل مع ما هو أعمق: النية، والمقصد، والاتجاه. لأن الوصول إلى المعرفة، أو الرغبة في أن تصبح مثقفًا، لا يتحقق فقط بقطع السموم العقلية، بل بترسيخ ما يُقابلها: النية النقية، والوقت المنظّم، والعادة الثابتة. الآن، وقد بدأ عقلك يستعيد صفاءه، حان الوقت لتُسائل نفسك بصدق:
لماذا أريد أن أكون مثقفًا؟
ما نوع المعرفة التي أبحث عنها؟
وهل أنا مستعد أن أُعيد ترتيب حياتي حول هذا الهدف؟
فهنا تبدأ الرحلة الحقيقية ياعزيزي. لأن الثقافة والتعلم، في جوهرها، ليست تجميع معلومات، بل بناء إنسان، بناء شخصية جديدة بالكامل. ولذا، فإن ما بعد العلاج هو التأسيس. وإن أردتَ يا عزيزي أن تتعلّم كثيرًا، أن تُغيّر نفسك من الداخل وتُصبح إنسانًا جديدًا بحق، فلابد أن نبدأ من جذور الأشياء. نعم، قد تبدو بعض الأمور بديهية عند السماع بها، لكنها في الحقيقة محمّلة بسوء الفهم أو بالتجاهل من الكثير. وأول هذه المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية هو: الوقت. وهو ما سيتم مناقشته في المقال التالي بإذن الله، لكنني لا أتحدث هنا عن جداول المهام أو تطبيقات تنظيم اليوم، بل عن الفهم الصحيح لمعنى الوقت، كما رآه الإسلام، وكما نُظمت به الحياة ذات القيمة حتى قبل الإسلام. الوقت، يا عزيزي، هو أثمن ما تملك، لكنه أيضًا أكثر ما يُهدر بلا انتباه.
هل تسائلت من قبل عن حسبة الوقت في الإسلام، إذ لم يكن الوقت يُحسب بالدقائق والثواني حينها كما نفعل اليوم. لم تكن هناك "ساعة حائط" تضبط الناس، بل كانت الحياة نفسها هي التي تضبط الوقت: الشمس، القمر، الفجر، الزوال، الغروب، الصلوات كانت أعمدة اليوم، وكل ما بينها من عمل وعلم وراحة ونُزهة كان يدور في فلك هذه المحطات النورانية. ولذلك العلماء قديماً يختلفون عن علماء اليوم، فالعلماء قديماً لم يتخصصوا في مجال واحد فقط بل في علوم مختلفة كلياً. وإذا أردت أن تعرف أثر هذا التصور، فانظر إلى العلماء المسلمين في العصور الذهبية والعلماء قبل الإسلام حتى.
ابن خلدون على سبيل المثال لم يكن مؤرّخًا فحسب، بل عالم اجتماع واقتصاد وفقيه ومفكّر سياسي. ابن الهيثم لم يكن "فيزيائيًا" فقط، بل طبيبًا، وفيلسوفًا، وعالم بصريات، وكان يُجري تجاربه على الضوء والمرايا. حتى ارخميدس اليوناني وهو قبل الإسلام بقرون عدة، لم يكن عالم رياضيات فقط بل عالم وفيزياء ومخترع اكتشف مبادئ الطفو والهندسة والميكانيكا، بل واخترع آلات دفاعية. هؤلاء لم يولدوا بقدرات خارقة، بل فهموا شيئًا نحن غفلنا عنه: أن الوقت طاقة مقدّسة، إن رتّبته ارتفع عقلك، وإن بدّدته تبعثرت أنت. أن تفهم معنى الوقت: لا بمعناه التقني، بل كما فهمه الحكماء، وكما عظّمه الدين؛ لأن إدراك الزمن هو أول مفاتيح السيطرة عليه.
ثم اسأل نفسك بصدق، ما مدى صحة رغبتك في أن تصبح مثقفًا؟ أهي رغبة أصيلة نابعة من حبّ للمعرفة، أم حاجة نفسية إلى الاعتراف والقبول؟ ما الغرض؟ ما النية؟ وينبغي كذلك أن تدرك حال الغفلة التي نعيشها تلك التي تُشعرنا بأننا "نقترب" من الثقافة بينما نحن في الواقع نبتعد عنها بالتشويش واللهاث. وبعد ذلك، لا بدّ من التنظيم، أن تفهم كيف ترتّب يومك ليثمر أسبوعك، ويثمر أسبوعك لتصنع عامًا له معنى. حينها فقط، يبدأ عقلك بالتغذّي حقًا، وتبدأ شخصيتك في النضج، ويصبح تفكيرك أكثر رزانة، أكثر عمقًا، وأقلّ اضطرابًا.
وكما أنني شاعر بك تمامًا، وأفهم ما يدور في أعماقك من حيرة وتوقٍ ونَفَسٍ طويل نحو الكمال، فاعلم أنني معك في هذه الرحلة. لا أقدّم النصح من برجٍ عاجي، بل من موضعٍ ملاصق لك في الطريق أتعثر حينًا، وأقوم حينًا، وأحمل معك ذات القلق وذات الطموح. ولأجل ذلك، لا يكفي أن نواسي أنفسنا بالكلام وحده، بل لابدّ من خطة، واضحة المعالم، نرسمها معًا، أنت وأنا، ونتعاهد على الالتزام بها لا التزامًا صارمًا خانقًا، بل التزام المُحب لمن يأمل في رؤية نسخةٍ أصفى من نفسه. وأعلم يا عزيزي أنني قد أطلت عليك الحديث، لكنني لم أفعل ذلك عبثًا. لقد سرنا سويًا في درب طويل من الأفكار، لأنني اؤمن ان التغيير الحقيقي لا يأتي بكلمة عابرة، بل بخطواتٍ تتراكم وتُبنى على فهم. ولأنني أؤمن أن عقلك يستحق الاحترام والتقدير، فلن أزحمك الآن بالمزيد بل سأدعك تلتقط أنفاسك، وتنتظر ما هو قادم بمشيئة الله. في المقال القادم، سنفتح معًا الباب لأحد أهم المفاتيح: مفهوم الوقت في الإسلام، وكيف أننا نعيش في غفلة عن جوهر هذا الوقت رغم أنه أثمن ما نملك. سنتحدث عن كيفية ترتيب اليوم ترتيبًا يُشبه الإنسان الذي تريد أن تصبحه، لا الإنسان الذي تفرضه علينا الفوضى والعادات. سنناقش:
ما الذي يجب أن يندرج في قائمتك اليومية؟
كيف توازن بين التعلم، العبادة، الراحة، والتأمل؟
كيف تجعل من يومك ورشة لبناء إنسانٍ جديد، أكثر تركيزًا، وعمقًا، واتزانًا؟
نعم يا عزيزي، سنقترب أكثر من الهدف: أن تصبح إنسانًا مثقفًا، ناضجًا، متزنًا، متصلًا بذاته وبربّه. ابقَ قريبًا، فما سيأتي قد يكون مفتاح التغيير الذي لطالما بحثنا عنه أنا وأنت.



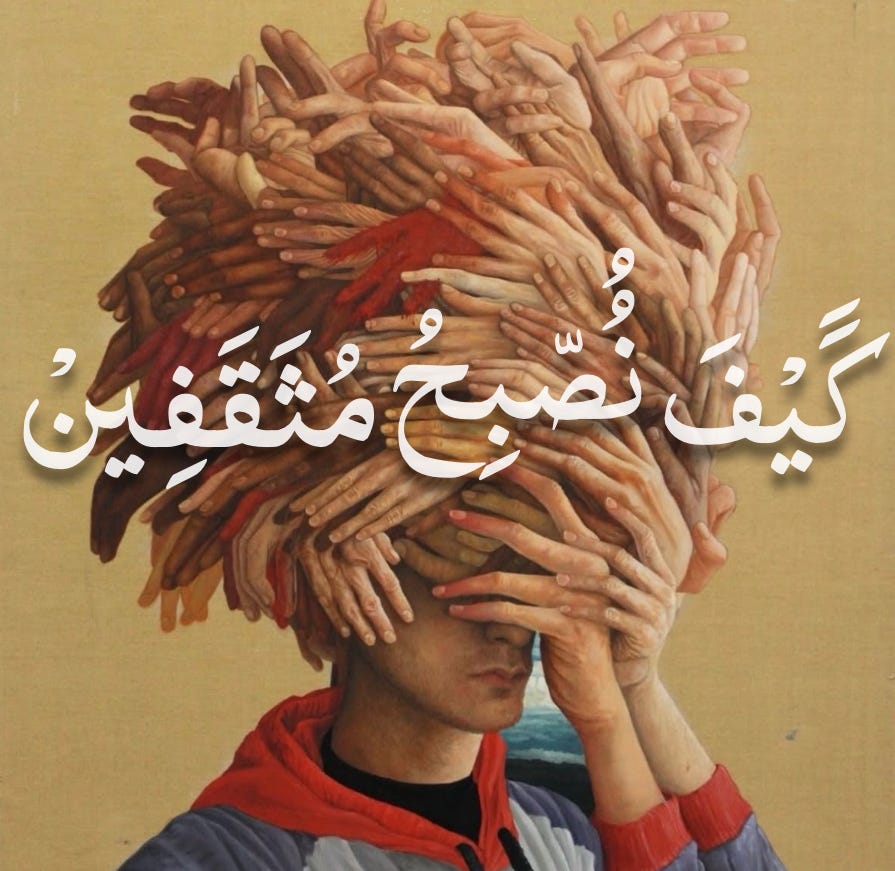
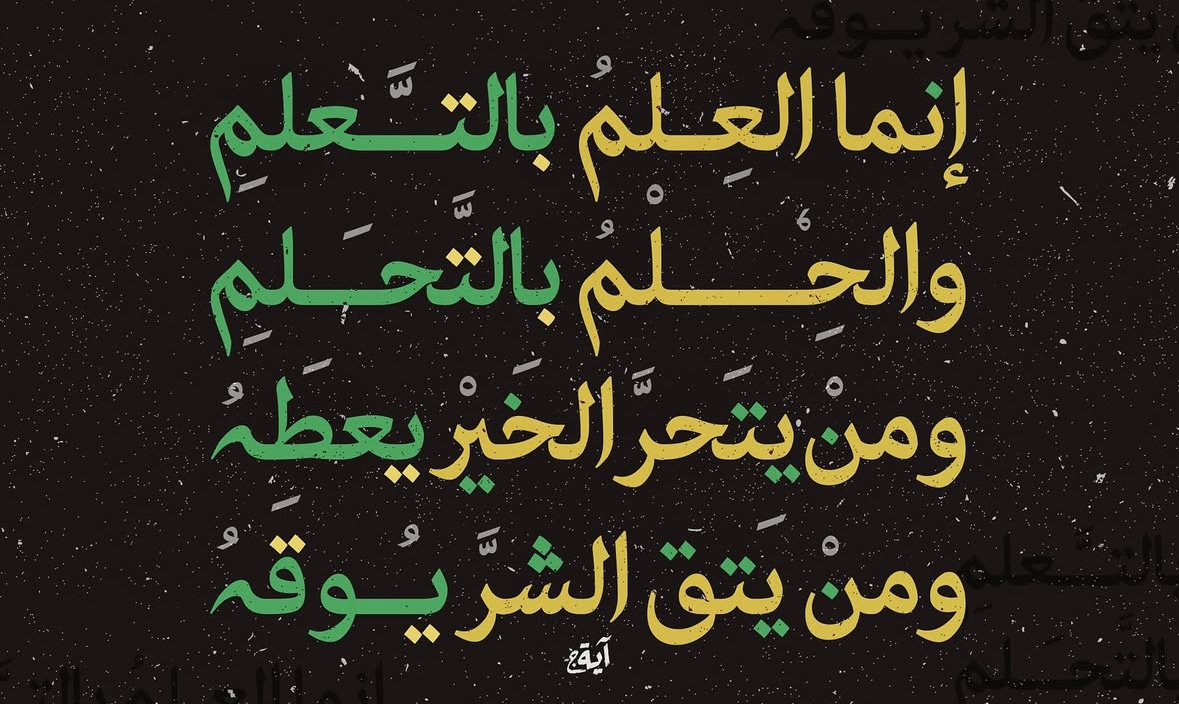
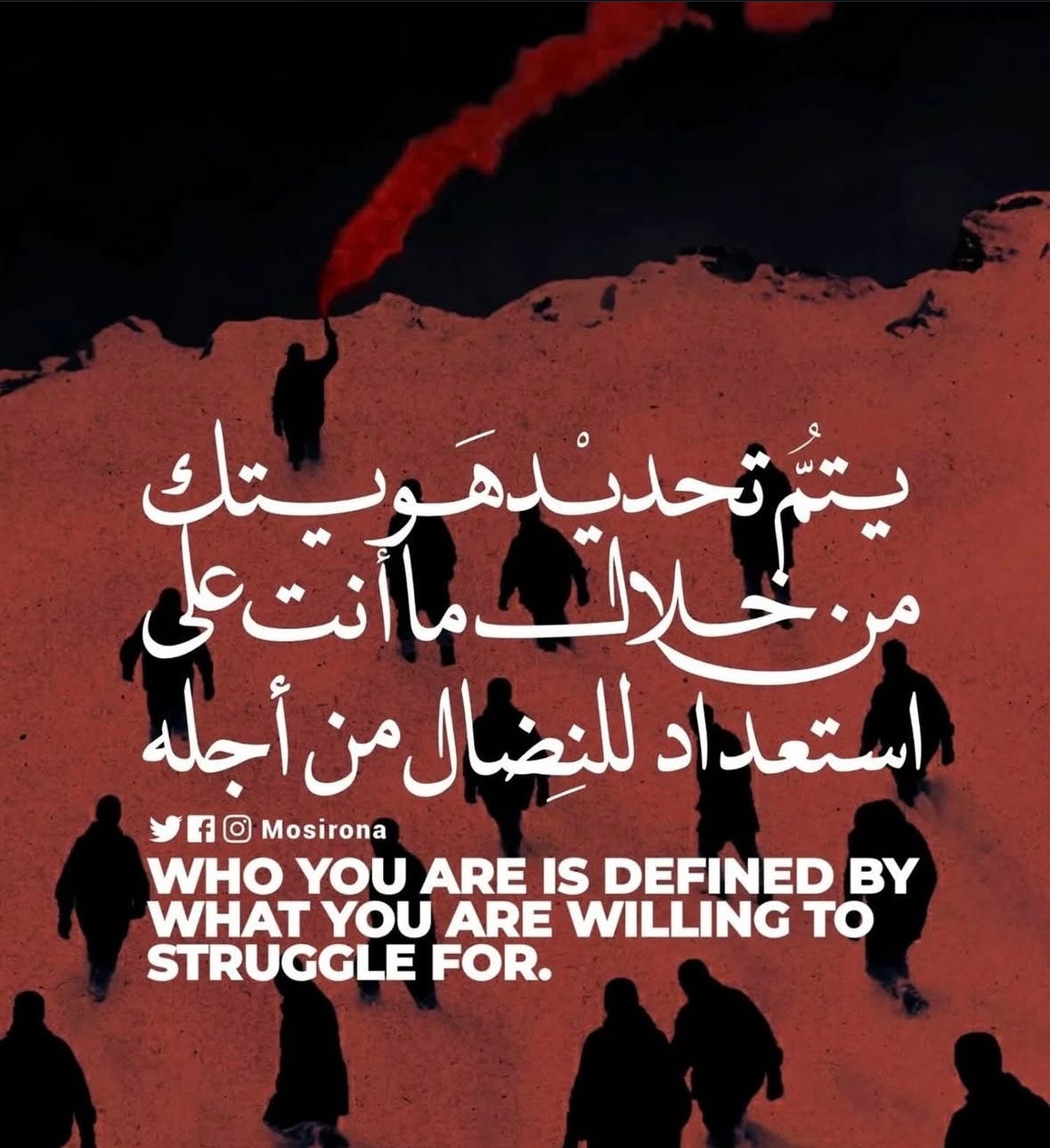
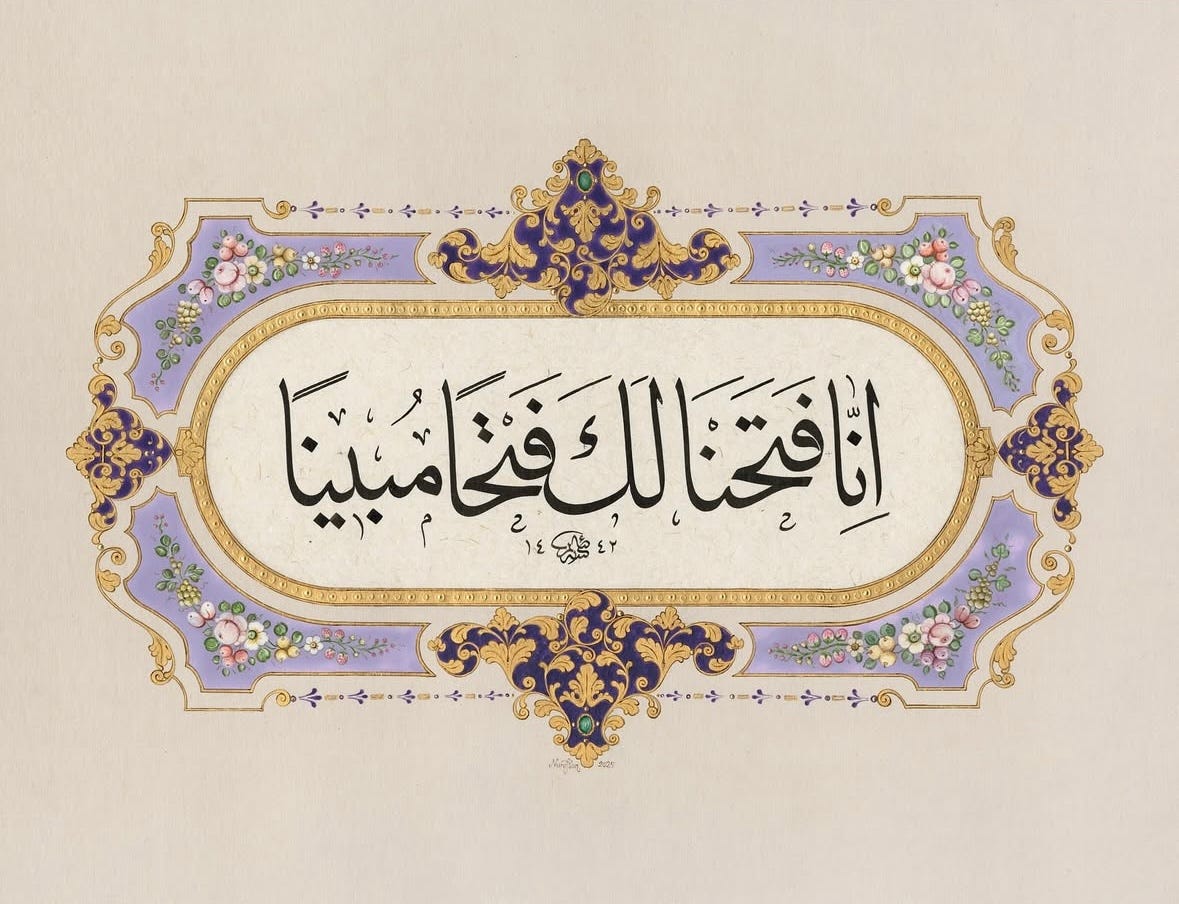
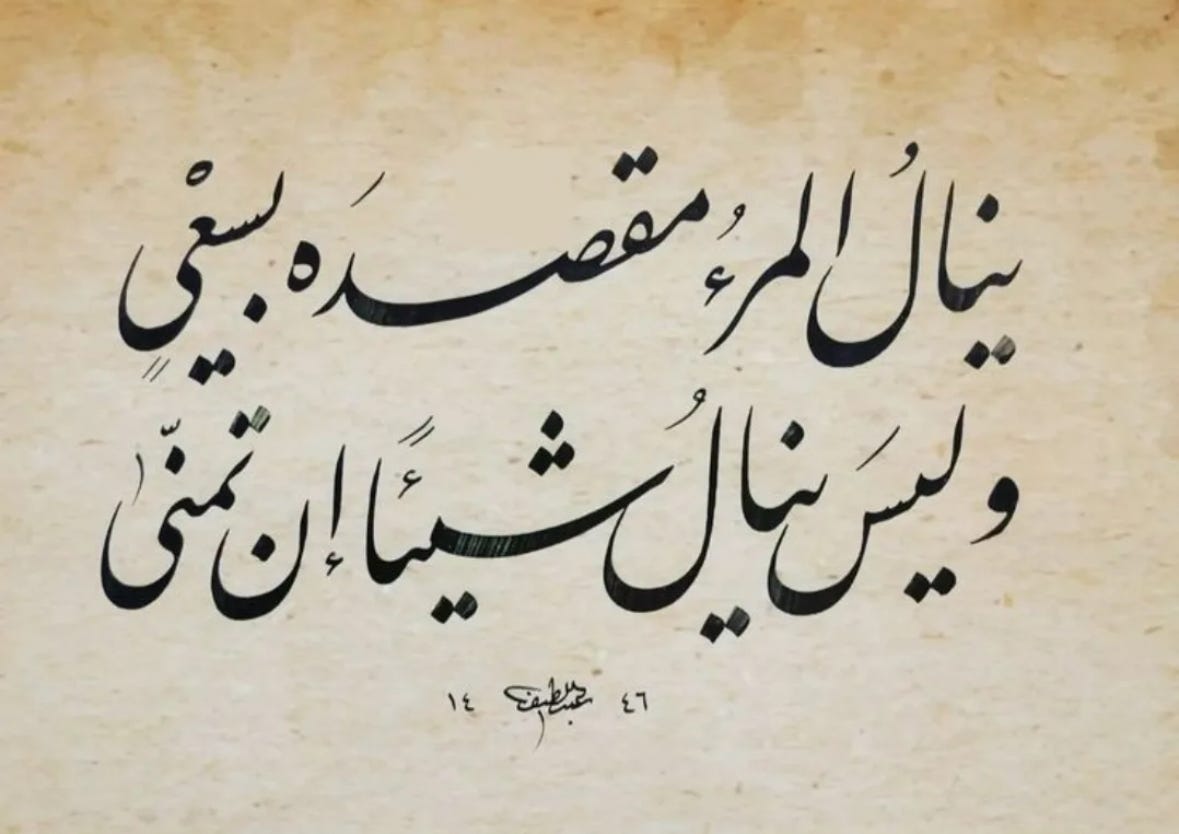
بناءً على اقتراحاتكم، تم تحويل المقال إلى فيديو مصوَّر على قناتنا في يوتيوب ايضاً، يمكنكم الاطّلاع عليه ومشاركته إن رأيتم أنه يستحق. ودمتم بخير وسعادة
https://youtu.be/_0CX1BHoWt4?si=D-TzklKIDuMR1kMN
ما قرأتُهُ للتو ليسَ مجردَ مقال، بلْ نِداء يقظة، و جوابًا عنْ كثيرٍ منَ التساؤلاتِ التي تُؤْرِقُ عقلي مُؤخرًا. يُسعدِني انه جاء في وقتهِ المناسِبْ و أنا في بدايةِ رحلةِ التشافي من تعفِنِ الدماغ الذي اصابَ عقلي. مقالٌ رائع كالعادةِ يا أشرفْ. نفعَ الله بكْ و أترقبُ المقالاتِ القادمة بشغفْ!