المدينة الفاضلة أم الفردوس المنهوب ؟
عبودية الاختيار الحر
تنويهٌ واجب:
إحذر ياعزيزي، فإنكَ على وشك النفاذ إلى لُبّ الحكاية وكشف مستورها. ما سيأتي هو كشفٌ صريحٌ لغوامض المسلسل ومآلاته. فإن كنت لم تشاهد العمل بعد، وتُؤثِر أن يبقى الغموض سيّد الموقف، فالرجوع الآن أسلم لك. وإن أكملتَ، فامضِ على بَيّنةٍ من أمرك.
أرجو يا عزيزي، وقبل أن نخوض في أي حديث، بأن تسمح لي أن أمارس عادتي التي عهدتَها فيّ في مقالاتنا سوياً. إنكَ تعلم ولعي بطرح الأسئلة؛ خاصةً الأسئلة الذكية التي لا نختارها، بل التي تختارنا، فتفتح أمامنا دروباً من الفكر لم تطأها أقدامنا من قبل، وتأخذنا إلى حيث كانت ترانا ونحن لا نبصرها. فليست الغاية، كما تعودنا، في العثور على جوابٍ يُريحنا، بل في الأسئلة ذاتها التي تُقلق راحتنا وتوسع آفاقنا.
ولذا، اسمح لي أن أستهل هذا المقال بسلسلة من الأسئلة التي تؤرق الضمير، ولعلك تطرحها على نفسك ايضاً وأهمها:
هل “إنسانيتُنا” بكل ما تحمله من ألمٍ ومعاناة، هي ثمنٌ باهظٌ ندفعه طواعيةً، رافضين حياةً أسهل وأكثر سكوناً للجميع؟
وهل يكمن السلام الحقيقي في بتر الرغبات المتنافسة من جذورها، أم في خوض المخاض العسير للتوفيق بينها، حتى وإن كان سبيلاً أطول وأشد كلفةً على المجموع؟
أيهما أثقل في الميزان: فرديّةٌ مُحقّقةٌ أم انسجامٌ شامل؟ وهل يغلبُ صَخبُ التعبير عن الذات على هدوء السلام العام؟
أنكون أحراراً في شقائنا، أم آمنين في نظامٍ يضمن راحتنا؟
وتلك التي سعت لإنقاذ البشرية مما أسمته “لعنة السعادة العمياء”، هل كانت رؤياها ثاقبة، أم كانت تدعونا لنتقاسم معها عذاباً لا ضرورة له، وتضحيةً لا يعود نفعها على أحد؟
ماذا لو كان ذوبان الفردية في بوتقة الجماعة هو الثمن الوحيد لسلامٍ عالميٍّ مستدام؟
هل نفضل فوضى الحرية المؤلمة، بكل ما فيها من حقٍّ في التعاسة، على سعادةٍ مُنظمةٍ نُسلب فيها خياراتنا لكننا ننجو بها من مآسينا؟
أو بعبارةٍ أخرى: هل تفضل أن تكون فرداً تعيساً فريداً، أم جزءاً من كُلٍّ سعيدٍ منسجم؟
إن هذه الأسئلة يا عزيزي هي جوهر المأزق الذي يواجه كل سعيٍّ إنساني نحو غدٍ أفضل. إنها تجبرنا بلا شك على أن ننظر أبعد من ذواتنا، لنسأل دائماً ما هي الغاية الأسمى؟ هل هي تمجيد الفرد، أم تخفيف وطأة الألم عن الجميع؟ إننا نميلُ، بطبعنا، إلى تقديس “المعاناة النبيلة” وحرية “الاختيار” حتى لو كان اختياراً للجحيم. ولكن، ماذا لو كان الاختبار الحقيقي هو التخلي عن هذا التقديس؟ ماذا لو كانت القيمة العُليا ليست في مدى تعقيدنا الفردي، بل في مدى قدرتنا على بناء نظامٍ يضمن أكبر قدر من السعادة ويقلل أكبر قدر من البؤس لأكبر عددٍ ممكن؟ بالنسبة للسؤال الأخير الذي طرحتَه “ماذا لو أصبح الجميع سعداء؟” فهذا السؤال هو ما سيقودنا سوياً في هذا المقال.
إن وطأة الألم حقيقةٌ دامغة، بينما أمجاد الفردية قد تكون وهماً نبيلاً ندفعه ثمناً باهظاً. وعندما يُوضع الخيار بين عالمٍ يئنُّ فيه الأفراد بحريتهم، وعالمٍ يرفلُ فيه المجموع بسلامٍ منظم، يصبح لزاماً علينا أن نعيد تعريف “الإنسانية”. ربما الجواب ليس فيمن “نكون” كأفراد، بل في “ماذا نحقق” كمجموع. ولعلّ الإنسانية الحقة لا تكمن في حقنا بالمُعاناة، بل في واجبنا الأخلاقي بإنهاء مُعاناة الآخرين مهما كان الثمن الذي ندفعه من “تفردنا”.
ولعلّكَ إن أردتَ الإلمامَ بجوهر هذه القصة والحكاية، فسأختصرها لك بالغ،ص في عالم بطلة العمل الفني “كارول ستوركا”. تلك هي بطلة السرد؛ امرأةٌ أوهى كاهلَها الإرهاق، وغرقت في كثرة شربها هرباً من واقعٍ لا تطيقه. هي الكاتبة ذائعة الصيت، التي تسكبُ للقرّاء رواياتٍ غراميةً تقليدية، فاجتمع حولها جمهورٌ غفير، وهي في غمرة ذلك كله، زاهدةٌ في رضا الناس، لا تُلقي بالاً لما يعتقدون. لكنّ المفارقة تكمن في كونها تمقتُ سراً وعلانيةً تلك الكتبَ ذاتها التي صنعت مجدها وبنت لها صرحاً. وهي لا تتردد في المجاهرة بهذا المقت أمام مديرة أعمالها، التي هي في الآن ذاته صديقتها المِثلية للأسف “هيلين”.
تستهلّ الحلقاتُ الأولى مسارها، فتنسجُ لنا خطين متوازيين ببراعة:
الأول، هو نذيرُ الفناء؛ حيث نرقبُ ببطءٍ مُطبقٍ ومُخيف، تفشّي فيروسٍ غامضٍ بدأ همساً، مجرد إشارةٍ راديويةٍ التقطتها مناظير الفلكيين قبل أن يصبح حقيقةً ماثلة.
والثاني، هو الغوص في يوميات كارول؛ تلك الحياة التي تبدو “اعتيادية”، لكنها مُثقلةٌ بالسخط، ويأسٍ خفيٍّ، وشعورٍ دائمٍ بعدم الرضا.
وإني (كمُشاهد) لأجدُ نفسي مفتوناً على الدوام بتلك السويعات الثمينة التي تسبقُ الكارثة؛ تلك اللحظات التي يظل فيها البشر غارقين في صغائرهم الإنسانية، ومنهمكين في معاركهم الشخصية، غير آبهين بالهاوية العظمى التي تنتظرهم. ومن رحم هذا التناقض الفادح بين الصغائر الإنسانية والمصير الجماعي يُبنى الأساس الوجداني العميق لهذه السلسلة. ثُمّ، وفيما كانت عتمة ليل (مدينة ألبوكيركي) تهبطُ، وعقب جولةٍ مُرهقة لتوقيع كتبها، تشهدُ كارول بعينَيها الفاجعة:
في وسط ضجيج إحدى الحانات، تسقط “هيلين” فجأةً، كأن خيطاً قُطع او أن احدهم للتو قد ضغط مفتاحاً وأطفأها. تندفع كارول إلى الداخل مستغيثةً، تطلبُ النجدة، فإذا بها تصطدمُ بواقعٍ يفوقُ الفهم؛ الجميعُ، دون استثناء، قد تجمّدوا في أماكنهم، أسرى ارتعاشٍ مُطبقٍ وحالةٍ من الشلل المُريب الغير مفهوم. يتحول المشهد إلى كابوسٍ حيّ؛ كارول تتنقل كالشبح بين أجسادٍ تهتزّ بلا وعي، ووجوهٍ شاخصةٍ لا تستجيب. إنه مشهدٌ يبعثُ على القشعريرة في التوّ واللحظة.
بيد أن ذروة الفزع لم تكن قد أتت بعد. فحين تقفُ على أعتاب مشفىً، لا تزال تستصرخُ طالباً العون، يلتفتُ إليها كل من في المكان، كأنهم جسدٌ واحدٌ، وبصوتٍ جماعيٍّ مُروّعٍ يخترق السكون، ينطقون بعبارة واحدة: “نحنُ فقط نريدُ المساعدة، يا كارول”. هنا يتجلى الغموض في أبشع صوره، وينكشفُ الستارُ لاحقاً؛ لم يكن ذلك فيروساً بالمعنى المعهود، بل تقنيةً غريبةً صهرت البشرية جمعاء في بوتقة “عقلٍ جماعيٍّ” مُوحّد. إنه هقل الجماهير بعينه. ولكن هنا لدينا سؤال آخر، لماذا قد يساعد الكوكب بأكمله شخص واحد لكي يبقى مثلهم؟
ذاب الأفراد في “الكُل”، وتحولوا إلى كيانٍ واحدٍ مُتّسق، يتّسم برضاً أخرس وسعادةٍ مُصطنعةٍ باردة، لا ينطقون إلا بعبارتهم الأثيرة: «نحنُ هنا للمساعدة». وفي وسط هذا التحول الكوني، تقف كارول وحيدة، تندبُ فقدان صديقتها، عاجزةً عن استيعاب ما آل إليه العالم. تكتشفُ كارول أنها ليست الناجية الوحيدة من هذا الاندماج، بل هي واحدةٌ من اثني عشر شخصاً فقط على وجه البسيطة، ظلوا، لسببٍ مجهول، مُحصّنين ضد هذا الوعي المُسيطر.
وبينما يتحول العالم من حولها إلى سيمفونيةٍ من الروبوتات عديمة الروح، المُنسجمة انسجاماً مُقلقاً، تظل هي على سجيتها؛ مُحتفظةً بفوضاها، وألمها، وفردانيتها، وتشبثاً مُريراً بزمام ذاتها. وهذا التفرّد، هذا “النشاز”، لا يروقُ للعقل الجماعي. فرغم قناعه الهادئ و«لطفه» الظاهري، إلا أن هذا الكيان المُهيمن يضع نُصب عينيه هدفاً واحداً وهو إقناع كارول، وإقناع القلّة الباقية من الأفراد، بالانضمام إلى “الكل” طوعاً أو كرهاً. وهذا يُساعد من ان يبقى الغالم كله ضمن إطار واحد معين.
وهنا، يا عزيزي، يكمنُ المغزى العميق الذي أراده صانع العمل “جيليجان”. من اليسير جداً أن نرى في قصة (Pluribus) هذا إسقاطاً مباشراً ونقداً لاذعاً لمخاطر “الذكاء الاصطناعي” التوليدي؛ ذلك العقل الجماعي الذي يهدد بابتلاع الفردية والإبداع البشري. ولم يكن هذا الإسقاطُ خفيّاً، بل إن المسلسل يتصدّرُ شارتَه بتنويهٍ فخورٍ وقاطع: «هذا العمل أُنجز بالكامل بأيدٍ بشرية، دون أي مساعدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي». فـ “جيليجان” معروفٌ بموقفه الصارم المناهض لهذه التقنيات التي يراها مهددةً لجوهر الإبداع البشري المتفرد. هو يرى في هذا “الكل” السعيد والمُوحّد خطراً يمحو الأنا، تماماً كما يمحو الذكاء الاصطناعي صوت المؤلف الأصيل. إنه نفٌسُ الموقف ذاته الذي عبّر عنه في مقابلةٍ حديثةٍ له، حين ألقى بسؤالٍ يختصرُ كل شيء: «ما الذي قد يكونُ أهمَّ من أن تكونَ مُبدعاً؟» وكأنما كارول، بفوضاها، وألمها، وإنسانيتها الناقصة، وإصرارها على أن تكون “هي” لا “جزءاً من كل”، هي صرخة “جيليجان” الأخيرة في وجه عالمنا اليوم الذي يفضل السعادة المُصطنعة والانسجام الآلي على الألم النبيل للإبداع الفردي.
في جوهر الأمر، إن هذا الذوبان المُريع للبشرية، وهذا الانصهار القسري في كيانٍ أوحد كما يصوره (Pluribus)، ليس إلا صرخة إدانةٍ مدوية. إنها أشبه مايكون بمرآةٌ صافيةٌ تعكسُ ما تسعى إليه إمبراطوريات التقنية العظمى وكيانات الذكاء الاصطناعي مثل محوُ الهويات المتفردة، وسحقُ “الأنا” الفردية، لتحويلنا قسراً إلى جماعاتٍ مُستكينةٍ، راضيةٍ في ظاهرها، لكنها خاوية الروح و كل ذلك تحت ستار “الكفاءة” المزعوم.
ولعلّك تدرك ياعزيزي، سِمةً متكررة في هذا الصنيع الفني، أو فيما سواه من أعمالٍ تُلامس شغاف القلوب، ولنا في “الإنشطار” (Severance) مَثَلٌ ساطع. ستجد أن أبطالها قاطبةً يرتعون في وهم الحرية؛ يُسبغ عليهم أَرْغَد العيش، فيُعَامَلون معاملة الأسياد، وتُغدق عليهم العطايا والمكافآت السخيّة، ويُحاطون ببيئة مصقولة تبدو كأنها “اليوتوبيا” او البيئة الفاضلة الموعودة. وحتى في “الإنشطار”، حيث بدا الخيار مُتاحاً لهم بملء إرادتهم ليُقسّموا ذواتهم، وحيث طُبّقت عليهم أرقى معايير المهنية والتقدير، لم تكن تلك الحرية، في كلتا الحالتين، إلا سراباً خادعاً. فبينما هم غارقون في نعيم قناعاتهم بالاستقلالية، كانت ثمة أيادٍ خفية تنسج من وراء ستار خيوط مصائرهم، وتَرسم لهم حدود الحركة المباحة، ويُلقى في رُوعِهم ذلك الوهم العظيم وهو وَهْمُ أنهم سادة قرارهم وأن لهم الإختيار. إنها العبودية المُقنّعة في أبهى صورها؛ سجنٌ مُذهّبٌ جدرانُه، لا يرى سجناؤه القضبانَ لأنهم اتخذوا من زوايا السجنِ الضيقة عالماً فسيحاً. وهكذا، يُسلب الإنسان حقيقته الأسمى، ولكن بدلاً من أن تكون بالقهر والسوط، تُصبح بالرضا المُصطنع والرخاء المسموم، ليصبح أداةً طيّعة في يد مُحرّكِهِ، وهو يبتسم، مُعتقداً أنه اختار تلك الابتسامة فتستمر عبوديته.
تتلقى كارول صدمتها الكبرى حين تكتشف أن خمسةً من رفاقها “المُحصّنين” قد استسلموا بهدوءٍ مُريبٍ لهذا الواقع الجديد. ولما لا؟ فها هو عالمٌ قد طهّر نفسه من الألم، ومحا الجريمة، وألغى الموت. لقد بلغَ هذا العقلُ الجماعي من “نُبله” الزائف حداً لا يسمحُ فيه بقتل كائنٍ حيّ عمداً حتى ولو كانت حشرة مؤذية، ولو كانت حشرةً هامشية. لقد تحول “الجميع” إلى خدمٍ طائعين لهذه القلّة الباقية من البشر، وهو امتيازٌ سارع بعض هؤلاء الناجين إلى التمتع به دون تأنيب ضمير. اضواء المدينة تُتطفأُ باكراً لأن السبب الوحيد لبقائها هو رؤية مرتكبي الجرائم والذين هم في هذه الحالة ليسوا موجودين. نعم ياعزيزي، إنه الوعدُ بعالمٍ يسيرُ كنظام آلةٍ مصقولةٍ لا تشوبها شائبة. ولكنه، في حقيقته، عالمٌ مسلوبُ الحياة، لأن الحياة لم تُخلق على أن تكون مثالية، وإلا فما كان هنالك جنة في الآخرة.
فحين تغيبُ “المعاناة”، تغيبُ معها بالضرورة أسمى تجليات الإنسانية وهي ببساطة لا فرحَ حقيقيٌّ ينبض، لا فضولٌ يستكشف، لا إبداعٌ يبتكر، ولا دهشةٌ تفتحُ العيون على الجمال. إن هذه المشاعر، وهذه التجارب الشاقة، هي الثمنُ الباهظ الذي ندفعه مختارين مقابل حياةٍ حقيقيةٍ نملكُ فيها زمام أنفسنا. قد يختلج في صدرك تساؤلٌ مُلِحّ ألا وهو ما أبهى أن يكون العالم على تلك الصورة المثلى! عالمٌ مُطهّرٌ من آفة الجريمة، مُبرأٌ من وَصمة التعاسة، قائمٌ على دعائم الهناء الخالص. فَلِمَ لا يصبو المرءُ إلى مِثل هذا النعيم المقيم؟
وإنه لسؤالٌ مشروعٌ ياعزيزي ولكن دعني أُجلِّ لك حقيقة الأمر: إن النَّفس البشرية لا تُدرك الأشياء إلا بأضدادها. فالطفلُ الذي لم تُصبه النار بلفحها، لن يدرك كُنهَ أذيتها؛ والنَّفسُ التي تقلّبت في بَحر السعادة الدائمة، ولم تذُق مرارة الشقاء قط، كيف لها أن تعرف للسعادة معنىً حقيقياً؟ إن الهناء الحقيقي ليس حالةً مُطلقة جامدة، بل هو شعورٌ حيٌّ يُعرَّفُ بنقيضه. إنها حالةٌ ذهنية تُبنى على الاختيار والمقارنة والظفر. وببيانٍ أوضح فإن العالم المثالي الخالص، هذا الفردوس الأرضي المنشود، هو في جوهره سجنٌ لِمعنى الإنسان. فلو وُجدتَ فيه، لما عرفتَ للسعادة طعماً، ولأصبحت روحك باهتةً خاوية. بل لن يلبث المرء فيه إلا أن تذوي بصيرته، ويغرق في لُجّة العدمية، باحثاً عن أي شيءٍ يكسر هذا الجمود، حتى لو كان الألم، فكيف للعين أن تُقدّر روعة النور، إن لم تَسبر أغوار الظلام البهيم؟
إن قيمة الوجود الإنساني تكمن في “الجهاد”؛ في الاختيار بين النور والظلام، وفي المعاناة التي تصقل المعدن، وفي الدمعة التي تسبق الابتسامة. أما السعادة الكاملة، المطلقة، التي لا تشوبها شائبة، فهي وهمٌ لا يُنتج إلا فراغاً لا يُطاق.
وهكذا، يظلُّ الأسى الذي يعتصر “كارول” لفقدها “هيلين” هو المِحورَ النابضَ لهذا السَّرد، والوترَ الأكثر ألماً في معزوفته. إنه ذلك الوجدان الإنساني البِكْر، الخام، الذي يقف أمامه ذلك “العقل الجمعي” المُصطنع وقفة العاجز، فلا هو قادرٌ على استيعابه، ولا مُهيأٌ لتجربته. وهنا يكمن مَقتلُ اللغز، وتفسيرُ تلك الفَناءات الغريبة التي تحلُّ بالآخرين كُلّما أثقلَ الحزنُ كاهِلَها أو اعترتها سآمة. ولا عجب أن يثورَ في الذهنِ تساؤلٌ وهو أيُّ رابطٍ عجيبٍ يجمعُ بين ضجرها ووحدتها، وبين مَصرعِهِم هم في نفس الوقت؟
والعلاقةُ، يا عزيزي هي علاقةُ النقيضِ بالنقيض؛ علاقةٌ وجوديةٌ حتمية. فالإنسان، في فطرته، كائنٌ مَجبولٌ على الشعور؛ يُمزِّقُهُ الحزن، ويُضنيه الضجر، ويُرهقُهُ الملل. أما أولئك، فقد انتُزِعَت مِنهُم نِعمةُ (أو لَعنةُ) الإنسانية. لقد سُلِبوا هذا الجوهر، وأصبحوا قوالبَ فارغة، لا مكان في وعيها المحدود لفيضان المشاعر الحقيقية. ألم تَرَ كيف كانت رفيقتُها المصنطعة، وهي تلفظُ أنفاسَها الأخيرة تحت وطأةِ الموتِ الناريّ، ترتسمُ على شفتيها ابتسامةٌ جليديةٌ غريبة؟ إنها لم تكن تبتسمُ شجاعةً أو رضاً، بل لأنها لا تدرك معنى الألم، ولا تعرف كُنهَ الفقد. إنها لا تفقهُ شيئاً عن لغةِ الدمعِ أو هَولِ الفجيعة؛ فالمشاعرُ الأخرى، غير تلك السعادة السطحية المُبرمجة، هي لغةٌ ميتةٌ بالنسبة لها.
لذا، فإن حزن “كارول” ليس مجرد عاطفةٍ شخصية، بل هو الحقيقةُ المطلقة التي ينهارُ أمامَها زيفُ عالَمِهِم. إن ضجرها هو مرآةٌ صافية تُظهِرُ لهم فداحةَ خواءهم. وحين يواجهون هذا العمقَ الإنساني، وهم العاجزون عن مُجاراتِه، لا يملكون إلا أن يتلاشوا؛ لأن وجودهم الهَشَّ لا يقومُ إلا على إنكارِ ما تُمثّله هي.
ويتجسد هذا العجزُ الفلسفيُّ جلياً في مشهد آخر وهو مشهد الدفن القاسي. حين تحاول كارول، وحيدةً مكلومة، أن تواري جثمان صديقتها تحت شمس الجنوب الغربي الحارقة. هناك، يظهر “زوسيا”، أحد أفراد العقل الجماعي المُكلف بمراقبتها، عارضاً “المساعدة” بمنطق الآلة البارد. وفجأةً، وبفضل هذا العقل المُتصل، تحصل كارول في لمح البصر على كل ما تحتاجه من أدواتٍ وموارد لشقّ تراب (ألبوكيركي) العنيد.
لكنّ هذه “الكفاءة” المُطلقة، لا تُطفئ جمرة الفقد، ولا تُخفف من وطأة الحزن، ولا تُغير من حقيقة الموت شيئاً.
وهنا، وأمام صدقِ العاطفة الإنسانية المُرّة، ينهارُ هذا النظامُ المُحكم. فكلما أطلقت كارول العنان لغضبها الحقيقي، وصبّت جام سخطها المشروع على “زوسيا” (ومن خلاله على “الجميع” المرتبطين به)، يعودُ هذا العقلُ العظيمُ إلى حالة الشلل المروعة التي رأيناها في الليلة الأولى. إن “إنسانيتها” الفائضة، بكل ما فيها من ألمٍ وحرقة، هي بمثابة فيروسٍ مضادٍ لهذا النظام المُصطنع، فتتهاوى بعض أجزائه وتموت.
وعندما تُدرك كارول أنها، بغضبها، قد تسببت في هذا الموت، تأتي ردة فعلها وهي إنسانيةً حتى النخاع، تنهارُ على ركبتيها، وتتقيأ في التراب. إنها، في ألمها، وغضبها، وحزنها، وحتى في تقيؤها أكثرُ حياةً وأشدُّ إنسانيةً من عالمٍ كاملٍ يعيشُ في سلامٍ مُعقّمٍ وسعادةٍ ميتة.
قد يُخيَّلُ للمرءِ أن الحكايةَ في مشاهد معينة رَمزٌ لِجائحةِ (كوفيد)، وهذا يَصِحُّ جزئياً؛ فالعقلُ المَسخُ وثُلّةٌ مِن “المُحَصَّنين” يُحاولون إقناعَ “كارول” بأن الخطبَ يسير، وبأن التضحيةَ بِبضعِ أرواحٍ في سبيلِ “الصالحِ العام” هو ثمنٌ مقبولٌ ومَهرٌ زهيد. ولكنَّ الحقيقةَ أعمقُ مِن مَجَرَّدِ الوباءِ. فالذكاءُ الاصطناعيُّ وهو مثال فقط، بِسُلطَتِهِ المُتَغَوِّلَة، هو التَجْسيدُ الواقعيُّ الأقربُ لِهذا العقلِ الفائقِ في “بلوريبوس” (Pluribus).
أتَذكُرُ حينَ سألت “كارول” “زوسيا” عن كَيفيةِ رَصدِهِم لها وهي تَحفِرُ القبر؟ أجابتها تلكَ بِبُرودٍ لا يُبالي، أنهم يَرقُبونَها بِطائِرَةٍ مُسيَّرَةٍ عسكريةٍ تُحَلِّقُ على ارتفاعِ آلافِ الأقدامِ. ثم تُطَمئِنُها، ويا لِلمفارقةِ المُرّة، بأنها “غيرُ مُسلَّحَة”! وكأنَّ الرقابةَ المُطلَقةَ، وسَلبَ الخصوصيةِ، وقُدرَةَ النظامِ على مَعرِفَةِ كُلِّ شَارِدَةٍ وواردةٍ، ليسَت سِلاحاً بحدِّ ذاتِه!
وكل هذا يجعل من تسميته مسمى مبدعاً في حد ذاته، فالعنوان Pluribus، مأخوذ من الشعار اللاتيني الذي اعتاد الأمريكيون رؤيته على ظهر العملات، والذي يعني “واحد من الكثير”، ولكن المسلسل يقلب هذا الشعار رأساً على عقب. فبدلاً من أن يكون “الواحد” (الدولة/المجتمع) مكوناً من “الكثير” (الأفراد) مع احتفاظهم بفرادتهم، يقدم المسلسل عالماً أصبح فيه “الكثير” (البشرية) حرفياً “واحداً” (عقلاً جمعياً). ولذلك قد يوحي بأن هذه سلسلة سياسية. ليس الأمر صريحًا، لكنه يطرح الكثير من التساؤلات حول أفضل طرق ترتيب المجتمع.
لا ريب أنني سأواصل الغوص في تتبع هذا العمل، ولعلي أعود لأسطر عنه رؤى أعمق، بل ربما أفرد له تحليلاً نفسياً خالصا يسبر أغوار “كارول”؛ لأنها الشخصية المحورية. إنها، وقبل سطوة “العقل الجمعي”، لم تكن كتاباً مغلقاً تماماً، ولكنها في الوقت ذاته، لم تكن كتابا مفتوحا على مصراعيه. ويشي بذلك، أصدق الشهادة، اختيارها المتعمد أن تجعل البطل المحوري في مخطوطاتها ذكراً لا أنثى، وهو السر الذي باحت به لـ “زوسيا” في غفلة من الزمن.
إن في هذا الاختيار، وفي اختيارها هي بالذات لتكون أيقونة الرفض وعنوان العصيان، لهو اختيار مثير وموفق إلى أبعد الحدود. وإن لصفتها كـ “مؤلفة” و “كاتبة” لأثراً بليغاً في هذا الاصطفاء؛ فالكاتب، في جوهره، هو حارس الفردانية الأخير، وهو العين التي ترصد الزيف، والقلم الذي يقاوم المحو. وإنني لأترقب بشغف إلى أي مدى ستغوص السلسلة في هذا المنحى، وتشرح هذا البعد.
ولكن، ويا لها من لفتة بارعة، فحين توضع “كارول” في مواجهة أندادها من البشر “المحصنين” الآخرين، لا يلبث النقاب أن ينكشف عن عيوبها هي الأخرى بجلاء تام. إنها ليست قديسة منزهة، ولا بطلة مثالية؛ بل هي إنسانة بكل ما في الكلمة من نقص وتناقض وارتباك. ولعل في هذا، بالذات، تكمن قوتها الحقيقية، وسر تفردها؛ فإنسانيتها “المعيبة” هذه، بغضبها وضجرها وعيوبها، هي السلاح الأوحد في وجه “الكمال” المصطنع، والمثالية الجوفاء التي يبشر بها ذلك العقل المسخ.
لا تنسَ متابعتنا على قناة اليوتيوب من هنا:



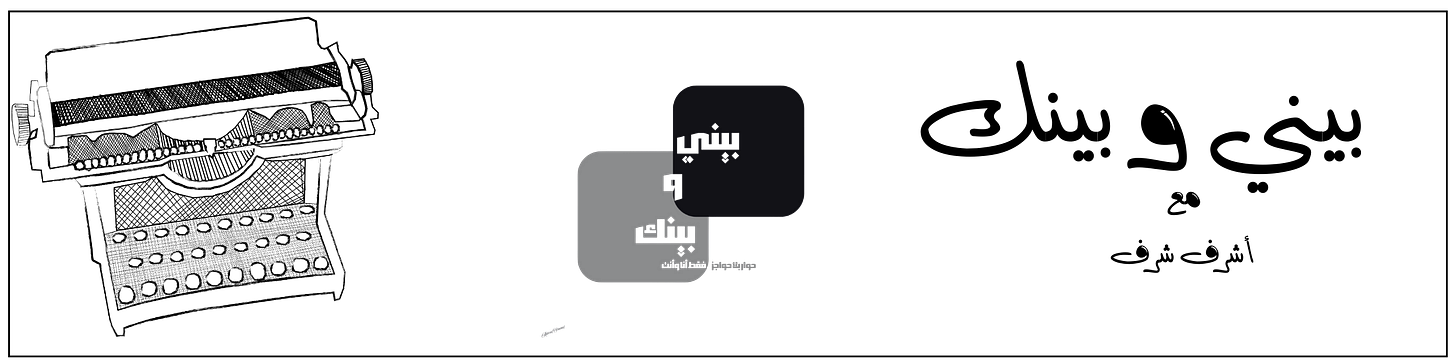










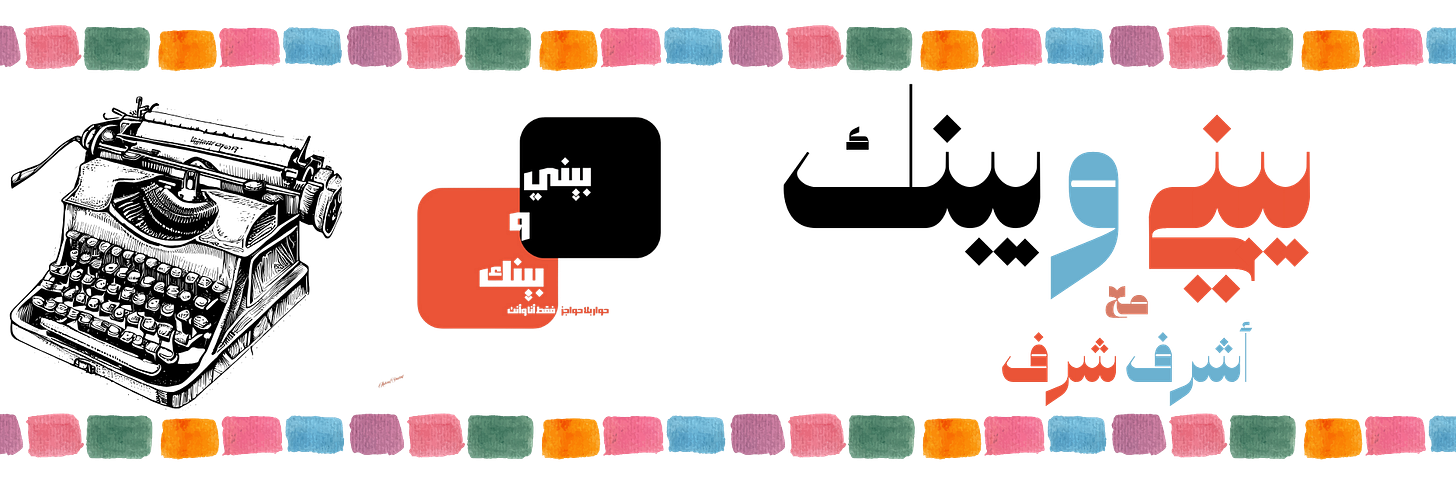
اخوي اشرف صور النساء AI؟