من “الداء” إلى “الدواء”: قراءة الأدب الروسي بعين البصيرة
الأدب الروسي يسأل والإسلام يُجيب
لقد أُشْرِبَ قلبي، منذ أمدٍ بعيد، حُبَّ الأدب الروسي؛ ولطالما كان هذا الشغفُ متيناً، راسخاً كالجبال التي صوّرها في سهوبه الفسيحة، وعميقاً كالأرواح التي شرّحها بمبضع الفهم الدقيق. لا أُخفيكَ ياعزيزي أن سِرَّ هذا الولع، كما أسلفتُ في مقالات أخرى، لا يكمنُ في براعة السَّرد وحبكة الرواية فحسب، بل في كونه أدباً “إنسانياً” خالصاً، يغوصُ بلا وجلٍ في أعمق أغوار النفس البشرية.
لا يخشى طرح الأسئلة الوجودية الكبرى؛ أسئلة الخير والشر، ومعنى المعاناة، وجدوى الإيمان في عالمٍ يبدو أحياناً غارقاً في العبث. لم يكتب أصحابه ليُسلّوا، بل ليكشفوا عن ذواتهم كما في أنواع الأدب الأخرى، بل ليُعرّوا الحقيقة الإنسانية من كل زيفٍ أو ادعاء. ففي كل رواية وصفحة نلتقي بالإنسان في أقصى حالات ضعفه وجبروته، في قمة قداسته وفي حضيض خطيئته. هو الأدب الذي يُعلّمنا أن نفهم “الآخر” حتى في أحلك صوره، لأنه يُرينا أن ذلك الظلام يقبعُ أيضاً في زاويةٍ من أرواحنا، لإنها الحقيقةُ الأزليةُ للنفسِ البشرية ياعزيزي؛ فهي كالأرضِ، تحملُ في داخلها الخصبَ والجَدْبَ، وكالبحرِ، يضمُّ في أعماقهِ الدُّرَّ والوحش. لكلِّ نفسٍ جانبان، لا ينفكُّ أحدُهما عن الآخر: جانبٌ يتوقُ إلى السَّماءِ بنُبْلِهِ، وجانبٌ ينجذبُ إلى الطينِ بِوَضَاعتِه، الخير والشر.
ومهما كنتَ تظنُّ في نفسِكَ النقاءَ، ومهما بَدَا لكَ أنكَ غُسِلتَ من أدرانِ الشرِّ، فما أنتَ في الحقيقةِ إلا راهبٌ لم يغادرْ صومعتَه بعد. أنتَ فقط لم تكتشفْ ذلك الجانبَ القابعَ في زوايا روحِكَ المظلمة؛ لربما لأنكَ لم تُواجهْ بعد الموقفَ الذي يستدعيهِ من داخلك. لم تُوضَعْ في مأزقٍ حقيقيٍّ يُخيِّرُكَ بين مبادئِكَ ونجاتِك. لم تُظلَمْ إلى الحدِّ الذي يوقظُ فيكَ رغبةَ الانتقامِ العارمة. لم تُبتَلَ بسلطةٍ مُطلقةٍ تكشفُ لكَ عن شهوةِ التسلُّط، أو بِثروةٍ طائلةٍ تُظهِرُ لكَ قسوةَ الأثرة. إنكَ لم تَقِفْ بعدُ على الحافّةِ؛ تلك الحافّةُ الدقيقةُ التي تفصلُ بين الفضيلةِ والرذيلة، والتي لا يتطلّبُ عبورُها إلا زلّةَ قدمٍ واحدة، يسبقُها اختبارٌ قاسٍ.
فالشرُّ فينا ليس غائباً بقدر ما هو نائمٌ، ينتظرُ أن يقرعَ القدرُ بابهُ ليَصحوَ. وحينئذٍ فقط، حين يُستَدعى ذلك الغريبُ من أعماقِنا، نُدركُ كَمْ كُنّا نجهلُ أنفسَنا. إنهم في هذا النوع من الأدب لا يقدمون لك أبطالاً مثاليين، بل يقدمون بشراً يتخبطون، يشكّون، ويحبون، ويكفرون، ويبحثون عن الخلاص في قلب اليأس. لقد شرّحوا الروح الإنسانية في تقلباتها بين القنوط والأمل، وبين العقل الهادئ والجنون المطبق. لهذا، يبقى الأدب الروسي بالنسبة لي نافذةً نطلُّ منها على كُنْهِنا، ومرآةً صقيلةً نرى فيها تناقضاتنا المقدسة والمدنسة، فنجدُ في صدقه الفذّ عزاءً عميقاً وفهماً نادراً لما يعنيه أن تكون “إنساناً”.
فبخلافِ كثيرٍ من الآداب الأخرى ولعلَّنا نجدُ في الرواية الإنجليزية أمثلةً فاقعة لم يُسخِّر الأدبُ الروسي العظيمُ قَلَمَه لخدمةِ اي أيديولوجيا، ولم يجعَل من فَنِّهِ بوقاً لتمجيدِ عقائدَ سياسية، أو تلميعِ رموزٍ زائفة. لعلّي، يومَ أنْ آثرتُ الأدبَ درباً وتخصصاً، أطلقتُ لفكري العِنانَ يجولُ في مشاربَ شتّى. لقد قرأت في الأدبِ الكوري، ونهلتُ طويلاً من مَعينِ الأدبِ الإنجليزي، وتجذّرتُ في العربيّ، فهو لساني الأُمِّ ومَهْدُ الوجدان. ولم أكن لأغفلَ عن أصواتِ إفريقيا وآسيا، فقرأتُ ما تيسّرَ لي من الأدبِ الإيراني والأفغاني، والإفريقي.
ثم، كان اللقاءُ الأخيرُ والأعمقُ حين انتهى بي المطافُ إلى رحابِ الأدبِ الروسيّ. وهنا، وَجَبَ علي الوقوف في كل مرة؛ فالأدبُ الروسيُّ، في واقعِ الأمر، كان نسيجاً وَحْدَه، مُغايراً لكلِّ ما سَبَق. إنَّ “الحظَّ” الذي نالَهُ من نفسي، كما أشرتَ، كان مختلفاً. فما إن أطوي الصفحةَ الأخيرةَ من إحدى رواياتهم، حتى تُفتَحَ أمامي صفحاتٌ منسيةٌ من حياتي أنا. كان كلُّ سطرٍ فيهِم يستدعي من ذاكرتي مواقفَ وأشلاءَ تجاربَ، كأنما كُتِبَ لي وعنّي، وبحثَ في أغوارٍ لم أكن أعلمُ بوجودها.
ولعلي أُبَيِّنُ لكَ الفارقَياعزيزي لأُقَرِّبَ إليكَ معنى أن “يُسخِّرَ الكاتبُ قلمَهُ لخدمةِ مُعتَقَدٍ أو أيديولوجيا”.انظُرْ، على سبيلِ المثالِ، إلى أولئك الأبطالِ الخارقين الذين يملؤون الشاشاتِ، سواءً أكانوا من “مارفل” أم “دي سي”. لربما أُعجِبتَ يوماً بقوّةِ “سوبرمان” أو ببطولةِ “كابتن أمريكا”. ولكن، أما تساءلتَ قَطُّ عن الرسالةِ المُبطّنةِ خلفَ تلك العباءاتِ البرّاقة؟
ألا ترى كيف أنَّ جُلَّ هؤلاءِ الأبطالِ، في حقيقةِ أمرِهِم، ما هُم إلا رُسُلٌ لرسالةٍ تُمجِّدُ “الحُلُمَ الأمريكي” وقِيَمَ الولاياتِ المتحدة؟ تأمَّلْ مَلِيّاً في ألوانِ بِزَّةِ “سوبرمان” أو “سبايدر مان”؛ أليستْ هي ذاتَها ألوانُ العَلَمِ الأمريكي؟ ألا تُلاحظُ أنَّ أغلبَ لقطاتِ المجدِ والانتصارِ تُؤخذُ بعنايةٍ وذلك العَلَمُ يرفرفُ في خلفيَّتِها، كأنما النصرُ حِكْرٌ عليهم؟ إنَّ الأمثلةَ على هذا التوجيهِ لا تقعُ تحتَ حَصْر. هذا هو الفنُّ حينَ يُستَأجَرُ لغرضٍ سياسيٍّ أو دعائيٍّ مُسبَق.
أمّا الأدبُ الروسيُّ الذي أسرَني، فكانَ في وادٍ آخر. إنهُ لم يُسخَّرْ لخدمةِ “دولةٍ” أو “نظام”، بل سُخِّرَ لخدمةِ “الإنسانِ” في كُلِّ زمانٍ ومكان. لم يكنْ بطلُهُ خارقاً يرتدي عباءةً ملوّنة، بل كان إنساناً مُعذَّباً، ممزقاً بين الشكِّ واليقين، يبحثُ عن معنى وجودِهِ في قلبِ العدَم. لم يُجَمِّلوا الواقعَ أكثر من كونهم شرّحوه. لم يهربوا من السؤال بقدر ما تعمقوا فيه وناقشوا مختلف الإجابات عليه. لهذا، حين نقرأُ لهم، لا نرى “أمريكا” أو “روسيا” تلوّحُ بأعلامِها، بل نرى “أنفُسَنا” عاريةً في مرآةِ الحقيقة. وذلك، لَعَمري، هو سرُّ خلودِهم واختلافِهم.
لقد ترفَّعَ عن أن يكون مجرّد “أدبِ مُناسبات” أو “صوتٍ للسلطة”. لقد كانت قِبلَتُه الوحيدة، ومَدارُه الأوحد: الإنسان. تغنّى به في ضعفه وقوته، في سُقوطه ونُهوضه، وفي تلك التقلّباتِ الداخليةِ العاصفة التي تَعتلجُ في صدره. لقد غاصَ في أعمقِ أغوار النفس، حيثُ لا يجرؤ كثيرون على النظر. ولأنَّ تشريحَ الروحِ لا يقبلُ الاختزال، ولأنَّ رَسْمَ ملامحِ “الإنسان الباطن” يحتاجُ إلى مساحاتٍ شاسعة، جاءت ملاحمُهم ضخاماً؛ فامتدَّت الروايةُ الواحدةُ لتشغلَ مُجلداً كاملاً لربما بألف صفحة.
هذا الإسهابُ رآهُ أحدُ النُقّاد الإنجليز، بعينِ العَجَلَةِ الباردة، “جريمةً بالغةَ الخطورة” في حقِّ الاقتصادِ الأدبي! بَيْدَ أنَّ القارئَ الذي يشرعُ في رحلته مع أولئك العمالقة سواءٌ كان تولستوي في اتساعِ أفُقِه، أو دوستويفسكي في غوصهِ المُعذَّب، أو تشيخوف في رقَّتِهِ الحزينة، أو غوركي في مَرارةِ واقعِهِ يُدركُ سِرَّاً آخر. فما إن تفتحَ الصفحةَ الأولى، حتى تُسْلَبَ منكَ أزمّةُ الوقت، وينفصلَ الحاضرُ عنكَ. تمضي بكَ الصفحاتُ، مئةً تلوَ مئة، حتى تبلغَ الألفَ صفحةٍ، تزيدُ أو تنقص، ولا تشعرُ بِكَرِّ الساعات؛ لأنكَ لم تكن “تقرأ” فحسب، بل كنتَ “تعيشُ” حياةً أخرى، في كونٍ أشدَّ اتساعاً من كونكَ المحدود.
الحَقُّ أقول ياعزيزي، إنَّ مقاربَتي للروايةِ تختلفُ عن سائرِ فُنونِ القراءةِ؛ وهي نصيحتي الخالصةُ إليكَ اليومَ يا عزيزي. إنَّني حينَ أُفْضي إلى الروايةِ، وبخاصةٍ تلكَ الروسيّةِ، لا ألتهمُ صفحاتِها التهاباً، ولا أجري في ميدانِها جريَ اللاهثِ خلفَ نهايةٍ. بل أَتَمَهَّلُ، وأُعطيها منّي صَفْوَ الوقتِ ولُبَابَهُ. ذلكَ أنَّ القراءةَ العابرةَ ليست هي الغايةَ التي أبتغيها، ولا مُنتهى ما أرتجيهِ منها. ما هيَ في عُرفي إلا “عَتَبَةٌ” أَلِجُ منها إلى ما هو أعمقُ وأخطر، إلى ما وراءَ السُّطورِ.
فملاذي أن أقتنصَ الشواردَ وأُقيِّدَ الخواطرَ على هوامشِ الصُّحُفِ، بل وفي دفتر خاص أيضاً، كأنني أخطُّ خريطةً لبلادٍ بِكْرٍ لم تُطأْ أرضُها من قبل. أرصُدُ كلَّ التفاتةٍ نفسيةٍ، وكلَّ رمزٍ مُبطَّنٍ، وكلَّ دافعٍ خَفِيٍّ. وما إن أطوي الصفحةَ الأخيرةَ، حتى يكمُنَ الشَّوْطُ الأعظمُ.
أعودُ، فأفتحُ أولاها من جديد.
ولكن، لا أعودُ هذه المرَّةَ كقارئٍ يبحثُ عن مُتعةِ الحكايةِ، أو كمُستمْتِعٍ يبتغي لذَّةَ الحَدُّوتةِ. كلّا. بل أعودُ عَوْدَةَ “الجَرَّاحِ البَصيرِ”يقلِّبُ مِبضَعَهُ في طبقاتِ النفسِ الإنسانيةِ؛ أُشخِّصُ كلَّ عِلَّةٍ كيفَ بدأتْ، وأَتَتَبَّعُ مَسَارَها في الشرايينِ الخفيَّةِ للروحِ، لأرى إلى ماذا آلَتْ وكيفَ اسْتَحْكَمَتْ. لا أكتفي بالنظرِ إلى “الفِعْلِ” الظاهرِ، بل أبحثُ عن “الدَّافِعِ” القابعِ في أغمضِ الزوايا. أُفَتِّشُ عن تلكَ اللحظةِ الفارقةِ التي نَبَتَتْ فيها بذرةُ الشَّكِّ، أو استيقظَ فيها وَحْشُ الكِبْرِ، أو انطفأَ فيها قنديلُ الأملِ.
أغوصُ لأرى كيفَ أنَّ خَيْبَةً صغيرةً في مطلعِ العُمْرِ، قد أورثَتْ قسوةً في مُنْتَهَاهُ. وكيفَ أنَّ كذبةً بيضاءَ، غُذِّيَتْ بالخوفِ، آلَتْ إلى فاجعةٍ لا تُسْتَرَدُّ. إنني في هذه العودةِ، أقرأُ لأَفْهَمَ؛ لأرى الخيطَ الرفيعَ الذي يفصلُ بين القِدِّيسِ والشيطانِ داخلَ الإنسانِ الواحدِ، ولأُدرِكَ أنَّ تلكَ العِلَلَ التي أُشَرِّحُها فيهم، هي ذاتُها التي تَكْمُنُ فينا، تنتظرُ مَنْ يستثيرُها. أعودُ لأُشرِّحَ وأُحلِّل، سابراً أغوارَ تلكَ الشخصياتِ، مُسْتَنْطِقاً أسرارَها، باحثاً عن عِلَلِها الدفينةِ وجذورِ أفعالِها. أُفَكِّكُ بواعثَها الأدبيةَ والنفسيةَ، وأسألُ: لِمَ آثَرَ الكاتبُ هذا المسلَكَ دونَ ذاكَ؟ وما الذي يختبئُ خلفَ هذا الصمتِ أو ذاكَ الاندفاع؟ قراءةٌ لا تكتفي بِما “قِيلَ”، بل تنقِّبُ عمَّا “أُريدَ” أن يُقالَ.
والأمرُ الذي يُدهشني في كلِّ جولةٍ من هذا الغوص، هو أنني لا أجدُ “شخصياتٍ” مرسومةً بحبرٍ على ورق، بل أجدُ “أكواناً” قائمةً بذاتها؛ عوالمَ كاملةً تضطربُ في دواخلِ هؤلاء البشر، تضجُّ بالصراعِ، والشكِّ، والإيمان، والخطيئة، والبحثِ عن الخلاص. إن كلَّ شيءٍ في هذا الأدبِ ينمو، ويتبدّلُ، ويتقلّبُ في ذاتِ الإنسانِ بشكلٍ مَهُولٍ ومُخيف؛ حتى ليُخيَّلَ إليكَ أنكَ تقفُ على حافّةِ بركانٍ يوشكُ أن ينفجر.
لهذا، ما إن تُغلقَ الكتابَ وتعودَ إلى واقعِك، حتى تجدَ نفسَكَ تحسبُ لخطواتِكَ ألفَ حساب؛ فشدّةُ ما تراهُ في نفوسِ هؤلاء الأبطالِ المعذَّبين، يجعلكَ أشدَّ حذراً من نوازعِ نفسِكَ أنت، وأكثرَ تبصُّراً بتقلباتِ قلبِك. تُصبحُ كالسائرِ على حبلٍ دقيقٍ، تَرْقُبُ كلَّ ميلٍ في قلبِكَ، وكلَّ همسةٍ من هَوَىً خَفِيٍّ. إنَّكَ، إذْ رأيتَ بعينِ اليقينِ كيفَ تنهارُ الحُصونُ المنيعةُ من الداخلِ، تُصبِحُ أكثرَ تَبصُّراً بتقلُّباتِ فؤادِكَ وهشاشةِ إيمانِكَ.
بل والأخطرُ من ذلكَ كلِّهِ، أنكَ تُدرِكُ الحقيقةَ المُرَّةَ: تُدرِكُ كيفَ أنَّ أشنعَ أنواعِ الشرِّ، وأعتى صُورِ الطغيانِ، قد تبتدئُ بشيءٍ أتفهَ من التَّافِهِ؛ لربما بشرارةٍ ضئيلةٍ، أو بفكرةٍ عابرةٍ جداً كنتَ مازحاً بها في صدرِكَ، لم تُلْقِ لها بالاً. تلكَ الفكرةُ التي دَاعَبْتَها استخفافاً، قد تكونُ هي البذرةَ الأولى للشجرةِ الخبيثةِ. تَسْقيها الأيامُ بماءِ الغفلةِ، وتُغذِّيها الظروفُ بِسِمَادِ المصلحةِ، فإذا بها تستحيلُ وحشاً كاسراً، بعد أن كانتْ مُجرَّدَ “مِزاحٍ” بريءٍ في سَريرَتِكَ.
لقد رأيتُ، على سبيل المثال، في “راسكويلنكوف” (بطل الجريمة والعقاب)، كيفَ يمكنُ لـ “فكرةٍ” باردةٍ أن تُحوِّلَ شاباً ذكياً إلى قاتلٍ مُنظِّر، ورأيتُ كيفَ أصبحَ هذا القاتلُ في النهاية؛ كتلةً من الهذيانِ والحُمّى والندم، لا يجدُ طمأنينتَهُ إلا في الاعترافِ والسجودِ على قارعةِ الطريق، مُعلناً هزيمتَهُ أمامَ الضمير.
ورأيتُ حتى في شخصيةٍ مثل “إيفان كارامازوف”، كيفَ يمكنُ للعقلِ الجبّارِ أن يكونَ هو الجحيمَ بعينه؛ فرأيتُ صراعَهُ الفكريَّ حول “موتِ الإله” وكيفَ أن “كلَّ شيءٍ مباحٌ”، وكيفَ آلَ بهِ هذا العقلُ المتألِّهُ إلى الانهيارِ التامِّ ومُحاورةِ شيطانه. إنكَ أمامَ أدبٍ لا يُسلِّيك، بل يُربِّيكَ؛ لا يُنسيكَ همومَك، بل يغوصُ بكَ إلى “جذرِ” الهمِّ الإنسانيِّ نفسِه. حقّاً ياعزيزي إن هذا الأدبَ لَهُوَ ديوانٌ حافلٌ بغرائبِ النفسِ البشريةِ لا ينقضي. وإنْ نحنُ جاوزنا “راسكويلنكوف” و “إيفان كارامازوف”، مُيمِّمينَ شطرَ أعماقٍ أخرى، فإنَّ الغَوْرَ يزدادُ سُحقاً، واللُّجَّةَ تزدادُ عُمقاً:
فهذا “بيير بيزوخوف” لتولستوي. إنه “الساعي الأبديُّ خلفَ الجدوى” في أصفى تجلّياتِه. رجلٌ مترهِّلُ الجسدِ، مُضطربُ الخُطى، آتاهُ الميراثُ ثراءً فاحشاً، غيرَ أنهُ كانَ يحملُ في صدرهِ “فقراً مُدقِعاً”. لقد كانَ باطنُهُ مَيْداناً لوغىً أشدَّ هَوْلاً وضراوةً من “بورودينو” ذاتها.
رأيناهُ يتيهُ في دَهاليزِ الماسونيةِ مُلتمِساً “الحقيقة”، واهِماً أنها سِر يُلَقَّن؛ ثم يَهيمُ على وجههِ في قلبِ المَعرَكَةِ راغباً في اغتيالِ “نابليون”، كفعلٍ خلاصيٍّ يائس؛ ثم نلفيهِ أسيراً يتضوَّرُ جوعاً وقُرّاً. بَيْدَ أنَّ “عينَ اليقينِ” لم تُشرِقْ عليهِ من فوهةِ مِدفعٍ أو من الفلسفة، بل وجدها في “الفِطرةِ الأُولى”، في “البساطةِ المُطلقة”، مُتجسِّدةً في جنديٍّ بسيطٍ هو “بلاتون كاراتاييف”. لقد كانتْ سيرتُهُ رحلةَ العَوْدِ من “التكلُّفِ” الظاهرِ إلى “صفاءِ” الباطنِ، ومن “ثِقَلِ” الامتلاكِ إلى “خِفَّةِ” الزهدِ الروحي.
وعلى الضفّةِ الأخرى منه، يقفُ نِدُّهُ في الروايةِ ذاتها، “الأمير أندريه بولكونسكي”. ذاكَ هو “الكِبرياء المجروح. أرستقراطيٌّ مُرهَفُ الذكاء، حادُّ الطبعِ، قد تَجَرَّعَ عَلْقَمَ الخيبةِ في حياتهِ، وزوجهِ، ومجتمعه. لقد شَيَّدَ عالَمَهُ الباطنيَّ على “التَرَفُّعِ” و “ازدراءٍ” مُبطَّنٍ لكلِّ ما حولَه. وما انغماسُهُ في الحربِ إلا فِراراً من وجودهِ الباهتِ، باحثاً عن “مجدٍ” ذاتيٍّ يَنتشلُهُ من تَفاهةِ محيطِه. غيرَ أنَّ “التجلِّيَ الأعظمَ” أتاهُ وهو صريعٌ ينزفُ في ساحة “أوسترليتز”، شاخصاً ببصرهِ إلى “قُبَّةِ السماءِ الصافيةِ الأزلية”.
هُنالكَ، في تلكَ اللحظةِ الفاصلة فقط، أدركَ كم كانَ “نابليون” (مَثَلُهُ الأعلى) “ضئيلاً”، وكم كانَ مَجدُهُ الذي يَلهثُ خلفَهُ “سُخفاً”، إزاءَ ذلكَ “الخلودِ الصامتِ” المُطْبِقِ عليه. لقد كانتْ لحظةَ “انكشافٍ” و “تَـضاؤُلٍ” أعادَتْ صياغةَ وُجدانِهِ بأَسْرِه.
وهُنا “آنّا كارنينا”... إن مأساتَها لا تُختَزَلُ في “زَلَّةٍ” زوجيةٍ سريعة، بل هي “ملحمةُ الروحِ المُتَوَهِّجَةِ” في مُصادَمَتِها لـ “واقعٍ مُجتمعيٍّ مُحنَّط”. إنَّ باطنَ “آنّا” هو صرخةُ حياةٍ مُدوِّية؛ رُوحٌ تَأبى أن تَقبَعَ في عالمِ “الرِّياءِ” المُقنَّعِ والأعرافِ الباردةِ الذي يُجسِّدُهُ زوجُها “كارينين” ذلكَ “الرجلُ الآلة”.
لهذا، لم تَرَ في “فرونسكي” مُجرَّدَ “عشيق”، بل رأتْ فيهِ “النَّبضَ” الذي سُلِبَتْهُ. بَيْدَ أنَّ ثَمَنَ هذا “الاختيارِ الحُرِّ” كانَ باهظاً؛ لقد كلَّفها “كلَّ شيء”. والأمرُ المُرعِبُ حقاً، هو أنْ نَرصدَ كيفَ استحَالَ هذا “الحبُّ الخلاصُ” في داخلِها، تحتَ مطرقةِ النبذِ والغيرةِ والقنوط، إلى “قَيْدٍ” أشدَّ فتكاً وكيفَ أخذتْ روحُها تَنخُرُها الظُّنونُ وتتآكلُ من فرطِ اليأسِ، حتى لم تَرَ مَنجاةً إلا في الفناءِ المُحتَّمِ تحتَ عجلاتِ القطار. إنها تُرينا كيفَ يغدو “المجتمعُ” سَيّافاً، يقتصُّ من “الروحِ” أولاً، قبلَ أن يُجهِزَ على “الجسد”.
وإذا ما طَوَيْنا صَفْحَةَ الملاحمِ الكُبرى لتولستوي ودوستويفسكي، وأتينا إلى “أنطون تشيخوف”، ألفَيْنا عالَماً داخلياً ذا طابعٍ مُغاير. إنَّ أبطالَ تشيخوف ليسوا أصحابَ “أفعالٍ” مُدوِّيةٍ أو “خطايا” كُبرى كأبطالِ دوستويفسكي، بل هُمْ أبطالُ “العَجْزِ الأنيقِ” و “الشَّلَلِ الباطنيِّ”. وها هو “الخال فانيا”؛ أفنى عُمرَهُ يكدحُ ويُضحّي من أجلِ بروفيسورٍ تبيَّنَ في خريفِ العُمرِ أنهُ لم يكنْ إلا “صَنَماً” أجوفَ، “خُدعةً” كبيرة. إنَّ عالَمَهُ الداخليَّ هو مأساةُ “العُمرِ المَسفوكِ” هَدَراً. إنهم أُناسٌ يَعِجُّونَ بالأحلامِ التي وَأَدَها الزَّمَن، وبالحُبِّ الذي لم يُبَحْ به، وبقُنوطٍ هادئٍ كصقيعِ الشتاء. إنَّ فاجعتَهُم ليستْ في “ما وَقَع”، بل في “ما لم يَقَعْ” أبداً. إنهم يَكشفونَ لنا عن “العذابِ البطيءِ” للترقُّبِ، وعن ذلكَ “التأرجُحِ” القاتلِ بينَ بَصيصِ الأملِ الخافتِ وبينَ “الاستسلامِ المُرِّ” للواقعِ الرتيب.
إنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاءِ ليست “شخصيةً” روائيةً فحسب، بل هو “قضيّةٌ” إنسانيةٌ قائمةُ الأركان، وعالَمٌ مُتكاملٌ بذاتهِ، لا يَستحقونَ مِنّا “القراءةَ” السريعة، بل “الوقوفَ” المُطوَّلَ عندَهُم، وقفةَ المُشرِّحِ الذي يُفكِّكُ ويُحلِّل، والتْحلِيل لهُ مُتعة اكبُر مِن القِراءَة.
ومن هذا المُنطَلَقِ بالذات، نُدركُ أن “الإسلامَ” لم “يَتَغَنَّ” بالنفسِ الإنسانيةِ فحسب فالتغنّي قد يكونُ مَدحاً مُطلَقاً لشيءٍ مُكتَمِل بل هو قد جعلَ من هذه “النفسِ” المِحورَ الأوحدَ الذي تدورُ عليهِ رحى الرسالةِ كلِّها. إنَّ الأدبَ الروسيَّ، كما أسلفنا، كانَ “يُشَرِّحُ” هذه النفسَ ويكشفُ عن أسرارِها، أما الإسلامُ، فقد جاءَ “لِيُهذِّبَها” و “يُزكِّيها” ويَرسمَ لها طريقَ النجاة. ولهذا، فإنَّ مُطالعةَ هذا الضربِ من الأدبِ، يا عزيزي، ليستْ دَأْبَ كلِّ قارئٍ عابرٍ، بل هي مَسْلَكٌ يقتضي “حُنْكَةَ” الخبيرِ وبصيرة العارف، لِتَفْتَحَ لكَ باباً أوسعَ وأعمقَ من مُجرَّدِ المتعةِ السرديّةِ؛ باباً يُفضي إلى “المُقارَنَةِ” و “الاستبصارِ”.
فَبِهَذِهِ الحُنْكَةِ، أنتَ لا تقرأُ حكايةً، بل “تَشْهَدُ”. تَشْهَدُ النفسَ البشريةَ عاريةً في أوجِ صراعِها، وترى تناقضاتِها وهي تُمَزِّقُ أصحابَها. تَرى “الداءَ” وقد اسْتَحْكَمَ، والروحَ وهي تَتَلَوَّى في ظُلُماتِ الشكِّ، أو تَغْرَقُ في وَحْلِ الخطيئةِ، أو تضيعُ في تِيهِ العَدَميَّةِ. ولكنَّكَ، بِما تَحْمِلُهُ في صدرِكَ من نورِ الإسلامِ، لا تقفُ عندَ حدودِ “التشخيصِ” البارعِ الذي قدَّمَهُ الكاتبُ، حائراً مُنْفَعِلاً. بل تتجاوزُهُ إلى “العلاجِ”.
أنتَ تَرى “الداءَ” في صفحاتِهم، وتَعْرِفُ أنتَ “الدواءَ” في ضوءِ شريعتِكَ. تَرى كيفَ يَتخبَّطُ الإنسانُ حينَ يغيبُ عنهُ اليقينُ، وتُدركُ أنتَ قيمةَ “الحَبْلِ المتينِ” الذي بَيْنَ يَدَيْكَ. تَرى كيفَ تُدَمِّرُهُمُ الأهواءُ، وتَعْلَمُ أنتَ كيفَ يُهَذِّبُها الإيمانُ. إنها لَعَمْرِي مُتعةٌ مُضاعَفَةٌ، وفائدةٌ لا تُقَدَّرُ: مُتعةُ فَهْمِ العِلَّةِ في الأدبِ، ومُتعةُ إدراكِ النجاةِ منها في الدِّينِ.
لم يكنْ همُّ الإسلامِ الأولُ تنظيمَ الظاهرِ بقدرِ ما كانَ إقامةَ ثورةٍ في الباطنِ. إنَّ النفسَ في المنظورِ الإسلاميِّ هي ساحةُ المعركةِ الحقيقية، وهي “مَيدانُ الاختبارِ والابتلاء، وهي مَوضوعُ التقويمِ والإصلاح. لقد فصَّلَ القرآنُ الكريمُ أحوالَها وتَقلُّباتها فصلاً بديعاً، فجعلها درجات ومَراتب:
فهي “النفسُ الأَمَّارةُ بالسوء”؛ وذلكَ حينَ يطغى “الهوى” وتُظلِمُ البصيرة، (وهذا هو “راسكويلنكوف” قبلَ جريمته، أو “آنّا كارنينا” في ذروةِ اندفاعِها نحو رغبتِها المُدمِّرة).
في “الحبِّ” كـ هوىً مُدمِّر: إن نظرت الى شخصيةَ “روغوجين” في رواية “الأبله” لدوستويفسكي. إن “حبَّهُ” لـ “ناستاسيا فيليبوفنا” هو “النفسُ الأمَّارةُ” في أقوى صُوَرِها: “شهوةُ التملُّكِ” الخالصة. إنهُ حُبٌّ لا يَحتملُ “الآخَرَ”، بل يريدُ ابتلاعَهُ. ولأنَّ “الهوى” إذا مَلَكَ لا يرى إلا ذاتَه، فإنهُ لا يتردَّدُ في نهايةِ المطافِ في “قتلِ” مَحبوبَتِه. لماذا ياعزيزي؟ لأنَّ “النفسَ الأمَّارةَ” تُفضِّلُ “فَناءَ” الشيءِ على “فُقدانِه”. إنهُ “الهوى” الذي حذَّرَ منهُ القرآنُ (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ).
في “الكِبرِ” كـ “فِكرَة”: وانظُرْ إلى “ستافروغين” في رواية “الشياطين”. هذا نموذجٌ أخطرُ لـ “الأمَّارة”. إنها ليستْ “شهوةَ الجسدِ” بل “شهوةُ العقلِ” و “الكِبرُ الفكريُّ”. “ستافروغين” هو الإنسانُ الذي أرادَ أن يتجاوزَ “الخيرَ والشرَّ” ليُثبتَ لنفسهِ أنهُ “إلهٌ” مُكتفٍ بذاتِه. فكانتْ نفسُهُ “تأمُرُهُ” بارتكابِ أفعالٍ شائنةٍ لا لِمُتعةٍ فيها، بل لمجرَّدِ “تحدِّي” القانونِ الأخلاقيِّ وإثباتِ “تفرُّدِهِ”. إنها “النفسُ الأمَّارةُ” حينَ تَرتدي رِداءَ “العدميَّةِ” أو ما يُعرف بـ(Nihilism).
وهي “النفسُ اللَّوَّامة”؛ وذلكَ هو “الضميرُ” حينَ يستيقظُ، وهي لحظةُ “الألَمِ” و “الندمِ” و “المُحاسبةِ” (وهذا هو جحيمُ دوستويفسكي بِعَينِه، وتلكَ هي اللحظةُ التي بدأَ فيها “بيير بيزوخوف” رحلةَ البحثِ عن ذاتِه).
وهي الغايةُ المَرجُوَّة: “النفسُ المُطمئنَّة”؛ الراضيةُ المَرضيَّةُ التي وجدتْ سكينَتَها ويقينَها.
هي “الضميرُ” وقد استيقظَ، وهي “مَيدانُ المعركةِ” الحقيقيُّ بينَ “الفجورِ” و “التقوى” (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا).
في “التيهِ الفكريِّ”: أُنظر معي لشخصيةَ “ليفـيـن” في رواية “آنّا كارنينا” لتولستوي. هذا الرجلُ ليسَ مجرماً كراسكويلنكوف، بل هو يمتلكُ كلَّ شيءٍ: الثروةَ، والأسرةَ، والمكانة. ومعَ ذلك، فإن “نفسَهُ اللوَّامةَ” تُعذِّبُهُ بلا هوادة. لِمَ؟ لأنها تلومُهُ على “فراغِ المعنى”. إنَّ “ليفـيـن” هو تجسيدٌ حيٌّ لـ “النفسِ اللوَّامةِ” الباحثةِ عن “اليقينِ”. لقد بلغَ بهِ “اللَّوْمُ” الداخليُّ درجةً جعلتهُ “يُخبِّئُ الحبلَ” عن عينيهِ لئلا يَشنقَ نفسَهُ، ويُخفي بندقيتَهُ لئلا يُطلِقَ النارَ على رأسهِ. إنهُ “العذابُ الفكريُّ” للضميرِ الذي يَرفضُ أن يعيشَ بلا إجابةٍ عن سؤالِ “لماذا؟”.
في “التطهيرِ بالألمِ”: وهنا يبرزُ “ديمتري كارامازوف” (الأخ الأكبر في الإخوة كارامازوف). لقد عاشَ حياتَهُ مُنصاعاً لـ “نفسِهِ الأمَّارة” (شهوانياً، مُندفعاً، عنيفاً). ولكنْ، حينَ يُتَّهَمُ ظلماً بقتلِ أبيهِ، تستيقظُ “نفسُهُ اللوَّامةُ” بقوّةٍ هائلة. إنهُ “يَقبلُ” العقابَ عن جريمةٍ لم يَرتكبْها، لماذا؟ لأنَّ “نفسَهُ اللوَّامةَ” تقولُ له: “أنتَ تستحقُّ هذا العذابَ، ليسَ لأنكَ قتلتَ أباكَ فقط، بل لأنكَ “أردتَ” أن تقتُلَه، ولأنكَ عشتَ حياةً دنيئةً”. إنهُ “الألَمُ” الذي يراهُ دوستويفسكي سبيلاً لـ “التطهيرِ” (الذي يُوازي “التوبةَ النصوحَ” و “الكفَّارةَ” في المنظورِ الإسلاميِّ).
هي النفسُ التي وَجدتْ “سَكَنَها” ويقينَها، لا في “الفلسفةِ” المُعقَّدةِ أو “الثروةِ”، بل في “التسليمِ” و “البساطةِ” و “الحبِّ الخالص”. في “اليقينِ بالفِطرة”مثلاً، أُنظُر ياعزيزي الى “سونيا مارميلادوفا” في “الجريمة والعقاب”. رغمَ أنها دُنِّسَتْ في “ظاهرِها” (بسببِ الفقرِ المدقع)، فإن “باطِنَها” كانَ مَقرّاً لـ “النفسِ المُطمئنَّةِ” في أسمى صورِها. إنها “المُوقِنَةُ” التي لم يتطرّقِ الشكُّ إلى قلبِها لحظة. إنها “المُطمئنَّةُ” التي مَنَحَتْ “اللوَّامَ” (راسكويلنكوف) طريقَ النجاةِ الوحيد: “الاعترافَ” و “الإيمانَ”. إنها تُمثِّلُ “الفِطرةَ” التي تَغلِبُ “الفلسفةَ” المُلتوية.
في “السكينةِ بالتسليمِ”: وهي “بلاتون كاراتاييف” في “الحرب والسلم”. ذلكَ الجنديُّ الفلّاحُ البسيطُ الذي التَقاهُ “بيير بيزوخوف” (الباحثُ القَلِقُ) في الأَسْر. “بلاتون” لا يمتلكُ شيئاً، لا يفهمُ في الفلسفة، لكنهُ يمتلكُ “كلَّ شيءٍ” لأنهُ “راضٍ” و “مُسلِّمٌ” لإرادةِ الله. إنهُ “النفسُ المُطمئنَّةُ” في صورتِها الفِطريةِ الأُولى، التي وَجَدَ عندَها “بيير” (صاحبُ النفسِ اللوَّامةِ) ضالَّتَهُ التي عَجَزَتْ عنها كُتُبُ الماسونيةِ وثروتُهُ الطائلة.
حتى الحُبُّ، تلكَ الطبيعةُ البشريةُ اللصيقةُ، لم يَشَاؤوا لَهُ أن يكونَ مُجَرَّدَ قِصَصِ غرامٍ تُطْوَى مع آخرِ سطرٍ. لم تكنْ غايتُهُم أن يصفوا لَهفَةَ اللقاءِ أو مَرَارةَ الفِراقِ فحسب؛ فذلكَ ما يَسْتَطِيعُهُ الكَثِيرُونَ. بل جَعَلُوا مِنَ الحُبِّ نَفْسِهِ “مَيْدَانَ صِراعٍ” تُخْتَبَرُ فيهِ أعمقُ قناعاتِ الإنسانِ. الحُبُّ في أدَبِهِم ليسَ مُتنفَّساً مِنَ الحياةِ، بل هو الحياةُ ذاتُها في أَقْسَى صُوَرِها. إنَّهُ المِحَنَةُ التي تَصْهَرُ مَعْدِنَ الروحِ؛ هو الابتلاءُ الذي يَكْشِفُ كُلَّ زيفٍ. لا يأتي الحُبُّ لِيُريحَ الأبطالَ، بل لِيَزيدَهُمْ شَقاءً وتَساؤلاً. يأتيهِمُ الحُبُّ مَقروناً بالألَمِ، مَمْزُوجاً بالتضحيةِ، مُعَمَّداً بالدموعِ واليأسِ فترى أن المسألة ليستِ قصةَ “لِقاءٍ” بينَ قلبَيْنِ، بل قصةَ “اصطدامٍ” بينَ عالَمَيْنِ. لقد سَألوا: “ما الذي سيصْنَعُهُ هذا الحُبُّ منهُما؟ وكيفَ سيُعيدُ تشكيلَ إيمانِهِما أو كُفْرِهِما؟” أكثرَ مِمَّا سَألوا: “هل سَيَجْتَمِعانِ؟”.فغَدَا الحُبُّ عِنْدَهُمْ مِبْضَعاً آخرَ، كالمعاناةِ تماماً، يُشَرِّحونَ بهِ كِبْرِياءَ النفسِ، وأَنَانِيَّتَها، وقُدْرَتَها الفائقةَ على الفداءِ أو على الخيانةِ.
وهذا ما نراه ايضاً في الإسلام، فمثلاً، كلمةَ “شَغَفَها” في قوله تعالى {قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا} في القرآنِ هي وصفٌ مُذهلٌ. “الشَّغافُ” هو غِلافُ القلبِ (التامور). فالمعنى ليسَ “أحبَّتهُ” حُبّاً عادياً، بل إنَّ هذا الحُبَّ قد “خرقَ” الغلافَ الواقيَ للقلبِ، والْتَصَقَ بهِ، وسَيْطَرَ عليهِ سيطرةً كاملة. هذا هو “الهوى” الذي أصبحَ هو “الآمرَ الناهيَ”. إنها من جديد “النفسُ الأمَّارةُ” وقد اتخذتْ هذه المرة “الحُبَّ” قِناعاً لها.
المثالُ الأبرز في الرواية الروسية هو في “آنّا كارنينا” مُجدَّداً. إنَّ ما حدثَ لـ “آنّا” مع “فرونسكي” هو “شَغَفٌ” بكلِّ ما تحمِلُهُ الكلمةُ من معنى. لقد “شَغَفَها حُبُّهُ”. لأن هذا الحُبُّ لم يكنْ خياراً عقلانياً، بل كانَ “قوّةً قاهرةً” (كما وَصَفَتْها هي) اخترقتْ “شغافَ” قلبِها. ولهذا، “أَمَرَتْها” نفسُها بالتخلّي عن كُلِّ شيءٍ في مرة: عن ابنِها، وعن زوجِها، وعن مكانتِها الاجتماعية، بل وعن “اتِّزانِها” النفسيِّ. لقد أصبَحَ هذا “الشغفُ” هو “صاحبَ الأمرِ”، وكانتْ هي “المأمورةَ”. وحينَ بَدأَ هذا “الشغفُ” يَخفُتُ من جِهَةِ “فرونسكي” (أو هكذا ظنَّتْ هي)، لم تَجِدِ “النفسُ الأمَّارةُ” التي قادَتْها إلى الذروةِ إلا أنْ “تأمُرَها” بالهلاكِ المُحتَّم.
“ديمتري كارامازوف” و “غروشينكا”: إنهُ “شَغَفٌ” من نوعٍ آخر؛ “شغفٌ” حِسِّيٌّ، شهوانيٌّ، ناريّ. لقد اعترفَ “ديمتري” أنهُ “عَبْدٌ” لهذه الرغبة. لقد “شغفَتْهُ” هذه المرأةُ حُبّاً، فكانتْ نفسُهُ “تأمُرُهُ” بالذلِّ، وبالعنفِ، وبمحاولةِ سرقةِ أبيه، بل وبـ “قَبولِ” فكرةِ قَتْلِه. لقد كانَ “شغفُهُ” هو “النفسَ الأمَّارةَ” التي كادَتْ تُرديهِ قتيلاً.
وترى ياعزيزي في موضع آخر في قوله تعالى {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا} وهي لحظةُ الهَمِّ الفاصلة. هذهِ الآيةُ تَصِفُ “المعركةَ” في ذروتِها. إنها “لحظةُ” التقاءِ “النفسِ الأمَّارةِ” بـ “النفسِ اللوَّامةِ” (أو الفِطرةِ الإيمانية).
“الهَمُّ” هو “المَيْلُ” الداخليُّ، هو “الانجذابُ” البشريُّ الطبيعيُّ الذي تُثيرُهُ “النفسُ الأمَّارةُ”. لقد “هَمَّتْ بِهِ” (هي)، لأنَّ “نفسَها الأمَّارةَ” كانتْ هي الغالبةَ والمُسيطرةَ (”قد شغفها حباً”). “وَهَمَّ بِهَا” (هو)، لأنَّ “النفسَ البشريةَ” لا بُدَّ أن “تَميلَ” (”الهَمُّ” كخاطرٍ بشريّ).
ولكنْ، ما الذي حَدَثَ؟ الآيةُ تُكمِل: “لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ”.
هُنا ياعزيزي “المِفصَلُ” كلُّه. سيدُنا يوسفُ عليه السلام “رأى البرهانَ”، فانتصرتْ “النفسُ المُطمئنَّةُ” أو اللوَّامةُ بقوّةِ الإيمان على “هَمِّ” النفسِ الأمَّارةِ. لقد “كَفَّ” و “انصرفَ”. إنَّ تراجيديا الأدبِ الروسيِّ كلِّها تَكمُنُ في أنَّ أبطالَهُ “يَهُمُّونَ” ولكنَّهُم “لا يَرَوْنَ البُرهانَ” في تلكَ اللحظةِ الحاسمة. “فرونسكي” (في آنّا كارنينا): لقد “هَمَّ بِها”. حينَ رآها في محطّةِ القطارِ أولَ مرّة، شعرَ بذلكَ “الهَمِّ” الجارفِ. لكنَّهُ، بدلاً من أن يرى “بُرهانَ ربِّهِ” (بُرهانَ العقلِ، بُرهانَ الأخلاقِ، بُرهانَ كونِها مُحصَنَة)، اتَّبَعَ “هَمَّهُ” حتى النهاية، فكانَ “هَلاكُهُ” النفسيُّ (وإنْ عاشَ) وهَلاكُها.
“راسكويلنكوف” (في الجريمة والعقاب): لقد “هَمَّ” بالجريمة. تردَّدَ طويلاً (النفسُ اللوَّامةُ كانتْ تُقاوم)، لكنَّ “نفسَهُ الأمَّارةَ” (المُتَمثِّلةَ في “فِكرَتِهِ” الشيطانية) انتصرتْ في النهاية. لقد “هَمَّ” وفَعَلَ، لأنهُ في تلكَ اللحظةِ “حَجَبَ” عن عينيهِ “بُرهانَ ربِّهِ”.
“روغوجين” (في الأبله): لقد “هَمَّ” بقتلِ “ناستاسيا” مراراً. وفي كلِّ مرّةٍ كانَ “هَمُّهُ” يَتَغلَّبُ على أيِّ “بُرهانٍ” للعقلِ أو الحبِّ، حتى فَعَلَها.
القرآنُ الكريمُ يُقدِّمُ لنا “التشخيصَ” (”شغفها حباً”) و “المعركةَ” (”همَّ بها”) و “طريقَ النجاةِ” (”لولا أن رأى برهان ربه”). الأدبُ الروسيُّ يأخذُنا في رحلةٍ مُفصَّلةٍ ليُريَنا ماذا يَحدُثُ للإنسانِ حينَ يَستسلمُ لـ “الشغفِ” (النفس الأمَّارة)، وحينَ “يَهُمُّ” بالشيءِ، ولكنهُ “يَفشَلُ” في رؤيةِ “البُرهانِ” في اللحظةِ المناسبة. إن الأدبَ الروسيَّ، في أصفى تجلّياتِهِ، هو سِفْرٌ طويلٌ يُصوِّرُ رحلةَ “النفسِ” من “طُغيانِ الأمَّارةِ”، مروراً بـ “أتونِ اللوَّامةِ”، وُصولاً إلى “بَرْدِ المُطمئنَّةِ” وسلامِها.
إنَّ “جهادَ النفسِ”، ومُغالبةَ “الهوى”، ورصدَ “خواطِرِ القلبِ”، وكشفَ “مكائدِ الشيطان” في الدواخل كلُّ هذا الذي هو “لُبُّ” السلوكِ الإيمانيِّ وغايةُ “التزكيةِ” أليسَ هو ذاتُهُ “المعتركُ الداخليُّ” الذي دارتْ فيهِ رَحى الملاحمِ الروسيةِ الكبرى؟ لقد كانَ الأدبُ الروسيُّ العظيمُ بَرَاَعةً فذّةً في “تشخيصِ الداءِ” وتصويرِ “جحيمِ السقوطِ” و “عذاباتِ الضمير”. أمّا الإسلامُ، فقد جاءَ ليُضيءَ “طريقَ الصُّعودِ”؛ جاءَ “بالدواءِ”، مُقدِّماً “مَنْهَجاً” دقيقاً لترويضِ هذا “الكيانِ” الهائلِ المُتقلِّبِ الكامِنِ في دواخلِنا، وهو ذاتُهُ الكيانُ الذي أمضى عمالقةُ الروسِ حياتَهُم في مُحاولةِ فكِّ طلاسِمِه ورسمِ ملامِحِه.
يُمكنك كتابعتنا على قناة اليوتيوب بعنوان من هنا:








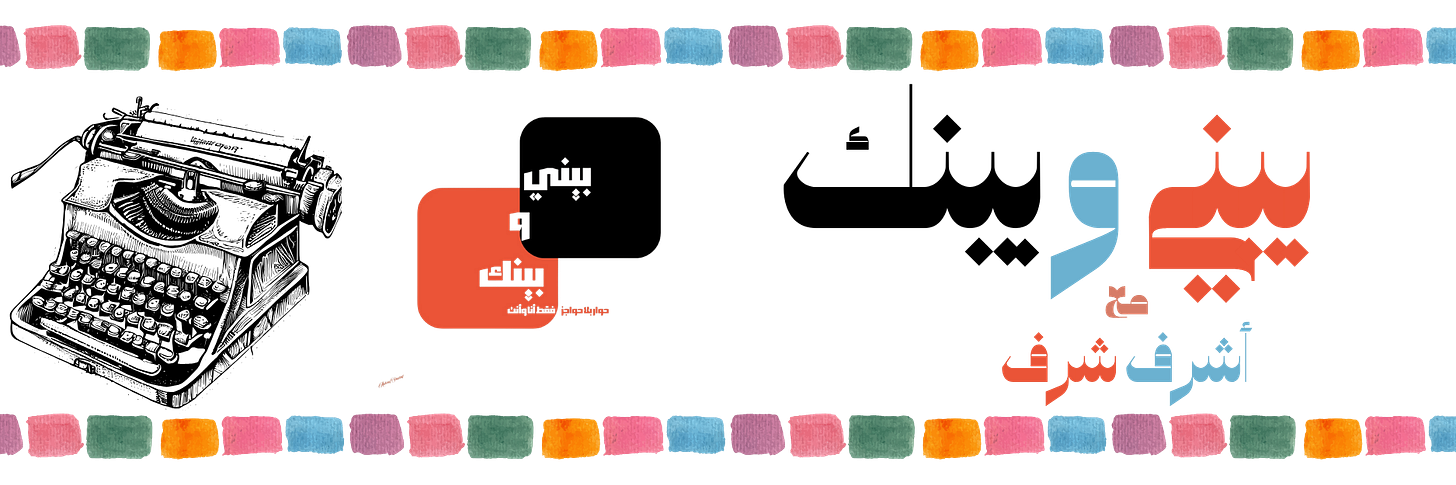
مذهل فعليا
آفاق جديدة لم افكر بها من قبل
كُنت دومًا أرى نفسي في الكتب الروسية، ولا أعلم لمِّا، حتى انني عندما كُنت اقرأ لكُتب دستويفسكي كنت أشعر فعلاً ان هنالك ترابط ما بين الادب الروسي والاسلام - حتى ان الكتب الروسيه وفلسفتها هي الفلسفه الوحيدة التي أقراها، كنت أعلم ان تفكيرهم حقيقي وغير متطرف-. فعلاً شكرًا لك على هذا المقال الرائع، لم اقرأ مؤخرًا مقالاً بروعته.