الموظف المثالي
رسالة إلى مهني العصر
في صميم أزماتنا الحالية، تبرز ظاهرة مقلقة، وهي القطيعة الموهومة بأن جودة الأداء الوظيفي تشترط إنسلاخ الحس الإنساني. لقد رسخ في عقول كثرة في يومنا الحالي أن “المهنية” و “الإنسانية” ضرتان لا تجتمعان. هذا الفهم القاصر هو الذي صََّيرَ “الاحتراف” في عيون البعض مرادفاً للتجرد من المشاعر، والتحصن خلف أسوار البنود القانونية. فبات الموظف المثالي في نظرهم هو من يتقن لغة العقود وليس لغة التعاطف، ومن يبرع في صياغة “إخلاء المسؤولية” قبل أن يبرع في إنجاز العمل.
إن لهذا السلوك آثارا نفسية وخيمة، فهو لا يكبل الأمة عن المسير قدماً نحو التقدم والرقي فحسب، بل يردها إلى غياهب التخلف والرجعية. تغدو المجتمعات بهذ الشكل حينئذ كأنما هي مسرح هائل، يتنافس فيه الممثلون بدلاً من العاملون. يتقمص كل امرئ دوراً لا يحسنه، ويتظاهر بإتقانٍ يفتقر إليه. ذاك يدعي خبرة تضاهي تجارب الدهور، ويزعم علماً تضيق عن حصره المجلدات، والآخر يتشدق بمعرفة بالقوانين والأصول وهو أجهل الناس بها. وتراهم في كل مجلس يخوضون في شؤون الإدارة ومقاصد العمل، ويطلقون الأحكام كأنما بيد كل واحد منهم مقاليد الأمور، وكأنهم جميعا رؤساء تنفذ لهم الأوامر.
كما عهدتني ياعزيزي من قبل فإنني أُحب أن تسأل وتتسائل دوماً، وأعرف أنك تسأل عن نقطة في غاية الاهمية ألا وهي وماذا لو غدا الادعاء هو العملة السائدة، وصار الحديث عن العقود والمهام هو الغاية لا الوسيلة؟ إن الجواب ببساطة، هو الجمود التام. لن نبرح مكاننا قيد أنملة. سترى الأمة، كما هي اليوم بالمناسبة، في تهافت محموم على القشور دون اللباب. يتسابق الناس إلى “الشهادات” كأنها غايات في ذاتها، ليس برهان على علم محصل. يغدون كمن يجمع الأختام في دفتره، ويظن أنه قد حاز ملكات الأرض. لذلك ترى الكل يسأل قبل أي شيء هل هناك شهادة حضور او شهادة إكمال؟ فترى أن الإنسان قد يضيع على نفسه كثير من العلوم لأنه لن يتحصل مع شهادة ليثبت لغيره أنها “يعرف”، فتراه قد سجل في كل دورة وندوة، ثم لا يلبث أن ينشر في الملأ أنه قد أتم وحصل، ويفيض حمداً وسعادة بتلك “الإسطوانة” التي ألفناها جميعا، والتي لم تعد تُطرب أحداً.
وهنا تبرز التساؤلات الحقيقية التي أشرت إليها، هل كان الذهن حاضرا في تلك المجالس، أم كان الجسد وحده هناك؟ أكانت الحاجة إلى ذلك العلم ملحة وضرورية، أم كان الدافع مجرد إثبات للآخرين، ورغبة في الظهور بمظهر الملم بكل شاردة وواردة؟ والسؤال الأعمق هو هل تخلى المرء عن دوره الأسمى كـ “مفكر” يحلل وينقد ويبدع، ليكتفي بدور “المحصل” الذي يجمع الركام والشهادات من كل صوب، دون أن يدرك قيمة ما جمع؟ إنه الفرق بين من يبني عقله، ومن يملأ مخزنه. الأول يرتفع، والثاني يبقى مثقلاً بما حمل.
وهكذا، يضيع الجهد الحقيقي وسط ضوضاء الادعاء، ويخبو نور الإبداع تحت ركام الزيف. إنها بلا شك ياعزيزي مسرحية تستهلك طاقات الأمة في تمثيل متقن، بينما تنهار أعمدة البناء الحقيقي، لأن الأساس ليس سوى وهم، والجمهور ليس سوى الممثلين أنفسهم، فلا يرى الخلل أحد حتى يقع السقف على الجميع. إنه الداء النفسي الذي يستشري ليصبح علة اجتماعية تهدم الكيان قبل أن يبنى. وإنني لأكره أن أقول هذا، ولكن من مرارة ما نراه اليوم، أننا بلغنا زمنا اختزلت فيه مهن بأكملها في “كوب قهوة”. نعم ياعزيزي، لقد أصبحنا نرى أناسا يندفعون إلى تخصص كامل، ويقضون فيه زهرة أعمارهم، وللأسف ليس لأن لديهم شغف بهذا العلم، إلا لأنهم رأوا من يزاولون هذه المهنة في تلك المسلسلات الوافدة، يحملون أكواب قهوتهم في منظر لائق وهيئة أنيقة. وإن هذا، لعمر الحق، ليجعل المرء في مصاف الحمقى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أجل، هو الغباء المطبق. وهي كلمة كنت ولا أزال أرددها على مسامع الدهر، إن الغباء أشد فتكا بالإنسان من أعتى المفسدين وأكثرهم شرا. فالمفسد قد يرتدع بقانون، أو يزجره وازع من ضمير، أما الغباء فلا دين له ولا ملة، ولا يعرف له حداً يقف عنده؛ إنه الهدم في صورته الخالصة. ويا لله! أيبلغ السخف بالعقل البشري هذا المبلغ؟
أأصبح كوب من القهوة هو ما يبهرك، وهو ما يحدد مسار حياتك بأكملها! ولكننا لا نزال عالقين في قلب تلك المسرحية العبثية، مسرحية المهنية حيث يرتدي الكل فيها قناع الخبير الجهبذ بشؤون الأعمال، ويتقمص دور العالم الذي لا ينطق إلا بلغة العقود والبلاغات القانونية. يبلغ التقمص بالواحد منهم مبلغاً، حتى ليخيل إليك أنك لا تحاوره في شأن من شؤون الحياة، بل إنك تستجوبه كمتهم في قضية شائكة. فما إن تفاتحه في أمر جاد، أو تطلب منه رأياً واضحاً، حتى يرمقك بنظرة باردة مصطنعة، ويجيبك بلسان حال ممثلي الأفلام: “لن أتكلم بكلمة إلا في حضور المحامي الخاص بي”
إسمح لي ياعزيزي أن أضرب لك مثلاً آخر لتزداد الصورة جلاءً. الكل في الظاهر خبراء، أليس كذلك؟ لكن المحك يكمن في السؤال: لم إذا وفد علينا قادم من تلك الديار الموصوفة بـ “العالم الأول”، تشرئب إليه الأعناق، وتتهامس الألسن قائلة: “لقد أتى الخبير الأجنبي”؟ بل لعلهم يبلغون حد التفاخر في مجالسهم بأنهم ظفروا بصحبته.
يا عزيزي، إن المرء إن أردت أن تسبر شيئا من معدنه، فضعه أمام موقفين لا ثالث لهما: أمام جاهل يرتجي منه النصح، وأمام عالم يفوقه معرفة. فإن رأيته أمام الجاهل قد انتفخ وتعاظم بعلمه، فاعلم أنه ربما كان أشد جهلاً من ذلك الجاهل، إذ فاته أن أوَّلَ العلم أدبه. وإن رأيته أمام من هو أعرف منه، يحاول جاهداً أن يثبت أنه الند للند، أو يقلل من شأن ذلك العارف، فاعلم أنه أسير غرر قديم. بمعنى آخر، وبمنظور نفسي، لم ينل في صغره ما يكفيه من الاهتمام من والديه، فكبر وهو يحمل لواء “ليس أحد بأحسن مني”؛ يدافع عن وجوده بالصوت العالي وليس بقيمة العمل، وهذا الصنف بالذات موجود بكثرة اليوم، سواء كان إفتراضياً أم في الحياة الواقعية.
وأما صاحبنا هذا الذي بهره الخبير الأجنبي، فهو قصة أخرى. إنه لم يذق حلاوة التعرف على طباع من أمامه أو عمق فكره، بل كل ما رآه هو شعر أشقر أو لسان أعجمي، فوقف له إجلالاً وتبجيلاً. أتدري لِمَ؟ لأن هذا الخبير الأجنبي قد كشف زيفَ مسرحيتِه الخاصة؛ فكلُّ ما كان يدَّعيه من علمٍ وثقةٍ تهاوى كبيتِ العَنكبوت. وأصبحَ ذلك الصوتُ في داخلِه يترددُ هازئاً: “هذا هو المِهنيُّ الحقيقي... لا أنت”. فيا للعجب! وما بال تلك الشهادات التي جمعها وافتخر بها دهراً، إن لم تكن كافية لتمنحه الثقة ليزن الأمور بميزان العقل، لا بميزان اللون والجنسية؟
وهذا يا عزيزي، ينطبق على كثير من شؤون دهرنا؛ تبدو ظواهرها براقة مزخرفة، حتى إذا ما سبرت أغوارها، ألفيت الباطن خواء، نفس الظاهرة قد تجدها في كبرى الشركات بل وحتى كبرى الدول. انظر إلى ذلك الصرح الشامخ الذي يسمى “شركة عريقة”، يعج بألف موظف؛ لو فتشت بينهم عن أهل الذمة والهمة، لما عثرت ربما إلا على عشرة، هم من يرون العمل عبادة ويقيمون أركانه. أما السواد الأعظم، فهم يؤدون مشهداً هزيلاً من الانشغال؛ يبددون الساعات في تصفح لا طائل تحته، وإن كانت لهم بالناس حاجة، فما أسهل أن يتخلصوا من عبء المراجعين بتوزيعهم يمنة ويسرة. بل إن الداء ليطال مواطن الشفاء ذاتها؛ فتدخل المستشفى العظيم، وقد لا تجد فيه إلا طبيبا واحداً يؤدي ما عليه بحق الإتقان والضمير. أما الكثرة الكاثرة، فلا يقومون بأدنى مهامهم المطلوبة، ما لم تقف على رؤوسهم رقيباً. ويا للعجب! ألا يحسب الواحد من هؤلاء أنه بهذا الصنيع يرتضي لنفسه الهوان، ويمعن في إهانة ذاته قبل أن يهين مهنته؟
ثُم بعد كل هذا، وفي آخر المطاف، يلقون على مسامعنا خُطباً رنانة، ويبشروننا بأننا نشهد تقدماً وأننا في موكب الحضارة سائرون. هيهات! أيّ تقدمٍ هذا الذي يدّعون؟ وكيف لأمةٍ أن تخطو شبراً واحداً نحو العُلا ما دام الضمير في صدور أبنائها مستتراً أو غائباً؟ لن تشهد تقدماً ما دمت لا تعرف ما معنى أن يكون الضمير هو الرقيب الأول والأخير عليك، ضميرك هو الصوت الخفي الذي يمنعك عن الخطأ قبل أن تراه أعين الناس.
لن تشهد تقدماً ما دمت تقف على الدوام في موقع المتأهب للتملص، تنتظر أدنى فرصة لتخلي مسؤوليتك وتلقي بالحِمل عن كاهلك ليحمله غيرك. إن الأمم لا تنهض على أكتاف الهاربين من واجباتهم. ولن تشهد تقدماً حقيقياً إذا انتظرت أن يقف على رأسك أحدهم سوطاً أو نذيراً لتُتقن عملك. إن الإتقان الذي يأتي خوفاً من العقاب أو طمعاً في الثناء هو إتقان زائف، يسقط بمجرد أن يدير الرقيب ظهره، وإهانة لذاتك المُكرمة. الإتقان الحق ينبع من نفسٍ تأبى التقصير وترى في العمل قيمتها.
والأدهى من كل هذا، أنك لن تشهد تقدماً ما دمت تهبط بقيمة العمل لتجعله مجرد أجرٍ يجلب المال في آخر الشهر. العمل ليس جني المال فحسب، بل هو صقلٌ للذات وبناءٌ للكيان. إنه الهوية التي تعرّف بها عن نفسك، هو المدرسة التي تتعلم فيها كيف تدير وتخطط وتبدع. هذه الهوية هي التي، فيما بعد، ستتخلص منها كأجيرٍ لتصبح بها سيداً لعملك الخاص، ممتلكاً زمام أمرك، لن يكون لك شأناً بهذا الشكل ياعزيزي،و لن تشهد تقدماً ما دمت تحمل هذه العقلية الضيقة يا عزيزي.
إن المجتمعات صروحٌ تُبنى بالجهد الصادق والعرق النظيف والضمائر الحية التي تراقب الله في الخلوات قبل الجلوات. المجتمعات لا تُبنى على خشبات المسارح، ولا يقوم عمرانها على مسرحياتٍ هزليةٍ يؤدي فيها الجميع أدواراً لا يؤمنون بها.
إن كنت يا عزيزي من أهل ديار الخليج، أو حتى مررت بها زيارة، فلا بد أن أمرا قد استرعى انتباهك. سترى أن كثيراً من المهن التي قوامها الجهد اليدوي أو الفني، كتلك المهن الشريفة التي لا يقوم نهارنا بدونها، كعامل محطة الوقود، أو عامل النظافة، يشغلها في الغالب أناس من جاليات بعينها.
وإنني أتفق معك تمام الاتفاق، أن أجورهم قد تكون زهيدة، بل ربما لا تكاد تكفي الإنسان الاعتيادي في زماننا هذا ليسد رمقه ويقيم أوده. ومع هذا البخس في العائد، فإنك تراهم يؤدون عملهم بهمة تبلغ المائة بالمائة، كأنما يؤدون رسالة وليس مجرد وظيفة، إن كنت من سكان المدينة المنورة قد تراهم حتى في المسجد النبوي حيث لا رقيب ولا حسيب قائم عليه ومع ذلك تراه كأنه ينظف منزله ليلة العيد.
ثم اقلب بصرك، وانظر إلى الوجه المقابل بعضاً من تلك الوظائف المرموقة، ذات المكاتب الفاخرة والرواتب العالية. عجبا! كيف تجد بعضاً من الموظفين فيها لا يؤدي حتى عشرين بالمائة من مهامه الأساسية التي اتفق عليها في عقده. نحن لا نتحدث هنا عن “الإتقان”، بل نتحدث عن أصل الواجب المتفق عليه.
والإتقان، كما أشرت، هو قصة أخرى تماما. إنه ليس أداء الواجب فحسب، بل هو إضافة على مهام العمل، هو تلك اللمسة التي تزيد على المطلوب، لمستك الخاصة التي تميزك عن غيرك. ودعني أشبه لك هذا الأمر بشيء مألوف لدينا، لنستجلي عمقه، انظر إلى “النفقة الزوجية” في ثقافتنا. إن الواجب المفروض على عاتق الرجل في الإسلام، هو أن ينفق على زوجه وأبنائه. وحد هذه النفقة هو ما يسد الجوع، وما يكسو الجسد ويقي الحر والقر. هذه هي الحقوق الطبيعية، هذا هو الحد الأدنى المتفق عليه شرعاً. ولكن، حين ترى الطعام فاخراً، والملبس كثيراً وفائضاً، وتتدفق الهدايا والعطايا في غير مناسبة؛ فهذا يا عزيزي هو “إتقان النفقة”. وهذا الإتقان، ليس له ترجمة في قاموس المشاعر إلا “الحب”.
لأن المرء كلما أحب، كلما جاد وأعطى من قلبه قبل أن يعطي من ماله. وإن البخيل الحقيقي، ليس بخيل المال، بل هو بخيل القلب والمشاعر أولاً. وهذا الميزان، هو نفسه ميزان إتقان العمل. فمن أحب عمله، جاد به وأتقنه، ومن نظر إليه كمجرد مصدر مال، بخل بجهده وهمته.
لذا، نجد اليوم أن السعي نحو “تأمين الذات” قانونياً قد طغى على واجب “أداء الأمانة” عملياً. تحول الحرص من إتقان المهمة إلى تفادي التبعة، فجفت ينابيع الثقة، وذبلت روح العطاء، وأصبح العمل تروساً في آلة بيروقراطية صماء، وليس نبضاً حياً في جسد المجتمع.
في العقود الأخيرة، ومع تعقد القوانين وانتشار ثقافة “المطالبات القانونية” و “التعويضات”، دخلنا مرحلة جديدة. أصبحت المؤسسات والأفراد يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية. هنا، تحول “إخلاء المسؤولية” من إجراء تنظيمي إلى “غاية” بحد ذاته. لم يعد الهدف إنجاز العمل، بل “توثيق” أنك قمت بالحد الأدنى المطلوب قانونا لتبرئة ساحتك. صارت اللغة “لغة عقود” جافة، لأن أي كلمة أو لفتة إنسانية قد تفسر قانونيا على أنها “تعهد” أو “التزام” لم يكن في الحسبان.
وهذه يا عزيزي، نصيحتي لك التي نختم بها هذا المقال، وأرجو أن تجعل لها في قلبك موطناً وفي عقلك مرجعاً:
لا ضير في أن لا تعرف، ولا عيب في أن تجهل؛ فبحر العلم لا ساحل له، وكلنا نبدأ رحلتنا على شاطئه، لا نملك إلا شغف السؤال. إن المشكلة الحقيقية، والداء العضال، يبدأ حينما ترتدي ثوب المعرفة زيفاً، وتدعي أنك تعرف. وكما أشرنا مراراً في مقالات سبقت، إن هذا العقل الذي بين جنبيك يعتاد ما تعوده عليه. إنه كالأرض البكر، إن بذرت فيها بذور العناد والإنكار، فلن تحصد إلا الشوك والحنظل.
إنك إن جعلت دأبك أن تهاجم كل من أتاك بجديد، ونصبت نفسك حارساً على قناعاتك القديمة، فقل لي بربك، أنى لك أن تتعلم؟ وإنك كلما همس أحدهم في أذنك بنصيحة، بادرت فقلت “أعرف!”، فاعلم أنك بهذه الكلمة قد أغلقت الباب الذي كان ليدخل منه النور. إن “أعرف” هي مقبرة التعلم، ومن ادعى المعرفة الكاملة، فهو في الحقيقة يعلن عن جهله الكامل.
إن أردت أن تكون لك قيمة ورأي، فتعلم أولاً الفرق السحيق بين الانتقاد الذي يهدف إلى البناء، وبين الهجوم الذي يهدف إلى الهدم. تعلم كيف تنتقد الفكرة دون أن تغتال صاحبها.
تعلم كيف تتعلم. نعم، اجعل هذا أسمى أهدافك. لن تتعلم أبداً إن كنت مجرد ممثل تؤدي دوراً على مسرح المهنية الزائف، تردد ما يحفظك إياه الملقن، وتصفق حين يصفق الجمهور. واعلم يقيناً أن كونك مهنياً لا ينفصل أبدا عن كونك إنساناً.
أنت لست آلة صماء، ولا ترس في منظومة عمياء. أنت لست دابة تساق فتسير، بل أنت كائن كرمه خالقه بالفكر والقلب. لك فكر يزن به الأمور، ولك قلب يبصر به ما لا يراه العقل وحده. فاستخدم عقلك ليميز الحق من الباطل، واستخدم قلبك لتشعر بآلام الناس وتجود بالرحمة. إن العقل بلا قلب هو سيف في يد مجنون، والقلب بلا عقل هو شراع بلا دفة. وإلا، فإنك إن عطلت أحدهما لصالح الآخر، أو عطلتهما معا إرضاء للظاهر، فقد ارتضيت لنفسك أسوأ صور العبودية بحذافيرها؛ عبودية لا يرى فيها المرء إلا نفسه، ولا يسمع فيها إلا صوته، وهو في الحقيقة لا يملك من أمره شيئاً.
شئنا أم أبينا، هذا هو الواقع الذي يصفعنا كل صباح. إن المنتشر اليوم ليس الذكاء، ولا نور العلم الحقيقي. إنما السائد هو غثاء كغثاء السيل. غالبية عظمى من الناس لا تكاد تميز الواحد منهم عن الآخر، كأنما صبوا جميعاً في قالب واحد.
تراهم بعقول مستنسخة، تردد ذات الكلمات، وتستهلك ذات الأفكار، وتطرب لذات الألحان السطحية. وتراهم بمبادئ معلبة، جاهزة للاستخدام الفوري، وهي في عمقها تكاد تكون معدومة، هشة كبيت العنكبوت، تسقط عند أول اختبار حقيقي. لقد أصبح الناس اليوم يتهافتون على السطحية البراقة تهافت الفراش على النار، وينفرون من العلم لأنه يتطلب جهداً وصبراً، وهما عملتان نادرة في هذا الزمان. الكل يريد الأجوبة السريعة، والنجاح الفوري، ولو كان نجاحاً مزيفاً.
في وسط هذا الطوفان من التشابه، فلتبق أنت متميزاً يا عزيزي. ارفض أن تكون نسخة، واجعل من نفسك أصلاً. فإن الأمم لا تنهض بالقطعان، ولا ترتفع بسواعد المستنسخين، ولا يبني الحضارات أولئك الذين يخافون أن يكونوا أنفسهم. الأمم لا تنهض إلا بالمتميز، المتميز في عقله؛ الذي يرفض أن يكون عقله وعاء يصب فيه كل شيء، بل هو مصفاة تنقد وتمحص وتغوص خلف المعاني لتخرج بالجديد. المتميز في مبادئه؛ التي ليست رداء يلبسه حسب المناسبة، بل هي جذور ضاربة في عمق تكوينه، لا تهزها رياح المصالح العابرة.
المتميز في قلبه؛ الذي لم يمت بحجة المهنية والاحتراف، بل لا يزال ينبض بالإنسانية والرحمة، ويرى العمل عبادة وليس مجرد صفقة، ويرى الناس غايات لا وسائل. المتميز في عمله؛ الذي يرى في إتقانه تحقيقا لذاته، ويضع فيه روحه قبل جهده، وليس مجرد انتظار لساعة الانصراف أو توقيع على ورقة الحضور. المتميز في شخصيته؛ كينونة متفردة، لها بصمة لا تتكرر، لا تخجل من اختلافها، ولا تحاول أن تكون أي أحد آخر لترضي أحدا. هؤلاء هم من يحملون المشاعل في الظلام، وبهم وحدهم تنهض الأمم، أما الباقون، فهم مجرد أرقام صامتة في مسرحية هزلية، يصفقون عند النهاية دون أن يدركوا أنهم كانوا هم الممثلين والضحية في آن واحد.
قلناها مراراً وتكراراً، وهي حقيقة كاد الدهر أن ينطق بها من فرط ما صدقتها شواهده، إن أكثر الناس ضجيجاً وتحدثاً بالشيء، هم أكثرهم افتقاراً إليه في حقيقة الأمر. إنها قاعدة الأواني الفارغة؛ فكلما زاد الخواء، علا الصوت. وذلك الذي يتشدق بـ “العمل” في كل مجلس، ويجعل من “المهنية” قميصه الذي لا يخلعه أبدا، ويحدثك عن صفقاته ومشاريعه في كل مكان وزمان، حتى في لحظات الصفاء التي لا تحتمل هذا الصخب، هذا بعينه هو الدليل الأكبر، والبرهان الأسطع، على أنه لا يفقه شيء في عمله، لإنه يعوض بالصوت العالي فراغا هائلا في الداخل.
وإلا، فلو أنه عرف قيمة الإنجاز فعلا، وأدرك معنى أن يكون المرء منتجا بحق، لقدس وقته الخاص تقديساً لا يقل عن تقديسه المزعوم لوقت عمله. لعرف أن النفس لها حق، وأن العقل يحتاج إلى السكينة ليجدد إبداعه، وأن الروح تحتاج إلى الخلوة لتتنفس. لكنه، يا عزيزي، يخشى الصمت. إنه يخشى الخلوة بنفسه، لأنه في تلك اللحظات، يواجهه ذلك الفراغ المدوي، فيهرع مرة أخرى لارتداء قناعه، ويطلق العنان لصوته، عله يغطي على حقيقة أنه، في نهاية المطاف، لا يملك شيئا ذا قيمة حقيقية، لا في العمل، ولا في الحياة.
لا تنسَ متابعتنا على قناة اليوتيوب من هنا:



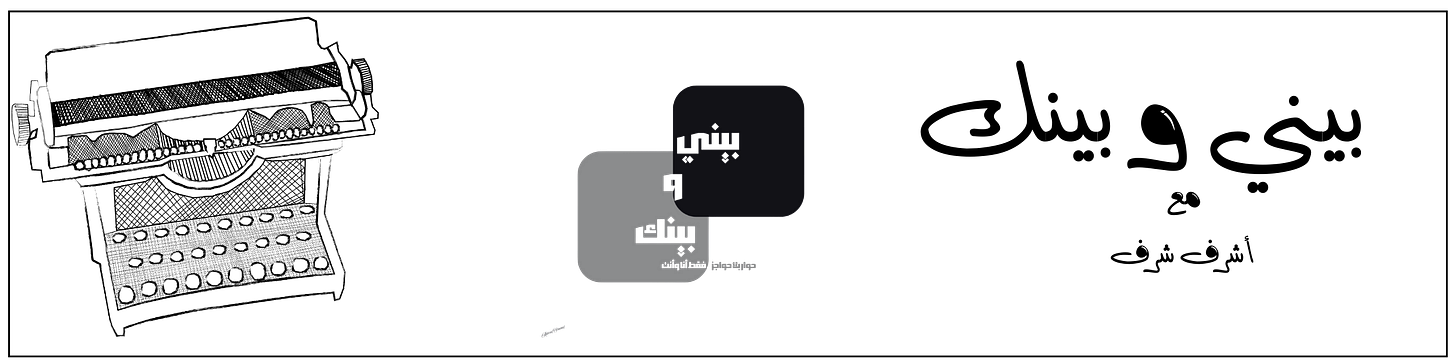




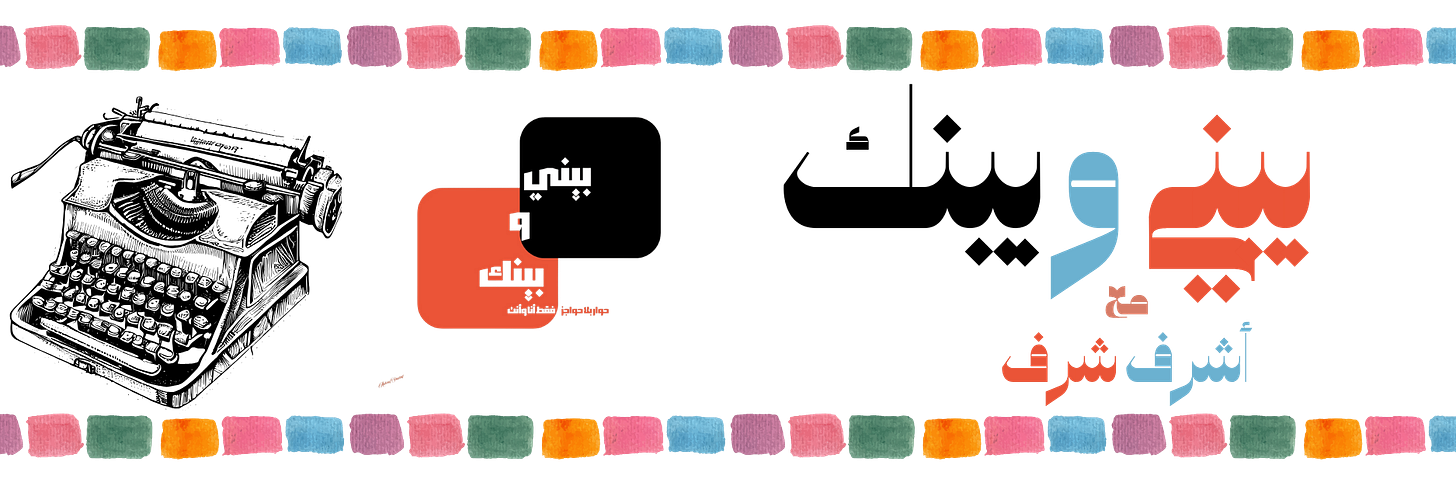
معجبة جدًا بالمقال الصراحة، أبدعت وصدقت في كل حرف وكل كلمة كتبتها. و ربطك الإتقان بالحب دا شيء عظيم جدًا، لانه فعلًا لما بنحب الشيء اللي بنعمله بيكون كل مجهود فيه خفيف على القلب حتى لو متعب جسديا. والإتقان الحقيقي عمره ما ييجي بالإجبار، بيجي بالمحبة وبالإحساس ان اللي بنعمله له معنى وقيمة. كلامك لمسني جدًا حقيقي تسلم ايدك يا أشرف❤️
جزاك الله خيرا